
فلسطين من البحر إلى الشعر
2023-12-08
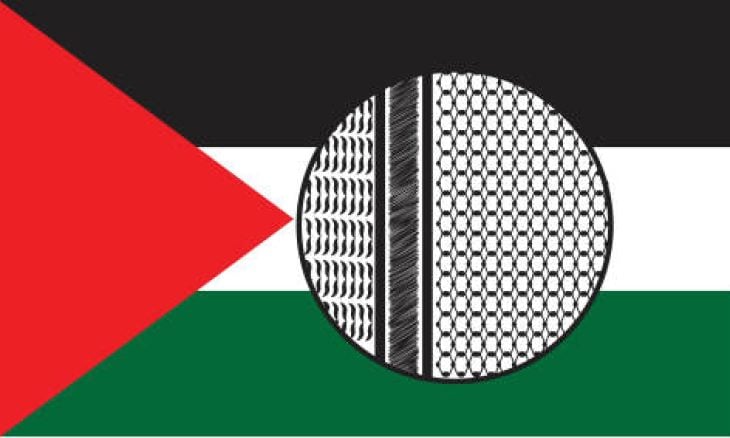
إبراهيم الزيدي
نحن على ثقة من أن الشعر ديوان العرب وسيبقى، فقد وثّق انتصاراتهم الدائمة، والمتتالية. ووثق كرمهم ورجولتهم، وعزتهم وإباءهم، وأنفتهم وكبرياءهم، وكأنهم فعلا خير أمة أخرجت للناس! وأصبحت معلقة عمرو بن كلثوم مرجعا للمتغنين بالأمجاد السالفة، وشاهدا أبعد من النسيان في العقل الجمعي العربي.
منذ «لا تصالح/ أمل دنقل» دخل الشعر في صراع بين الجرح وصورته الكلامية. وحين تلاحقت الجروح، وتكاثرت وتنوعت، عقدت الدهشة حاجبي الشعر العربي، ووقف كالأبله أمام مشفى المعمداني في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. هناك حيث أغلق الشهداء أبواب جراحهم، قبل أن تمسح الجرافات الغبش عن زجاج غيابهم، وسقطت لوحة كتب عليها بالخط الكوفي: وإذا مرضت فهو يشفين، وتحول المشفى إلى مقبرة، فهل يستطيع الشعر حين تبرد حروف اللغة، أن يصف حرارة الدم؟
لقد تأكدت مقولة البير كامو: أسوأ الأوبئة ليست بيولوجية، لكنها أخلاقية.
سابقا استطاع قيس بن الملوح أن يجعل من « شميم عرار نجد» عطرا لا يعرفه كريستيان ديور، لكن من الصعب الآن على أي شاعر أن يكتب مثل تلك الكلمات التي قالتها إحدى الأمهات الغزاويات وهي تقف بين جثامين أطفالها: «الولاد ماتوا قبل ما ياكلوا». الشعر الفلسطيني اليوم لم يعد بحاجة إلى الوزن، والطباق، والجناس، والتشبيه، تلك الثيمات الشعرية فقدت صلاحيتها، ولم تعد مجدية. لقد خرجت بلاغة الصورة الشعرية الفلسطينية على الشعر العربي وتاريخه، واستقلت بذاتها ولذاتها. الآن كل الطرق في غزة تؤدي إلى الموت، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى المعابر! وفي كل موت تولد ألف قصيدة. ليس في ديوان محمود درويش، أو معين بسيسو، أو إبراهيم طوقان، أو سميح القاسم، بل بين شفتي الأمهات والآباء المكلومين. في تلك اللحظات بالذات يمكننا أن نسمع كلاما عفويّا واقعيّا طازجا، كلاما لا يوارب الحقائق، ولا يغلف المشاعر بسيلوفان اللغة «اسمو يوسف، عمرو سبع سنين، شعرو كيرلي، وأبيضاني وحلو». حين قالت إيميلي ديكنسون أنها أمام القصيدة الحقيقية يصيبها البرد، لدرجة أنها تتصور أن لا نار تستطيع تدفئتها بعد ذلك. لم يكن كلامها إنشائيا. كانت تعرف أن «الطفل الذي نجا من الحرب، ولم تنجُ ساقه، سيظل والده يشتري له زوجين من الأحذية».
زمن المطولات، والمعلقات، والنفاق الفني، انتهى. الآن الشعر الفلسطيني جسّد الحلم القديم للغة، وتصالح مع الحواس، ووصل إلى عاطفة اللغة الكامنة، فاستعار من الانفجارات وميضها الخاطف، فخطفت أبصار المتابعين بلاغته الهائلة: «يمّا، والله كنت عم حضّر لعيد ميلادك، يمّا» هذه القصيدة – الملحمة قالتها أم وهي تقف فوق جثمان طفلتها الوحيدة، فبأي ألاء ربكما تكذبان؟ الأطفال الذين أودت بحياتهم الغارات المتلاحقة، وتحولوا إلى أرقام في شريط الأخبار، لم يتعبوا من الموت، وما زالوا يبحثون عن أسمائهم بين الأنقاض! لذلك ترى أن الشعر الغزاوي الآن ليس معنيا بالسلام والجمال، وتربية الذائقة الفنية. تلك المهام دستها الأيديولوجيا في معجم المفاهيم الشعرية. الشعر الغزاوي الآن، ليس لديه الوقت لتبني وظائف المترفين. الشعر الغزاوي الآن يبحث عن زمنه بين خداع مناشير الإنذار، وغدر الغارات الجوية. الشعر الفلسطيني كله اليوم يشبه الموت، أما فلسطين فإنها تشبه الحياة. خطان متوازيان يبحثان عن رصاصة ليلتقيا. فلسطين كل يوم ترتطم بالحقيقة، والعالم يفقد صوابه.
(رفضت أمي أن يكتب على جسدنا أحد، نادتنا إلى داخل الخيمة، وبين أصابعها الجافة قلم حبر أسود، بدأت بي «أحمد تعال»/ كتبت على يدي: أحمد راشد صالح، الأم عبير، العمر 9 سنوات، فصيلة الدم A+، ثم أختي هبة، كنت أقرأ ما تكتب، المعلومات نفسها، إلا أن هبة عمرها 5 سنوات، ثم راشد وعمره 3 سنوات، لكن جسده لم يتسع لكل الكلمات، فتنهدت وقالت: «راشد ما رح يضيع عنّا، رح يعرفوه، بضلّ بحضني» ونظرت إلينا برأس مائل، وابتسامة صغيرة، وقالت: تخافوش، أنا كتبت على جسمي إني أم أحمد وراشد وهبة، وزوجة الشهيد فهمي صالح).
هذا الشعر الجديد الذي فاض وأغرقنا، سيتسرب حمضه النووي إلى كل العرب. ها هي فلسطين اليوم تجوس بأنامل قلبها كل البرد الذي مرّ على القشرة الأرضية. لقد حدثت كل التوقعات، ولم يبق ما يمكن أن يخشاه الفلسطينيون في المستقبل (وإذا تركت أخاك تأكله الذئاب/ فاعلم بأنك يا أخاه ستستطاب) (ويجيء دورك بعده في لحظة / إن لم يجئك الذئب تنهشك الكلاب).
كاتب سوري



















