
رولان جاكّار: الإنسانيّة ليست موهوبة للأفضل ولا للأسوأ
2020-10-10
 حاوره أيمن حسن
حاوره أيمن حسن
في الحوار مع رولان جاكّار، وكذلك في الشذرات المسمّاة “مكيّف في الجحيم” التي ترجمها أيمن حسن، نتعرف على شخصية أدبية وفكرية فرنسية من نوع استثنائي.
الجديد: اسمح لي بأن أنطلق من كتابك الصّادر مؤخّرا تحت عنوان “يابانيّة في باريس”. في ما يتمثّل بالتّحديد؟ هل هو، كما يبدو للجميع، حكاية للأطفال، أم، كما تبيّن لنا، قصّة للكهول؟
رولان جاكّار: في البداية، هو طلب من ناشر ياباني لجمهور مستهدف: اليابانيّات الشابات اللواتي يحلمن بباريس وبالحبّ الكبير. لقد رفع التّحدّي وفي ذهني كتاب إيريك سيغال (1973 – 2010)، “لوف ستوري” (“قصّة حبّ”)، وكذلك بعض الشّيء ستيفان زيفاغ. من مميّزات الشّيخوخة أنّه ليس لنا من نُثْبِتُهُ أو ما نخسره. قلتُ إذن لنفسي: فلأسمح لنزعاتي الرومانسيّة بالتحرّر.. فالكمنجات دائما على حقّ.
الجديد: ما الذي يخفيه عملكم المتواصل مع رسّامين أمثال رولان توبور، رومان سولكومب وغيرهما من الفنّانين المشهورين بغرابتهم؟ هل تبحث عن تعويض لموهبة تفتقدها؟
رولان جاكّار: في البدء، كنت أودّ أن أكون سينمائيّا، ولقد صوّرت فعلا بعض الأفلام في لوزان. حتّى أنّي اشتغلت في فيينّا مع جون رونوار. أستمتع الآن يوميّا بتصوير فيديوهات أسمّيها “هايكاياتي البصريّة”. كلّ الرسّامين الذين اشتغلت معهم كانوا أصدقائي وأقدّر أعمالهم، وعلى رأسهم توبور. هي متعة كبرى أن أجدهم في كتبي.
“حياتي وخيانات أخرى”، قصّة صدرت سنة 2013، تمثّل كذلك كتابا فلسفيّا وعملا أدبيّا حياتيّا شديد الشّراسة. تمكن قراءة النصوص الخمسة والثلاثين التي يتكوّن منها بطريقة مسترسلة أو بطريقة متقطّعة. كيف تكتب؟ كيف تنظم نصوصك وأفكارك وكتبك؟
أكتب كيفما كان وأينما كان. ما يهمُّ بعد ذلك هو التّركيب وخاصّة الفكر النّقدي المؤدّي إلى إزالة جزء كبير من النص. من جهة أخرى، أحاول أن أكون أكثر قربا من نفسي. ما جدوى الكتابة إن لم نتحدّث عن أنفسنا؟ بالطّبع، الأنا بغيض، لكن أنا الآخرين بالأخصّ.. ثمّ، أليس من الأفضل أن يكرهنا النّاس لذواتنا على أن ننال إعجابهم أو نحظى بحبّهم لما لسنا عليه.
آثار لعالم الغد
الجديد: يمكن وصف قراءاتك بالعدميّة. ما معنى ذلك؟ “ليس العدم إلاّ برنامجا”، على حدّ رأي سيوران الذي كان صديقا حميما لك وقد كتبت عنه كتابا جميلا جدّا صدر سنة 2005 عن المنشورات الجامعيّة الفرنسيّة. ماذا عن كلّ ذلك إذن؟
رولان جاكّار: يجب ألاّ نتعجّل في الحديث عن العدميّة! فلنقل إنّي أمارس فلسفة أو فنّ فكّ الارتباط، وذلك بصحبة بعض المعلّمين: شوبنهاور، نيتشه، سيوران وأمْييل وبرنهارد وفرويد.
الجديد: أنت اليوم متقاعد، وبعيد عن عالم الصّحافة الأدبيّة والنّشر. كيف ترى ما يجري في هاتين المهنتين؟ هل يبدو لك ما يجري فيهما صافيا أو على الأقلّ عاديّا؟
رولان جاكّار: بما أنّي صرت عجوزا بسرعة (وهي أفضل طريقة للمحافظة على الشّباب)، لطالما بدا لي أنّي كنت متقاعدا. لقد تمكّنت، وهذا هو الأهمّ بالنّسبة إليّ في أيّ حياة كانت، من حماية جلّ وقت الفراغ الخاصّ بي تقريبا. يتراءى لي أنّنا انتقلنا من خيال التقدّم إلى خيال الكارثة. وهذا ما يؤكّد ما عرفناه منذ الأزل: الإنسانيّة ليست موهوبة للأفضل ولا للأسوأ كذلك.
الجديد: لا يمكننا محاورتك دون طرح سؤال سياسيّ عليك. ما رأيك في ما يجري خلال السّنوات الأخيرة مع العلم أنّك كنت قد زرت تونس للعديد من المرّات في الستّينات والسّبعينات؟
رولان جاكّار: بعد إتمامي دراستي الجامعيّة في لوزان، أهدى لي والداي إقامة طويلة في تونس، خاصّة في الحمّامات وسيدي بوسعيد. أحتفظ بذكريات مبهرة لها. حريّة الأخلاق، الفتيات على الشّاطئ، العلب اللّيلية.. باختصار، هي الحياة الحلوة. لكن عاينت على مرّ السّنين الصّعود الذي لا تمكن مقاومته – لا وحسب في تونس، بل كذلك في سويسرا – للدّين الذي يعطي في نظري مشهدا مزعجا لسلفيّة مدمّرة. لكن، ورغم كلّ شيء، من حقّ كلّ حقبة أن تعيش هذيانها القاتل. الألمان تمتّعوا بذلك مع هتلر، والرّوس مع ستالين والصّينيّون مع ماو.. لن أسمح لنفسي بمحاكمتهم. لكن عندما يصير المشهد ضاربا في الفحاشة، أفضّل مغادرة القاعة. وذلك لأسباب جماليّة لا أخلاقيّة.
الجديد: وماذا بخصوص “مكيّف في الجحيم”، وهو مجموعة من الشّذرات والأقوال المأثورة التي تتأرجح بين الجدّ والهزل؟ هل يمكنك أن تروي لنا قصّة ولادة هذا الكتاب؟
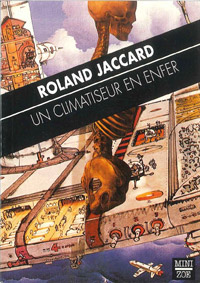
رولان جاكّار: بالنّسبة إليّ، يمثّل الشّكل الشّذري روح الأدب، النّواة الأساسيّة، العلبة السّوداء لكلّ إبداع يريد أن يتحدّى الزمن. على سبيل المثال “هل تتذكّر تلك الثّعابين التي، عندما وصلنا إلى إيبيروس، كانت تمسح خلفنا آثار أقدامنا؟ ثعابين أخرى ستأتي وكلّ شيء سيُمسح”. من يمكنه منافسة سكيبيو الأفريقي؟”.
لطالما تمتّعت بتوابل لاروشفوكو، شومفور، نيتشه أو سيوران كي لا أصاب بغواية قول في فقرة واحدة ما يتعسّر على آخرين التّعبير عنه في كتاب كامل. في “مكيّف في الجحيم”، نقرت في دفاتري ما يمكنه إعطائي وهم أنّني أستحقّ تقدير أساتذتي في السّخرية والتّحرير من الوهم.
الوقاحة، الاستفزاز، الفكر الخبيث، لطالما دفعوني، أحيانا رغما عنّي، إلى قول كلام غير لائق. التّحليل النّفسي لعب كذلك دورا هامّا. أن تكون عقلا حرّا يتطلّب التخلّص من كلّ حكم مسبق والتّعبير عن كلّ ما نشعر به، حتّى الأبشع. ومع ذلك، يجب أن تكون في حالة طيّبة. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة إلى عدم الاكتراث وقبول هزيمة الفكر بشيء من الوقاحة. وإن كنت قد فشلت في ذلك، فعلى الأقل قد حاولت قبول تحدّي الشّكل القصير في الكتابة.
الجديد: اليوم وقد تُرجم الكتاب إلى العربيّة، ماذا تنتظر من هذه المغامرة خاصّة وأنّك كتبت العديد من النّصوص ونشرت الكثير من الفيديوهات على الإنترنت وفي مجلّة “كوزور” (Causeur) ، التي عبّرت فيها عن قلقك من تفشّي الخطر والإرهاب الإسلامي؟
رولان جاكّار: بالنّسبة إلى الفوضوي الكامن فيّ، الإسلام يُسبّبُ النّفور والخوف. إذا كان يوجد شيء يمكن إنقاذه فيه، فأفضّل تركه للآخرين. أنا لست حسّاسا جدّا لهذا الهذيان المقدّس المتمثّل في الدّيانات السّماويّة التي ظهرت كما لو كانت صدفة في منطقة من العالم حيث تضرب الشّمس بشدّة. صحيح أنّ النّازيّة والشّيوعيّة والماويّة (وقع جلّ المثقّفين الفرنسيّين في غرام الآخرتين) تتفانى في إثبات أنّ للعبوديّة وللقتل الجماعي نوابض عميقة في النّفسيّة البشريّة.
يبدو اليوم أنّ الإسلام قد حمل شعلة الخضوع. لقد صار ظاهرة موضة، أو “ميّال” إن تحدّثنا كشباب اليوم. فهو يرشّنا بأحاسيس قويّة ويجعل المحارب الرّاقد فينا يهتزّ. في بحر من الطّين ومن الدّم، هل للكتيّبات السّاخرة كالتي أؤلّف حظّ كي ينظر إليها بطريقة أخرى غير أنّها آثار لعالم الغد؟ أشكّ في ذلك بشدّة. ولكن وحده الذي يعلن أنّه هُزم يكون قد هُزم. لن تكون هذه حالتي أبدا، ولن تكون كذلك حالة صديقي العزيز ومترجمي أيمن حسن.
.............................
مكيّف في الجحيم
“سامحوا تناقضاتي: إذ يجب اقترافها عند التّفكير، أفضل أن أكون رجل تناقضات على أن أكون صاحب أحكام مسبقة”.
جان جاك روسو
يُعرف عنه التسرّع في إصدار كتيّبات حول موضوع: الفتاة والموت. ويلومه البعض على وقاحته، فيتباهى بها. كان يريد أن يكون كاتبا من صنف بسيط وأصيل وجذّاب. لكنّه يشكّ في أنه توصّل إلى ذلك. قد عاش كوارث لا تصدّق. لكن وحده غريق مسبح “دوليني” تركه في حالة يرثى لها.
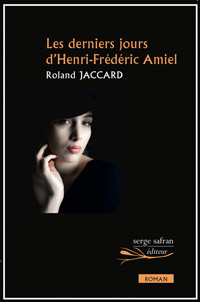
ألصقَ على نفسه صفة العدميّة وأطنب في الاستشهاد بسيوران وشوبنهاور. لكنّه أبدع في الميوعة. كان يسهر على أن يكون هناك 100 في المئة من الاقتناع و100 في المئة من التحدّي في ما كان يكتب.
تعرّف على الكثير من الرّجال العظماء وعلى فتيات. في آخر حياته لم يعد يقدر على التّمييز بينهم. خلّف وراءه صورة لرجل لطالما تراجع أمام الانتحار تاركا مكانه لآخرين أكثر عجلا منه.
عندما لم يكن يلعب الشّطرنج أو تنس الطاولة، كان يحرّر مصنّفا أساسيا عن البندقيّة الدوّارة لدى الجيش البلغاري في القرن التّاسع عشر. لم يعترف له أحد بذلك الجميل أو بأيّ جميل آخر، لكنّه لم يبال بذلك. لم يكن أحد يعرف كيف وافاه الأجل المحتوم. حتما كان ذلك على حافّة مسبح بنزل فاخر في اليابان. هذا ما كان يحلم به على الأقلّ.
هل سأوصف بالمتكبّر إن قلت إنّي أرى نفسي في هذا الرّجل، أو هل سأُعتَبر ضعيفا إن نشرت مرّة أخرى بعض الشّذرات المقتطفة من كراريسه الشخصيّة؟ وليكن. خاصّة أنّ علينا أن نغالي في تقدير أنفسنا إلى حدّ المرض لكي نتخيّل أنّ لخربشتنا أيّ وقع على قرّائنا المساكين. إذ لا قيمة لها عند أصحابها من الكتّاب. إذن؟ إذن علينا أن نرفّه عنهم وذلك باستفزازهم أو بتسليتهم. هذا فعلا ما نقوم به، شئنا أم أبينا. إنّ أبرز قيمة لأيّ عمل إبداعي تكمن في إضحاك أولئك الذين ليس بوسعهم تذوّقه. فإن تمكّن من إضحاك حتى المعجبين به، إذن يمكننا أن نقول إننا لم نضيّع وقتنا.
حياة تنتهي وهي لم تكد تبدأ. سنحاول أن نرتّبها بعض الشيء. ملذّاتي الوحيدة شبقيّة وشغفي الحقيقي فكري. أردت أن أفهم ‒ مع يقيني أنّ لا شيء يُفْهَم. أردت أن أحبّ ‒ مع يقيني أنّ لا أحد يستحقّ الحب. أردت أن أموت ‒ مع يقيني أنّ الموت ليس حلاّ.
نعتني بعضهم بالمتباهي. إن كان ذلك صحيحا، فلن أكون قليل التّفاخر بأنّي نجحت في ذلك لمدّة تقارب نصف القرن. لكنّي أفترض أنّ حتى الانتحار يبقى بالنسبة إلى بعض النّاس نوعا من التّباهي، وهي طريقة رخيصة لابتياع تذكرة إلى اعتراف الأجيال القادمة. أنصحهم بأن يحاولوا: ليس الأمر بالسّهولة التي يزعمون. في كل الحالات، لن أكون هنا لأهزأ من سخريتهم.
في شبابي، ارتأيت نفسي في شخص اليهودي التّائه أهاسيفيروس. لأنّه كان قد خاطب المسيح بوقاحة وهو على طريق الصّليب، حُكمَ عليه بأن لا يرتاح في أيّ مكان كان وأن يعبر القرون وكأنه ميت حيّ. لكنّ اللّعنة التي يحمل عبئها هي في الآن ذاته بركة تعمّه. رمز التّيه والانفصال وانقلاب جميع القيم، إنّه ذلك الحالم السّاخر الخائن لجلّ وعوده، وهذا ما كنت أطمح أن أكون. وفعلا أطنبت في تبديد ثرواتي الأخلاقيّة في الاستهزاء وفي لعب دور مصاص الدماء مع الفتيات الصّغيرات.
بالنّسبة إلى أناس مثلي ليس العالم إلاّ ديكورا لرغباتهم أو مخبرا لصراعاتهم. هذا ما يفرض عيش حيوات كثيرة وإفسادها جميعا حتىّ لا ننجح إلاّ في مراسم دفننا.
حين فهمت مهزلة أنّني سويسري، وهي مهزلة تشبه وضع تلك الآنسة التي أرادت أن تشتغل في ماخور دون أن تفقد عذريتها، بدأت في تذوّق لذّة سخرية أنّي من مسقط رأسي.
لا أتحمل إلاّ الأشخاص الذين يحمون الآخرين من فظاظة حمل جنسية أو دين، وهم أشخاص تنفلت الأرض تحت أقدامهم.
كل عام ليلة عيد الميلاد يخرج ربّ العائلة من داره، يطلق رصاصة في الهواء، ثم يعود هادئا بين ذويه المرعوبين قائلا “قد انتحر بابا نويل من جديد”. هل يجدر بنا أن نحلم بهديّة أجمل من هذه بمناسبة عيد الميلاد؟
أب غاضب لأنّ ابنه لم يتعلم شيئا من دروسه في السينيزم، فقرّر بمناسبة زواجه أن يرسل إليه البرقيّة التّالية “الزّواج في الشباب كابتياع سخان كهربائي صيفا”. فأجابه الابن فورا “لا تعوّل عليّ لأهديك مكيّفا في الجحيم!”.
يمثل جحود الأبناء تجاه والديْهم الشّكل الأكثر مكرا للحبّ الذي يدينون لهم به.
تمثل مقاومة قلقي الشّخصي النشاط الأساسي الذي كنت أقوم به، وهو النّشاط الوحيد الذي طالما مارسته في غاية السّريّة، وليس ذلك للأناقة بل لتجنّب الشّفقة. كان البعض يغارون مني لأنّهم كانوا يجهلون كل شيء عنّي. وبفضل حسن مراوغاتي كنت أتمكّن من الإفلات منهم. لم يكن ذلك يدوم طويلا. كنت أحلم بالعدم كانتصار أخير، لكن في قرارة نفسي كنت أعلم أنّ السّقوط سيكون شأنه شأن حياتي دون منزلة.
في أحد الأيام، في فندق فخم، التقت نظراتي بنظرات معبود الشباب الذي كان يستعد لإشعال شرارة الرّغبة الجماعيّة في أحد ملاعب لوزان. كان من فئة الرياضيّين الذين تفوّقوا على كلّ المصاعب، في حين لم أكن أطمح إلاّ لأصير الكُتيّب الأكثر طيشا في جيله. كان معبود الشباب من فئة المراهقين المتخلّفين الذين تصنع الحياة منهم أجمل شيوخها. قريبا سيتجاوز تلك النقطة التي بعدها تصير تذكرته غير صالحة. كنّا تقريبا في نفس النّقطة، تلك التي عندها يجتاحنا شلل إلهي: تمّ كل شيء، ربحنا كلّ شيء، خسرنا كل شيء. ما جدوى ذلك؟ ابتسامة النصر تشبه تكشيرة الهزيمة. كان يعرف ذلك وأنا كذلك. كان فينا شيء من تينيسّي.
| كان الفيلسوف الألماني نيتشه يقول “إن مرماي أن أقول في عشر جمل ما يقوله غيري في كتاب.. ما لا يقوله في كتاب بأكمله”، من هنا نفهم اهتمام الفلاسفة والمفكرين والكتاب والأدباء بالكتابة الشذرية التي تمثل نوعا من التفسخ والتفكك والاختلاف وشكلا من الثورة على المقاييس المنطقية الصارمة، لقول الفكرة خالصة نقية من الأدران والحشو والالتواء، وهو ما اختاره الكثير من الكتاب مثل إيميل سيوران وصديقه رولان جاكّار الذي ننشر في ما يلي نصا لحوار معه أجرته مجلة الجديد الثقافية اللندنية. |
كنت في ما مضى أخفّف من روع قلقي بمعاشرة فرويد وبمشاهدة أفلام إنغمار برغمان، اليوم أمتصّ أعوادا كيمياوية وأتفرّج على كائنات بشريّة إلكترونيّة وهي تهتزّ على قناة M.T.V.. هكذا تتفسّخ الإنسانيّة ‒ منّا وخارجنا.
في أفضل الحالات، تدور العلاقات على هذه الشّاكلة: في اليوم الأوّل الإثارة، في اليوم الثّاني الفضول المرضي، في اليوم الثّالث اللا مبالاة. لكن عندما تمتدّ الإثارة فالأسوأ ليس ببعيد.
نصيحة لويز بروكس للفتيات الشابّات: ليس من الشّائع العثور على الرّجال القساة، فإن عثرتن على واحد منهم، فلا تفرّطن فيه!
لطالما حاولت عبثا أن أكون ذلك الرّجل القاسي. لم أتمكن إلاّ من ترويض بعض العصافير التي سرعان ما عادت إلى حريّة الفضاءات الكبرى.
كلّ امرأة أحببت محطّة في طريق صليبي، لكنّي نجوت بصحيح العبارة من الصّلب. يجب شيء من اللاّ وعي للدّخول في قصّة حبّ والكثير من الشّجاعة للخروج منها.
نحسب أنفسنا دون جوان نفرح بالرسائل الممجدة التي تأتينا من غريبات. أحيانا نجيب. ننطلق إذن في سيناريو نتخيّل أننا نتحكم فيه، لكن نكتشف أنه لم يكتب لأجلنا. نرغب أكثر في التعرف على كاتب السيناريو الذي حاك تلك القصة الماكيافيليّة حيث أوقع بنا ضعفنا.
في أحد الأيام، نفهم أن لا وجود لقصص الحب، لأنّ الحب نفسه قصة داخل قصة أخرى. وهي قصة ليست بالضرورة أن تتكرّر: إنها تُقفَّى. إذ أنّ نهايتها تعكس بدايتها. كما في المتاهات القديمة، باب الدخول وباب الخروج يتماهيان.
يجنبنا الإشهار مجهود الرّغبة، لكنّ الإرادة التي يسخّرها في توجيه شهواتنا نحو الجنس النّاعم تبعث الرّيب فينا: هل هذه الرّغبة عاديّة في نهاية الأمر؟ لماذا كل هذا الإلحاح المصطنع، بيد أنّ الطبيعة تكفي. على أيّ حال، ما عدا لوريل وهاردي، لم أر أبدا زوجين من غير المثْليينْ.
لا تعني الفلسفة لي شيئا إلاّ عندما تفقد صوابها. في آخر حياته، وصل فيتغنشتاين إلى درجة أنّه لا يرغب إلاّ في لفظ أصوات ممزّقة. أنا أفكّر إذن أنا أغرق.
الخاطرة هذه لنيتشه: كره الرّداءة غير جدير بفيلسوف وربّما يمنعه من الولوج إليها. إن كان استثناء فعليه أن يحبّ القاعدة. ستكون تلك طريقته الشّخصيّة في الشّجاعة.
وعندما سألت الجميلة السّمراء المكلّفة بمكتب الإرشاد السياحي بمدينة نيس أين كان يعيش نيتشه؟ أجابتني بطلاقة ساحرة “كان يتسكّع دوما من جهة ساحة سَلِييَا..”.
أداة التعجب العدميّ عن جدارة “وماذا بعد!” يمكنكم أن تطهوها بكلّ الصلصات، ولتعلموا أنّها ستكون دوما لذيذة.
يزداد عدد الذين يهيمون في المدن الكبرى في أغلب الأحيان دون هويّات وفي حالة من فقدان الذّاكرة. لا أحد يعرف من أين جاؤوا ولا إلى أين يذهبون. لكن يكفي أن نسترق السّمع لنصغي إليهم يتمتمون “لم يسمح لي الوقت. كان ذلك قصيرا”. ويكرّرون “الحياة! كانت قصيرة جدا، الحياة”. يبكون وهم يقولون الحياة.
مروّض نمور يبلغ من العمر 63 سنة، مشمئزّ من الحياة ومن السّرك، في أحد الأيام دخل بعد الظّهر إلى القفص متنكّرا في هيئة قرد. لم تكن النّمور شرسة، لكنّها لم تتعرف عليه فافترسته. يحدث دائما في حياة كل واحد منا وقت ما لا يتعرّف فيه علينا الآخرون ويفترسوننا. لكنّنا نادرا ما نعي بذلك.
وجب فهم أنّ الأسلوب ليس مسألة تقنيّة، بل هو حصيلة نظرة إلى العالم. وهذه النظرة، لا نتمكّن من امتلاكها إلاّ عندما تضعف بصيرتنا وتصلنا أصوات العالم خافتة. عندها إذن يتشكّل شيء ما وهو عالمنا. لم نربح شيئا حتىّ الآن. لأنّ ما نكتشفه بإمكانه أن يحبط عزيمة أكثر النّاس شجاعة. وحده بإمكانه أن ينجح ذلك الذي ينجو من الإحباط ومن القرف ومن السّأم المنجرّ عنهما. ينجح في ماذا؟ ربّما في الوصول إلى يأس أكثر عمقا، يفضّل البعض الحديث عن الفرح. ربّما في أفضل الحالات في الوصول إلى فراغ كامل إلى درجة إلغاء الضغوطات فيظهر شيء ما، ليس معنا ولا ضدّنا، لكنه مستقلّ عنا. ربّما. لست أدري تحديدا، لم أصل إلى هذه المرحلة بعد.
التشفّي النصّي شبيه بالتشفّي المرضي أو بالتحرّش الجنسي. إنه ثقيل وفظّ وبغيض. يجب الاستمتاع بالكتب وبالحياة وبالنّساء بخفّة، وبعد ذلك ترك النسيان يغطّي كلّ شيء.
قراءة كتاب إلى آخر صفحة شكل من أشكال التعصّب الذي لم أقع فيه أبدا.
نتذكّر كلمة أناتول فرانس عن مرسيل بروست “ماذا تريدون؟ الحياة قصيرة جدا وبروست طويل”. كان يجدر قول العكس تماما: بروست قصير جدا والحياة طويلة.
نبرة تحقيريّة شيئا ما، محاطة بهالة من السّخرية، لكن أنيقة، آه كم كنت مستعدّا للتّضحية للتمكن منها! كان عليّ أن أمرّ بمشنقة الجامعة وأن أكمل تدريبي في ادّعاء العلم. حاولت أن أتحرّر من خلال الصحافة، فوقعت في نسقيّة أكثر شدّة. كنت متحذلقا فصرت سطحيّا.
بطاقة رولان جاكّار
وُلد رولان جاكّار في لوزان بسويسرا سنة 1941. اشتغل لفترة طويلة محرّرا أدبيّا في جريدة “لوموند” الفرنسيّة ومدير سلسلة بالمنشورات الجامعيّة الفرنسيّة.
متعدّد الأوجه، لاعب شطرنج وتنس طاولة موهوب، لأعماله أشكال وأجناس أدبيّة مختلفة كالأبحاث النقديّة منها “الاغتراب الباطني” و”الغواية العدميّة” يتبعهما “مقبرة الأخلاق” وكتاب شهير تحت عنوان “فرويد”، ومن جنس اليوميّات “الرّوح بلد شاسع”،” ظلّ هدب”، “يوميّات رجل ضائع” و”يوميّات كسول”، والكتب المصوّرة منها “قاموس الكلبي المثالي” و”العودة إلى فيينّا”.
هنا في هذا الحوار الذي أجراه الشاعر التونسي بالفرنسية أيمن حسن جولة مع الكاتب السويسري الأصل، إنه بالضرورة هازئ كبير، وهو قد يبدو فوضويا.. لكنه في الحقيقة أقرب في تفكيره وسلوكه الصّدامي مع العالم إلى الغنوصيين المؤمنين بقوّة الفكر وطاقة الروح على معانقة العالم بانفتاح هائل، طالما هي متصلة بفكر كوني.
في مكان ما من النص الذي ترجمه له الشاعر التونسي يقول رولان جاكّار “لا أتحمل إلاّ الأشخاص الذين يحمون الآخرين من فظاظة حمل جنسية أو دين، وهم أشخاص تنفلت الأرض تحت أقدامهم”، و”حين فهمت مهزلة أنني سويسري، بدأت في تذوق لذّة سخرية أني من مسقط رأسي”.
إنه كاتب يحاكم بفكره الأخطاء الفاحشة للعالم، ومع ذلك فهو يفعل على طريقته الغنوصية “من حقّ كلّ حقبة أن تعيش هذيانها القاتل. الألمان تمتّعوا بذلك مع هتلر، والرّوس مع ستالين والصّينيّون مع ماو.. لن أسمح لنفسي بمحاكمتهم. لكن عندما يصير المشهد ضاربا في الفحاشة، أفضّل مغادرة القاعة. وذلك لأسباب جماليّة لا أخلاقيّة”.
*ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة الجديد الثقافية اللندنية

















