
صورة المخيم في رواية «اليركون» للأردنية صفاء أبو خضرة
2024-12-02
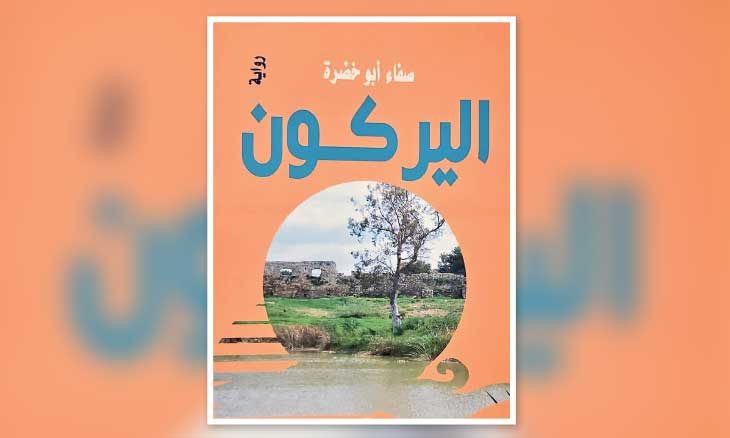
موسى إبراهيم أبو رياش*
فلسطين، جرح لا يندمل، ومُخطأ بن غوريون حين قال: «الكبار يموتون.. والصغار ينسون»؛ فالكبار قبل أن يموتوا يروون قصة فلسطين وجرحها الدامي إلى أولادهم وأحفادهم؛ وصية وأمانة وعهدًا، والصغار، يرضعون فلسطين، في الداخل والشتات، فلا يمكن أن ينسوها، وإن نسوا ذات يوم، فيتكفل العدو الصهيوني بتذكيرهم بعدوانه المستمر على مدن وبلدات فلسطين، وجاء عدوانه الهمجي النازي بعد 7 أكتوبر، ليعيد القضية الفلسطينية بكل أبعادها إلى الواجهة، ليس أمام الفلسطينيين وحدهم، بل أمام العالم كله، مؤكدًا إجرامه ووحشيته وساديته.
وتجيء رواية «اليركون» للأردنية صفاء أبو خضرة، لتؤكد أن قضية فلسطين حيّة لا تموت، وتتوارثها الأجيال، وما تزيدها الأيام إلا اتقادًا وضرامًا، فلا أحد ينسى، ومن يستطع أن ينسى جرحًا ما زال ينز في قلبه؟! حيث تعيدنا الرواية إلى النكبة وما سبقها وما تلاها، وإلى مخيمات الشتات، وسرقة العدو الصهيوني المادية والمعنوية لكل شيء فلسطيني، وطمسه لمئات القرى الفلسطينية، وملاحقته لمن يحاول التذكير بها وفضحه، بالإضافة إلى سجون الاحتلال وما يتعرض له الأسرى من تنكيل وتعذيب وقهر وظلم لا يوصف، وأثر ذلك اللاحق على أجسادهم ونفسياتهم وعقولهم.
تسير الرواية في خطين، يبدوان متباعدين، ثم يتقاربان تدريجيًا حتى يتلاقيان في النهاية. وتتناول هذه المقالة صورة المخيم الفلسطيني كفضاء مركزي يعكس صورة القهر والفقدان المستمر، من منظور إنساني عميق، حيث لا يُنظر إلى المخيم فقط كمساحة جغرافية، بل كرمز للمعاناة والتشرد الدائم، وهو المكان الذي يُختزل فيه الألم الفلسطيني عبر الأجيال.
ماهية المخيم
لا يُذكر المخيم الفلسطيني إلا بالعار والهزيمة والضياع والتشتت والخذلان والإذلال؛ وما المخيم إلا مأساة تتجدد كل لحظة، وتذكير بأرض ضُيّعت، ومُقدسات سُلبت، وكرامة اغتُصبت، وحاضر مأساوي، ومستقبل قاتم. وأي حياة إنسانية في المخيم، وسكانه لصق بعضهم بعضًا، لا خصوصية ولا سكينة ولا طمأنينة، تعيش كل أسرة أيًا كان عددها في مكان محصور؛ غرفة واحدة، في العراء، وفضاء لا تتجاوز مساحته مع الغرفة اليتيمة مائة متر في أحسن الأحوال، دون خدمات من أي نوع، حتى قضاء الحاجة، فيتدبر كل أمره أينما وجد مكانًا يستره على أطراف المخيم.
تصور الرواية المخيم كفضاء جغرافي ومكاني قائم على البؤس والمأساة. المخيم هنا ليس مجرد تجمع للاجئين، وليس مكانًا عابرًا، بل هو رمز للفقدان المستمر، وشاهد على تهجير الفلسطينيين من وطنهم، ورمزٌ للهزيمة والانتظار الدائم.
يستخدم السرد في الرواية العديد من الصور الحية التي تصف حال المخيم الذي يعج بالمعاناة اليومية، تتساءل لميس: «أتعرف ماذا يعني المخيم؟ حالة بؤس؟ ربما ضياع؟ تشرد؟ لجوء؟ كذبة أطلقها العالم في لحظة ما؟ خديعة للبشر؟ موت؟ حياة؟ أكداس من البشر الضائعين؟ حالة انتظار؟ حصار؟ خوف؟ قل لي أنت ماذا يعني المخيم بنظرك؟ هل فكرت يومًا أن تزور المخيم وترى البؤس في عيون البشر هناك؟ هل فكرت يومًا أن تزور مركز الأيتام؟ المؤن؟ الطُّعمة؟ أن تمر في الأزقة الضيقة؟ أن تدخل البيوت التي يتكدس فيها البشر بعضهم فوق بعض؟». هذا التساؤل المر الصارخ يفتح أبواب التأمل في البؤس الإنساني الذي يعانيه سكان المخيمات، حيث تفتقد الخصوصية، وتصبح الحياة محاولة للبقاء في ظروف تكاد تكون مستحيلة، ويبرز المخيم باعتباره سجنًا معنويًا وماديًا لا مفر منه، ومكانًا محاصرًا يقتصر فيه الإنسان على العيش على هامش الحياة.
والمخيم مكان يعكس الخذلان والتهميش والقهر والوجع الذي يشعر به اللاجئون الفلسطينيون، والمكان الذي تتكرر فيه المأساة والمعاناة في كل لحظة، فقد كان المخيم في بداياته لا تتوافر فيه أية خدمات، حتى المياه، كانت تأتي يومًا واحدًا في الأسبوع عبر مضخة عمومية، حيث يتجمع الأهالي ليعبأ كل منهم ما يحمل من أوعية. وكانت شوارع المخيم ترابية بائسة، وغرف الزينكو مكشوفة على العراء دون أسوار، ذات سقوف تتسرب منها مياه الشتاء، وتعزف الأمطار ألحانها الحزينة على ألواح الزينكو، ويتبلل الفراش داخلها، وتعيش حولها وبينها الحشرات والفئران والجرذان وغيرها، أما الكهرباء فكانت ترفًا لم ينالوه إلا بعد سنوات طويلة من الانتظار، وباختصار، يصبح كل يوم جديد في المخيم تحديًا جديدًا، وصراعًا وجوديًا من أجل البقاء، في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة.
أما المؤن والمساعدات التي كانت تأتيهم من الوكالة (وكالة غوث اللاجئين)، فكانت تذكرهم بالإذلال، وكأن العالم تقصد أن يضعهم في هذا الوضع المزري ويتصدق عليهم بالفتات، ويظهرهم كالمتسولين، يمدون أيديهم كل شهر لتسلم نصيبهم من المواد التموينية، بالإضافة إلى الملابس المستعملة والبطانيات في بعض الأحيان، ولذا؛ كان بعض اللاجئين يأبون تسلم هذه المؤن لما فيها من إهانة لهم.
ومما يزيد الطين بلة، هذا التنميط والتعميم الظالم لأهل المخيم، فالبعض يراهم مجرمين ولصوصًا وزعرانًا، فالمخيم بحد ذاته تُهمة، وكل مَنْ فيه مُتهمون. تذكر لميس حادثة عندما رفض سائق تاكسي أن يقلها ووالدتها إلى المخيم، وكان تبريره «ما بروح على مخيم كله زعران». من المؤكد أن من أبناء المخيم بعض الأشرار، ولكن التعميم جريمة، ثم هل ينتظرون ملائكة عندما يحشرون آلاف البشر في سجن بلا أي مقومات للحياة «كيفَ لبُقعة صغيرة أن تحتوي آلاف الأرواح الحائمة بأوجاعها ومقفلٌ عليها بشتى أَقفال الكون، لا سماء لهم ولا أرض ولا هواء؟».
المخيم كفضاء اجتماعي وثقافي
المخيم في الرواية فضاء اجتماعي تتشابك فيه علاقات الاغتراب والتضامن بين الفلسطينيين الذين نشأوا في هذا المكان، لا يفصلهم عن بعضهم سوى جدران الزينكو الرقيقة، حيث العائلات الفلسطينية تعيش في أماكن ضيقة؛ «غرفة واحدة لكل أسرة» ولا تجد من يُؤمن لها الحد الأدنى من مقومات الحياة. ويظل الحلم حيًا عند اللاجئ الفلسطيني الذي يسعى للخلاص من معاناته «أدرك أن حلمي أعلى من صفائح الزينكو التي تعلو سقف المنزل»، وهو حلم مشروع بحياة أفضل بعيدًا عن التشرد والفقر والحرمان.
كما أن المخيم مكان لا تكتمل فيه ملامح الطفولة الفلسطينية؛ فالأطفال في المخيمات لا يعيشون طفولتهم الطبيعية بل يُجبرون على تحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم، فهم يعيشون طفولة مشوهة، حيث «يكبر البشر على عجل، ستجد طفلًا يعيل أسرته في العاشرة من عمره؛ لأن أباه مات، أو هاجر إلى حيث لا يدري أحد، أو فر من جحيم المخيم، وجحيم الانتظار إلى الحرب»، فالطفل في المخيم ينضج قسريًا بسبب الظروف القاسية، مما يختزل الزمن ويفقده معانيه.
لا يقتصر المخيم على كونه مجرد مأوى للاجئين، بل هو مساحة من الإبداع والتحدي، كما يظهر في صورة لميس التي حلمت «بسقف غير مثقوب»، في إشارة إلى الأمل في الخلاص والعيش بكرامة بعيدًا عن صعوبة الحياة في المخيم.
ومع أن المخيم سجن مفتوح بشكل ما، لكنه سجن ذو طابع إنساني، حيث تمثل كل شخصية فلسطينية في المخيم «شهادة حية» على نضال الشعب الفلسطيني. ولا تصور الرواية المخيم كمرادف للموت، بل تجسد فيه التمسك بالحياة، والصمود في مواجهة الظروف القاسية. وفي المقابل فإن المخيم سجن معنوي يخلق شعورًا بالانقطاع عن الوطن، ويجعل الفلسطينيين يعيشون في حالة انتظارٍ دائمٍ للمستقبل المجهول، والحياة المعلقة التي لا تعرف اليقين.
المخيم والذاكرة الجمعية
أكثر من كونه مجرد مساحة مادية، يحمل المخيم في رواية «اليركون» رمزية الذاكرة الفلسطينية التي تظل مشتعلة في قلوب سكان المخيم، فهو يمثل الذاكرة الجمعية التي لا تموت، ومقاومة معنوية لا تفتر، يحفظ هوية الشعب الفلسطيني من الطمس، ويؤكد استمرارية القضية عبر الأجيال، حيث يسترجع الفلسطينيون في المخيم أحداث النكبة والتهجير القسري، وذكريات الوطن وخيراته وحكاياته وحكايات رجاله، ويحتفظون بمفاتيح بيوتهم في فلسطين وشعارهم «سنعود يومًا إلى حيّنا»، ولذا بكوا الجدة «مريم» عند وفاتها؛ لأنهم «شعروا جميعًا يومذاك أنّهم فقدوا ذاكرة البلاد، المرأة التي كانت تمدّهم بأمل العودة: بازن الله راجعين يمّا … توكلوا على الله … راجعين». وكانت صورة قبة الصخرة شعارًا يؤكد قدسية العودة، ولا يخلو منها منزل في المخيم «معلقة على جدار القلب والروح قبل أن تعلق على الجدار».
وعلى الرغم من قسوة الحياة في المخيم، إلا أن الذاكرة تعيش في المخيم كجزء لا يتجزأ من الهوية الفلسطينية، فالروح المعنوية للاجئين الفلسطينيين، رغم واقعهم المؤلم، تظل مشبعة بالحنين إلى الوطن، وإيمان عميق لا يتزعزع بحق بالعودة، لأن فلسطين لكل لاجئ وإن لم يرها أو يعش فيها «وطن يسري كالدم في عُروقه، وكالنايات، الحزن لحنُها الدائم، لأنها تحنّ إلى أصلها الذي اقتطعتْ منه».
وإصرار الفلسطيني على التمسك بذاكرته الجمعية، وعدم السماح بأن يستبيحها العدو أو ينتحلها لنفسه، هو ما أدى إلى استشهاد غسان وسجن وتعذيب لميس، فالعدو الذي اغتصب الأرض، يحاول جاهدًا طمس كل وجود فلسطيني، بما فيها أسماء القرى والمدن، وما لم يستطع طمسه يحاول أن ينسبه لتاريخه المزور، ومنها «اليركون»، الاسم الكنعاني لنهر العوجا، الذي يدعي العدو أنه اسم عبراني.
وبعد؛ فإن «اليركون» للأردنية صفاء أبو خضرة، الصادرة عام 2024 في عمّان عن دار الفينيق، رواية تؤكد أن فلسطين قضية أبدية لا تموت، وتصور فلسطين كروح حية تتنقل بين الأجيال، تستمر في اجتياز الحواجز والصعاب. ونجحت الرواية في تقديم صورة مؤلمة وصادقة وواقعية عن المخيم الفلسطيني الذي يعكس المعاناة والظروف القاسية، ومسرحًا للحياة والموت، ورمزًا للشتات والنكبة، وشهادة على المعاناة المستمرة والصراع من أجل البقاء، وهو أيضًا رمز للنضال الفلسطيني والتحدي المستمر لطمس الهوية والذوبان، وفضاء يحمل مزيجًا من الألم والصمود. وتأتي الرواية توثيقًا إنسانيًا عميقًا لمعاناة الفلسطينيين وحلم العودة. وتعكس الأمل في المستقبل والتصميم على مواجهة الظروف القاسية، مؤكدة أن فلسطين ليست مجرد مكان، بل هي ذاكرة وعزيمة وأمل وهوية وقضية وجود وعقيدة في وجدان كل فلسطيني.
*كاتب اردني فلسطيني



















