
إبداع مغاير : الريف والمدينة في الرواية العربية
2025-01-23
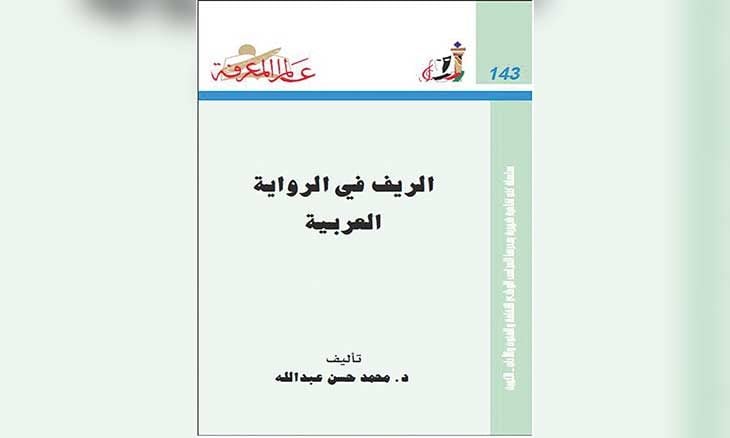 مصطفى عطية جمعة
مصطفى عطية جمعة
من المفارقات في نشأة الرواية العربية في العصر الحديث، أن البواكير الأولى لها جاءت معبرة عن عالم الريف العربي في فضاءاته المختلفة، كما في وادي النيل، وأرض الرافدين والريف الشامي، وقرى المغرب العربي وبلاد اليمن وعمان.
وقد عمد جيل الرواد من الروائيين العرب، في محاولاتهم الروائية الأولى إلى تصوير واقع الريف العربي بكل ما فيه من تفصيلات، ما يدفعنا إلى إصدار حكم بأن التجارب الروائية الأولى كُتِبت لتصوير الريف، وإن كان مبدعوها مقيمين في المدن، ولكنهم منتمون في غالبيتهم إلى العائلات الريفية. وكأنهم رأوا أن الريف هو الأصل، وأن المدينة فرع، على الرغم من العراقة التاريخية لمدن كبرى مثل، القاهرة ودمشق وبغداد والقيروان والجزائر ووهران، وفاس ومكناس، والأبيّض وعطبرة.
فالريف هو أساس الحياة وعماد الاقتصاد في العالم العربي، وفي وسط قراه، تكونت المدن، ونشأت الحواضر والعواصم، فحياة الريف عنوانها الاستقرار، حيث الأرض مصدر الخير والعطاء للإنسان، والفلاح ملتصق بأرضه، ومجاور لأبناء عشيرته، ويكاد يكون مجتمع الريف العربي متكاملا، فالقرية العربية تنتج كل شيء: الخضر والفاكهة والحبوب من الأرض، ومشتقات الألبان من البقر والجاموس والغنم، وتدخل في تبادل تجاري وعلاقة نفعية مع غيرها من القرى، وتصدر فائض إنتاجها إلى المدن، كما تستورد منتجات المدينة من مصنوعات ومنسوجات وآلات.
إن المفارقة الواضحة في ما نلاحظه في أطر المدن العربية الحديثة، وأيضا القديمة، أن الريف يقع على حوافها، أو بالأدق تحيط بها القرى والنجوع والكفور، بل إن الناظر في تاريخ كل مدينة عربية، يكتشف أنها كانت قرى في الأساس، ونمت جرّاء عوامل عديدة، لتصبح مدنا، وبدت العلاقة بين الريف والمدينة قديما، أقرب إلى التكامل منها إلى التصارع والتزاحم، وأحزمة الفقر التي تحيط بالمدينة العربية المعاصرة. فكثير من المدن العربية التي نشأت في العصر الحديث تمت إعادة تخطيطها، وفقا لنظم العمارة الغربية، من جهة تنظيم الشوارع، وشكل البيوت، خاصة في الأقطار التي سقطت تحت نير الاستعمار الغربي مبكرا، كما هو الحال في أقطار المغرب العربي ومصر والسودان، ما أوجد ازدواجية في الحياة، فوجدنا حياة حضرية مدنية في المدينة، وحولها في أطرافها حياة قروية ريفية، الطابع والمعيش والملبس والعادات والتقاليد، ما أدى لوجود أشكال من الصراع الاجتماعي الخفي أو المعلن بين القرويين والمدنيين، تعزز مع الزيادة السكانية، وظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة بعد الاستقلال، بكل مظاهرها وآثارها، وأبعادها الثقافية والاجتماعية، إلى جانب نظرة أهل المدن إلى أبناء الريف وما فيها من استعلاء حضاري وثقافي، ومنظور الريفيين المتمسكين بالعادات والتقاليد والقيم، ضد ما يأخذونه على أهل المدن من انفتاح في العلاقات الاجتماعية والأسرية، وحرية المرأة، وجرأة المثقفين والمتعلمين.
وفي هذا الصدد، يجدر بنا نقاش إحدى القناعات النقدية المتواترة في النقد العربي الحديث؛ بأن الرواية العربية بوصفها فنا أدبيا حديثا مقتبسا من الغرب؛ جاءت معبرة عن تطور المدينة العربية في العصر الحديث، على نحو ما يقول محمد حسن عبد الله في كتابه «الريف في الرواية العربية»: «إن الفن الروائي اُبتدِع ليعبِّر عن المدينة وليس الريف أو القرية، وارتبط ازدهاره بنشأة المدن الكبيرة، وارتبط ازدهاره بنشأة المدن الكبيرة، وانتشار التعليم، لأن الرواية فن يُقرأ، كما ارتبط بحصول المرأة على قدر من الحرية الاجتماعية، خاصة حق العمل وحق الحب اللذين يتيحان قيام شبكة من العلاقات تسمح بصنع نسيج فني متعدد الألوان، فيه من عناصر الكشف والتشويق ما يغري بالاستزادة».
ونستغرب من هذا المنظور، ذي الحكم المسبق؛ بأن يقصر فنا أدبيا على بيئة بعينها، يعبّر عنها، ويتوجّه مبدعوه إليها؛ فهل يمكن أن نقصر الشعر العربي على البيئة الجاهلية الصحراوية فقط؟! فالشكل الأدبي، أيا كان، لا يعرف بيئة، وإنما هو وسيلة إبداعية، يتم توظيفها وفق موهبة مبدعيها، لا تنحصر في مكان أو زمان، أو أفراد أو فئات. كما أن التبرير المقدّم لهذا الرأي يجعل الرواية معبرة عن أجواء المدينة المنفتحة: العمل، والحب، والعلاقات العاطفية والاجتماعية، وكأن الريف لا يعرف هذه العلاقات.
إن الرواية فن سردي، يوفّر أطرا وقوالب وأساليب للحكي، يمكن استخدامها للتعبير عن الإنسان ومشاعره، والأحداث التي مرت في حياته، أيا كانت البيئة التي سيعبر عنها. وحقيقة، فإن الواقع الإبداعي العربي والعالمي على الصعيد الروائي يرد بقوة على هذا الرأي، ذلك أن الرواية العربية استطاعت أن تكون الشكل السردي الحديث الذي يقدم سرديات عن مختلف البيئات والمجتمعات والأزمنة والأجيال والقضايا العربية، بل إن الريف حظي بالنصيب الأوفر في الإبداعات الروائية، ومنه خرج الروائيون الكبار، وكتبوا عن عالمه وعلاقاته الاجتماعية والعاطفية ومشكلاته وأزماته، بما يدفعنا إلى القول إن الرواية قدمت الريف بكل دقائقه وتفصيلاته وناسه، وبكل ما فيه من بيوت طينية وأبراج حمام، وبشر متسامحين، ومياه صافية، وأرض خضراء، وكذلك مختلف الصراعات التي تحفل بها القرية، بين العائلات الغنية والفلاحين البسطاء، وبين الأفراد بعضهم مع بعض، وعشنا قصصا للحب مع خرير الماء العذب وهو يداعب المزروعات.
وهي القناعة نفسها التي تربط نشأة الرواية العربية بعصر النهضة العربية الحديثة، وظهور مدن جديدة، لم تنشأ كتطور طبيعي للقرية العربية، وإنما أُنشِئت بقرارات فوقية، اتخذتها السلطة الاستعمارية، أو الحكومات التي جاءت بعد التحرر من الاستعمار، فجاءت مدنا محملة بكثير من المشكلات والهموم، ومكدسة بالأحياء الفقيرة، والطبقات المهمشة، ما أوجد أزمة على صعيد السرد، عبّرت عن الأزمة في الحياة المدنية العربية. وكثير من المدن العربية الحديثة، بُنيت مجاورة للمدن القديمة، أو على أنقاض أحيائها القديمة، في محاولة للجمع بين التراث والحداثة، ولكن كانت المحصلة مدنا مشوهة العمارة، سيئة التخطيط، فيها أحياء راقية على النظام الأوروبي، وفي مقابلها أحياء شعبية تشبه في تخطيطها القرية الريفية.
وهو الرأي الذي تصوغه يمنى العيد في كتابها «الرواية العربية: المتخيل وبنيته الفنية» مؤكدة أن الرواية فن يستجيب لكل ما نحن بحاجة إلى قوله بالفعل، وقد أقبلَ على إبداع فنها روائيون عرب، مع بدايات النهضة والانتقال إلى حياة مدينية مربكة، يتجاور فيها القديم والحديث بكل مكوناته وظواهره التي تخص الثقافة والعمارة واللباس والسلوك، ومجمل نظم العيش وتقاليده. لقد كانت الكتابة الروائية العربية تواجه قلقا والتباسا، ليس فقط على مستوى المسرود، أو الحكاية التي هي حكاية الواقع المعيش؛ في نهضته وحروبه وهزائمه، وما يُبنَى وما يُهدَم؛ وإنما عانى أيضا قلقا على مستوى المتخيل، وقلق المتغير والمختلف، وقلق الإفادة من تجربة الآخر، دون السقوط في التقليد والمحاكاة، والعجز عن قول ما تود الكتابة قوله.
وربما تكون وجهة نظر يمنى العيد تنظر إلى القضايا والهموم وأشكال السرد التي قدمتها الرواية العربية، في مراحلها المختلفة، ولكنها وجهة نظر تحمل فصلا بين الريف والمدينة من جهة، وهما في رأينا كل واحد، ذلك أن المدينة العربية الحديثة استوعبت ملايين من أبناء الريف، خاصة الفئات المتعلمة منهم، الذين جاءوا للمدينة للتعليم أولا، ثم استقروا فيها للعمل في المصانع والمتاجر والشركات والمؤسسات الحكومية، ولكن لم تنقطع روابطهم عن قراهم، بل ظلوا على تواصل دائم مع أهلهم فيها، وحملوا أيضا إلى المدينة كثيرا من عادات وقناعات القرية.
كما أن أزمات المجتمع العربي وتحولاته السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية؛ لم تقتصر على المدينة فقط، بل كان الريف جزءا منها، إن لم يحمل العبء الأكبر فيها، فمن الريف خرج الجنود والضباط الملتحقون في الجيوش العربية، أو حركات مناهضة الاستعمار الأجنبي، وكانت القرى تمد الثوار والثورات بوقود من أبنائها، الذين ضحوا في سنوات الحرب، وشيدوا في حقب السلام.
يمكن القول إن الرواية عبرت عن مظاهر القلق والحيرة واضطراب البوصلة التي أصيبت بها المجتمعات العربية، في العصر الحديث، يستوي في ذلك الريف والمدينة.



















