
مكالمة هاتفية
2023-07-08
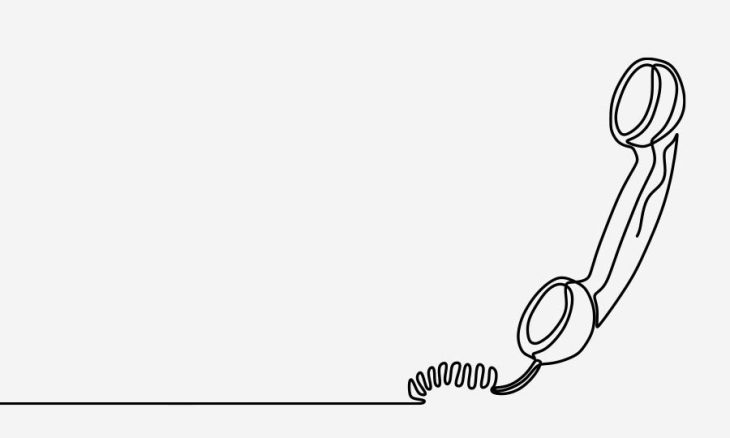
وصال العلاق
أنهيت المكالمة وغرقت في صمت معتم لبضع ثوانٍ. إنها تلك الثواني التي تكمن بين الحقيقة والوهم، حين يتوقف بك الزمن ولا تقوى على فهم ما تشعر به من ألم وخذلان.. أهكذا تنتهي حكايته! كيف له أن يرحل الآن! ما زال لديّ الكثير، الكثير لأخبره به! وما سيحدثني عنه أكثر! عليّ أن أراه مرة أخرى! كيف يكون الهاتف آخر ما سأتذكره عنه؟ كيف لي أن أختزل كل ذكرياتي بنبرة صوتٍ؟ لا عناق، ولا قبلة على الجبين، لا أدمع مالحة ولا ضحكات مدوية!
أخذت أبكي، فأوقف زوجي السيارة وأخرج الأولاد منها ليتركني وحيدة، حينما بدأت بالصراخ بأعلى صوتي! لم يكن ذلك صراخاً، بل عويل حيوان جريح! ما زلت أذكر نظرات أولادي المذعورة إليّ وهم يبتعدون عن السيارة، لم أكترث للرعب الذي زرعته فيهم لحظتها، فلم يعد هناك ما أكترث له مطلقاً: لقد عاد وغادر دون أن يلحظه أحد! كم انتظرت عودته من غيابه الطويل! غياب تقبلته رغماً عني بمرور الوقت، حتى أصبح مجرد ذكرى من الذكريات التي تضج بها حياتنا الوعرة. لا يسعني نسيان ذلك اليوم حين رن الهاتف. كان اتصالاً من أمي، صوتها مشحون بالسعادة والحماس:
ـ لقد عاد عمك!
لا أدري ما اعتراني لحظتها، أهو الفرح أم الذهول؟ هل عاد حقاً! من أين؟ لم أتوقع عودته مذ رحل وأنا في الثانية عشرة من عمري! قد رأيته للمرة الأخيرة حينها، إذ جاء إلى بيتنا، وجلس مع أبي لبعض الوقت، ومن ثم غادر دون سلام، دون وداع، دون نظرة أخيرة. لم يقل كلمة واحدة حين مضى، لكني لم استغرب وقتها، فكيف لي أن أدرك بإنها كانت لحظة وداعه الأبدية!
مرت بنا الأيام وأخذتنا الحياة في دهاليزها المعتمة، لكنه كان حاضراً في ذكرياتنا وأحاديثنا عن بغداد.. لم أعرفه جيداً، لكنني أذكر انه كان هادئ الطباع… لم أسمعه يرفع صوته لأي سبب كان، ولم أسمعه يقهقه ضاحكاً أو يبالغ في غضبه أو انفعاله. كان وديعاً ومنطوياً على نفسه، وأذكر انه كان متديناً بعض الشيء، غير أنه لم يعلق يوماً على ثيابنا، أو ارتدائنا البنطلون أو الكم القصير، لم يتدخل في هذه الأمور السطحية على الإطلاق. لم أعرفه جيداً.. لكني تمنيت لو فعلت! لعقود طويلة أحسست بفقدانٍ لا يسعني فهمه أو تبريره، ولا أذكر أي حديث عنه لم يكن ختامه حزناً وألماً. كلها مشاعر تنبع من تساؤلات تتشعب وتتعقد بلا هوادة: أين رحل؟ أما زال على قيد الحياة؟ لماذا لم يحاول الاتصال بنا؟ لماذا لم نسمع أي شيء عنه، حتى لو شائعات عن لجوئه إلى بلد آخر؟ أين زوجته وابنه؟ لقد حاول أبي البحث عنه وذهب إلى أسرة زوجته للسؤال عنهم دون جدوى..
ـ سأرسل لك رقم هاتفه..
ناديت زوجي: لقد رجع عمي!
فردّ مازحاً: سبحان الله! كلما سمعتكم تتحدثون عنه، كنت أظنه شخصية خيالية ابتدعتموها! ولا وجود لها في الواقع! وها قد حان الوقت لتدحضوا نظريتي!
اتصلت به.. وأخذ الهاتف يرن لبعض الوقت.. لا بد أنها ثوانٍ قصيرة، لكنها مرت وكأنها الدهر بأكمله، ماذا أقول له؟ كيف أبدأ حديثي معه؟ ماذا تقول لمن يرحل عنك بصمت ويُغرِق في غيابه بصمت؟ هل عاد لأجلنا! أم عاد مجبراً! هل أسأله أين كان؟ ولما شطبنا من كتاب حياته كفصلٍ من رواية كُتِب بأسلوب ركيك! هل أعاتبه على..
جاء صوته كالرذاذ الخفيف في يومٍ مشمس! صوت دافئ.. يبعث على الطمأنينة.. إنه عمي! نسيت هذا الجدل الذي خضته مع نفسي للتو! لم أذكر الأسئلة التي سأنهال بها عليه! ولا غضبي لرحيله الفظّ: كان البكاء سيد حديثنا الأول، فلم أتفوه بكلمة أخرى أثناء تلك المكالمة، وحتى التساؤلات التي تملكتني لم تكن سوى دموعٍ تتساقط دونما كلمات. لم يغادرني هذا الإحساس حتى هذه اللحظة.. وكأنني بين اليقظة والحلم! ما زلت أتساءل: هل أعاده الله لنا لبدء صفحة جديد؟ هل منحنا فرصة أخرى كي نكون عائلة حقيقية؟ يا ألهي، لك الحمد! لم يعد أبي وحيداً في هذه الدنيا المتحجرة، ولم يعد عمي مجرد حكاية تروى بين حين وآخر كأنه شخصية أسطورية، لا وجود لها سوى في مخيلتنا الهشة. كنا نتحدث هاتفياً كل يومين أو ثلاثة أيام، وكانت أحاديثنا جميلة، مشوقة. سألني عن أطفالي وزوجي وعن حياتي وإنجازاتي، وكان يخبرني باستمرار كم هو فخور بي! وكلما سألته أين كان كل هذي السنين، وما الذي حدث له؟ يأتي رده هادئاً ودوداً:
ـ سنلتقي قريباً وسنتحدث عن كل شيء!
كنتُ أمني النفس باللقاء الذي طال انتظاره، وكنت أتخيل الأحاديث التي ستدور بيننا، أكاد أسمع ضحكته، وأرى ابتسامته! كان هذا كل ما يشغل تفكيري؛ وأنا أرضع صغيري، وأثناء دراستي، وعندما أذهب للتسوّق.. كيف سيكون لقاؤنا بعد كل هذه الأعوام؟ هل سيحضنني كما يفعل أبي؟ هل سيقبل جبيني بهدوئه المعتاد؟ هل سيدرك مدى حبي له، وكم آلمنا رحيله الغامض؟ هل كان يتذكرنا في غربته؟ وهل تساءل ماذا حل بنا؟ أصبحت تلك الأفكار والتصورات هاجسي الوحيد، حد أني لم انتبه إلى حالتي الصحية الحرجة التي تدهورت بعد الولادة وأبقتني طريحة الفراش في المستشفى لعدة أيام. غادرت المستشفى وحاولت الاتصال به.. لكنه لم يجب. عاودت الاتصال عدة مرات لكنه لا يجيب! ما الذي حدث يا ترى؟ هل هو مستاء لأني لم أتصل به في الفترة الماضية؟ هل انشغل بزيارة الأقارب ولم ينتبه للمكالمات الواردة؟ هل أحس بالوجع الذي يسببه غياب المرء دون مبرر؟ بدأت أفكر بطريقة للاعتذار له، وما يمكنني قوله أو فعله كي أصلح ما هدمته رغماً عني، لكني لم أجد جواباً شافياً، فما زال يرفض الردّ على مكالماتي.
خرجنا بعد يومين لزيارة والديّ فاتصلت بهما ونحن في الطريق إلى هناك: أردت أن أهنئ أمي بمناسبة عيد الأم، ولأتأكد من أنها وأبي في البيت. جاءني صوتها كئيباً، متجهماً، مختلفاً تماماً عن صوتها الذي بشّرني بعودته قبل شهرين:
ـ نحن في طريقنا إلى المطار، عمك ليس على ما يرام.. ووالدك يريد أن يكون إلى جانبه.
كانت مكالمة مقتضبة، تركتني في حيرة من أمري. مكالمة انتهت دون أن أفهم ما الذي يحدث، مكالمة أشعلت فيّ نار القلق والشك وملأتني بأحاسيس لا أريد اختبارها.. ففكرت في المحاولة مرة أخيرة، سأتصل به! قد يردّ أحد أفراد العائلة!
لم أستمع إلى كل ما قيل عبر الهاتف، فقد سقط من يدي وأنا أرتجف، إذ أدركت بأن كابوسي أصبح واقعاً.
من ينتشلني مما أحسه الآن! من يوقف هذا النحيب الذي يأبى أن يهدأ! من يمنحني لحظة كي أستوعب فداحة ما حدث! حين تمالكت نفسي لوهلة، تذكرت ما أرعبني أكثر من الموت، والغياب، والفقدان: أبي! أخذت أصرخ كالثكلى: أين الرحمة! وأين العدل يا رب! هل استكثرت عليه هذا القليل من الفرح؟ أما كان لك أن تمهله حتى يرى من يحب! بدل أن يذهب الآن كي يواريه التراب، وكي يعيش اليتم من جديد!
كاتبة ومترجمة عراقية



















