
قال إن جيل الستينيات كان يعجّ بالموهوبين والأدعياء
علي جعفر العلاق: كنت منذ البداية أبحث عن اختلافي
2022-04-23
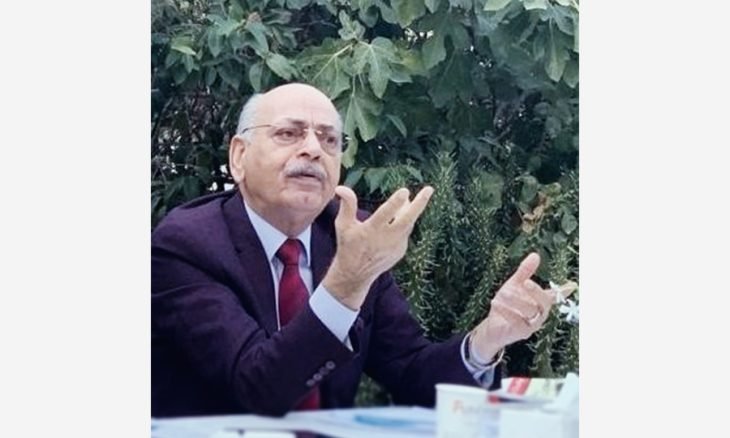
حاوره عبد اللطيف الوراري
حياة هذا الشاعر الواسطيّ من حياة قصيدته التي كانت علاقته بها تتجدّد في كل مرة، باعتبارها سماءً مبتلّةً بالفضة، أو امرأةً تنبثق من جرح في الريح، فيما هو يرتفع بآلامه وآماله إلى مستوى الرؤيا خفيفاً، مُشعّاً، ومفتوناً بحزنه العظيم عبر دبيب اللغة البلّورية الصافية. وبالقدر نفسه كان يصغي إلى ذاته في زمنها، مثلما كان يُلْقي بالاً وارفاً على تجارب الآخرين بوصفه ناقداً ومُفكّراً في قضايا عصره.
في هذا الحوار، يتحدّث الشاعر العراقي علي جعفر العلاق عن أسرار قصيدته، وكيف ينقلها إلى حيز المكتوب المحسوب، ومصادر إلهامها وإيقاعها المائي، وتجربتها العابرة للأشكال جميعها، وعن استخدامه لأقنعة التاريخ والأسطورة من أجل تعميق رؤيته الملحمية للعالم، وعن جيل الستينيّات الشعري في العراق الذي تأثر به وعايش أساطيره الصاخبة.
دعني أسألك هذا السؤال الموجع: ما الذي جاء بك إلى هذا الوديعة الغامضة التي تُسمّى الشعر؟
يبدو أن الطفل، في الريف، يولد على مقربة من الشعر، أكثر من طفل المدينة، لقد وجدت نفسي في قرية مائية بامتياز، تتجاور فيها المتناقضات إلى أقصى حدّ: الطين والضوء، الفقر والغنى، الموت والماء. كنا نجلس إلى هذه المتناقضات جنباً إلى جنب، نصحبها إلى النوم، ونشمّها في غناء الأمهات. كان كل شيء في تلك القرية البعيدة يحرضني على البوح: غناء الفلاحين في مواسم الحصاد الصافية كالذهب، احتفاؤهم بالموت أو إقبالهم على الحياة، سهرهم الطويل وهم يرافقون الأنهار في تجوالها الليلي، يفتحون جرحاً مائياً هنا، أو يلحمون جرحاً مائياً هناك. كان كل شيء حولي يغنّي أو يبكي، يشكو أو يتأوه. كل شيء تماماً: الريح والنباتات، الطيور والناس، الخيول والمطر.
أنت من إحدى قرى واسط. ماذا حملت منها في طريقك إلى الشعر، وإلى بغداد والعالم؟
لقد حملت من قريتي الجنوبية الصغيرة، وأنا في طريقي إلى بغداد، أمشاجاً من تأثيرات كثيرة، عادات، وشعائر، وأنماطاً من السلوك الوجـداني والانفعـالي. وربما كان الشعر الشعبي، أو القصيدة العامية هي أحد تلك الانماط. كانت تلك القرية، كأية قرية عراقية، تموج حد التوتر بكل ما يثري النفس، ويغذيها بحس الفجيعة أو فورة الفرح، وتلقائية التعبير ولوعته. وما تزال ذاكرتي تضجّ بتلك الانفعالات المنفلتة من عقالها، أيام الأعياد، أو مآسي التاريخ، والمناسبات الاجتماعية، وتقلبات الفصول والمواسـم كالحصاد، والتنادي لدرء الفيضانات، أو استعراضات القوة أو التلاحم من خلال التجمعات القبلية. هذه الفعاليات الكثيرة، التي كنت أحضرها بصحبة والدي غالباً، لا يتم التعبير عنها أو تجسيدها، بغزارة استثنائية جارفة، إلاّ عبر الصوت، والكلمة، والإيقاع.
لقد كان الصوت، الذي هو صميم تلك الفعاليات وخيطها الموصل إلى الروح، يأخذني إلى أقصى مديات الانفعال ممثلاً بالأهزوجة المرتجلة، هلاهل النسـاء، المغنين الريفيـين، الأغاني الغجريـة، نايات القصب النائحـة، إطلاق النار في الأعـراس والمآتـم والأعيـاد.
وكان للكلمة حضورها الملهب للوجدان أيضاً، أعني القصيدة الشعبية، بإيقاعاتها العديدة، كالموال أو الزهيري، والأبوذية. وكانت الحركة التي ترافق هـذه الفعاليات جميعاً: رقصات الغجر الضاجة بتشهيات الجسد ونداءاته، وقـع الأقـدام المنفعلـة في دبكات الجوبي، اندفاع الأجسـاد وتراجعها وسط الغبار وحركة الريح.
ولا أنسى أبداً ما تتركه الأهزوجة الشعبية من انفعـال رجولي فـذّ، في حركـة الهازجين ووجـدانهـم، وهم يجسدون تلك اللحظات العامرة بالزهو والتباهي. كان هـذا المزيج الحميم أو الجارح، من الإيقاعية والكلمـة والحركـة، يأخـذ طريقـه ليذوب في أعماق ذلك الطفل الذي كنته آنذاك، وينسرب إلى ذاكرته ومخيّلته اللتين ظلّتا فياضتين بالحنين واللوعة والغرابة.
هل يمكن القول إنّ الثراء الإيقاعي الذي نكتشفه في شعرك دائماً، يعود إلى هذا المصدر بالذات؟
إلى حدٍّ كبير، وكأنني خرجت من قريتي، في لواء الكوت، بذاكرة منقوعة بالإيقـاع ومخيلة قابلة للاشتعال في أية لحظة. ولا بد لي من القول إنني كنت، إلى هـذا الحـدّ أو ذاك، على صلة بمقطوعات، وأبيات من الشعر الفصيح أيضاً. لقـد كان والدي، وهـذه إحدى مفارقات طفولتي كما قلت سابقاً، يعرف القراءة والكتابة. مفارقة قد تبدو عصية على التصديق في ذلك الوقت.
ما هي أهمّ الأحداث والمصائر، الشخصية والجمعية، التي ألحّت عليك في تجديد النظر الشعري، أو هي مثّلت قطائع في حياة قصيدتك برمّتها؟
يلعب السجـلّ الشخصيّ للشاعر دوراً كبيراً في تجديد روحه، والصعود بها إلى أرقى طرق التعبير عنها وأكثرها حيوية. ولا يقف بعيداً عن هـذا المؤشر المشهد العام، الاجتماعي والسياسي والثقافي. وقد لعب هذان العاملان دورهما متضافرين بالنسبة لي. كان لا بُدّ من مراجعـة تجربتي والتحقق من جدارتها الشعرية، ومتانة صلتها بالمشهد الشعريّ في أفضل تجلياته. من جهة أخرى، كنت وما أزال لا أثـق كثيراً بالقفـزات الفنيـة المفاجئة في تجربـة شاعـر مـا. النار المتأنية، والصابرة. التطور الذي تنضج فيه التجربة بعمق وبطء وعلى مهل. هذا ما أسعى إليه دائماً. إن القفز من شجرة إلى أخرى ليست خاصية شعرية دائماً، فهو يضيع على الشاعر، في الغالب، فرصة النموّ الداخلي المتناغـم، ويقطع عليه خيط مسيرتـه النامي الذي ينتظـم مراحلـه كلها، ويخترق تحوُّلاتـه بحبـل شـعريّ وإنسـانيّ متصـل.
في أعمالك الأخيرة ثمّة عودة إلى الأساطير والرموز والأقنعة التراثية والتاريخية. هل يمثّل ذلك بديلاً من حنين ما، أو عزاء في المنفى؟ وبالنتيجة، هل لنا أن نقول إنّ ثمة طفرة من عالم الطبيعة الحسّي والأليف إلى أتون الأسئلة الكونية ذات المرجع الميتافيزيقي والحضاري؟
قصائدي، في معظمها، لا تحيا بعيداً عن هذه الأجواء، كان التراث بكل تجلياته على مرمى آهـةٍ منّي منذ قصائدي الأولى. وربما كان ابن زريق البغدادي أول الأقنعة التراثية في مجموعتي الأولى، وكان الكثير من الإبداع الشفاهيّ العراقيّ، والإبداع المـدّون، في الماضي والحاضر، عراقياً وعربياً وعالمياً، يقع في مدى الوظيفة الشعرية لقصائدي.
بعد الاحتلال، وجدت نفسي في مهبّ كثافة أسطوريّة نادرة. كان العراق، بكل ثرائه الأسطوريّ والشعريّ والروحيّ، يهدر في الأعماق، ويتسرب إلى عـروق القصيدة، ويشكل الكثير من ملامح البناء وفداحـة المعنى. كان حضور العراق، بهذه الكثافة الروحية، مقاومة شعرية لما يتعرض له من إبادة وامتهان على المستوى الفعليّ. يمكنني القول إن الانتقال من فضاء الطبيعة وفتنتها العارية إلى متاهة الأسئلة المرة يعود إلى بداية التسعينيات، تحديداً مع ديواني «أيـام آدم» الذي صدر في بغداد عام 1993. وقد أشار إلى هذا التحوُّل أكثر من ناقـد، وربما كان حاتم الصكر أسبقهـم إلى تأشير هـذا التحول.
مع التحوُّل الجمالي الذي تمرُّ به تجربتك، هل تعتقد أنّ جملك الشعرية في قصرها وكثافتها قادرة على استيعاب رؤيتك الملحمية الجديدة إلى الذات والعالم؟
ألا ترى معي أن الصدمة الشعرية لا تتحقـق، في الغالب، إلاّ بفعل هـذه اللغة الشعرية الخاصة؟ لا أميل إلى الشعر الذي يتنازل عن شمائله، عن توتره، وكثافته، وإيماءاته الخاطفة. هذه الخاصية تضاعف من قدرة الشعر على تأجيج خميرة التوتر، والوصول بإيقاع الروح إلى أكثر منحنياتها حيوية وإثارة. أضيق أحياناً بالقصيدة التي تنفتح، بشراهة، على مكاثرة الكلام، واستقدام التفاصيل الزائـدة عن حاجـة القـول الشعريّ، هـل هي أكذوبـة النفس الطويل مرة أخرى؟ أم هو دفع القصيدة إلى مزاحمة غيرها، من أنماط القول، التي تتسع بطبيعتها لانهماكات الفكر، واستفاضاته القاهرة لحكمة الإيجاز.
يلاحظ أنّ شعرك، رغم ما عاشه من عصور وأحداث مضطربة سياسيّاً وفكريّاً، بقي بمنأى عن أن يتأثر بالأيديولوجيا أو بالواقعية الفجّة، وهو ما كان كافياً أن ينقذ ماء كتابتك، ويجعلك راهنيّاً باستمرار. هل هذا ذكاء الشاعر، أم استراتيجية الرائي؟
كنت منذ البداية، أبحث عما يجعلني مختلفاً عن سواي. ما يعزز إحساسي دائماً بأنني لا أشبه شاعراً آخر، ولا أمتّ بقرابة شعرية إلى أحد. ووسط تلك الأجواء المعبأة بالصخب والدخان والشعارات وألوان الانتماءات البراقة، حاولت وبضراوة لا تعرف الادعاءات، أن أنأى بقصيدتي عن تلك الولائم الأيديولوجية، وما يشيع فيها من شللية ومجاملات.
إضافة إلى هذا الهاجس، أعني النزوع إلى الاختلاف في السلوك الشعريّ والحياتيّ، فإن قَدْراً من المقاومة الصامتة، أو قَدْراً من الوعي، إن شئت، كان يحصنني ضد الانغمار في تلك المظاهر غير الشعرية، التي مارسها البعض مؤمناً، أو منتفعاً، أو مضطرّاً.
صار من المألوف اليوم، في حقل الدراسات النقدية، «تجييل» الشعراء أو تصنيفهم إلى أجيال. في تاريخ الشعر العراقي، نعرف الطفرة النوعية التي أحدثها جيل الستينيّات، بمرجعيّاته ومصادر كتابته، في تحديث القصيدة على صعيدي الشكل والمضمون. ما وضع كتابتك ضمن هذا الجيل أو الذي أتى بعده؟
كنت من جيل الستينيات، ولم أكن منه تمامـاً. كان جيلاً شديد الحيوية، وكان متنوع النبرة ومتعدد الانتماءات السياسية إلى حـد كبير: منهم التجريبيّ حد الفوضى، وشاعر التفعيلة، وشاعر النثر. وكان بينهم الماركسيّ، والقومي، والمستقلّ. أتيت إلى هذا الجيل متأخراً، في النشر، نسبياً، واختلطت بالكثير من شعرائه، بحذر شديد. كان يعجُّ بالمواهب الكبيرة، لكن فيه الكثير من الأدعياء أيضاً، ولو عُدْتَ إلى صحافة الستينيات لعجبتَ من تلك الكثرة الهائلة من الشعراء الذين أغرقوا صحافة تلك الفترة بالضجيج حيناً وبالوعود الجميلة حيناً آخر. أين هم الآن؟ كنت أترك شراعيَ لريحٍ خاصة، ولم أكن أعبأ كثيراً بصخب المراكب المجـاورة، ولم أكن أعنى بالشلليـة التي لا تثمـر، في الغالب، غير الصداقات النيئة.
في ذلك الجوّ الذي كان يزدحم بالمواهب الحقيقية، كان للادعاءات، والصراخ الأيديولوجي، والمطولات الشعرية حضورها أيضاً. كنت من أكثر الشعراء احتفاءً باللغة والصورة: أنكبّ على قصيدتي، وأحيطها بالكثير من العناية لأخلصها من الاستطالات، وباروكات اللغة الزائدة. كنت أسعى، وما أزال، إلى كتابة قصيدة قلبيـة، ملمومـة، صافيـة ومفاجئـة.
في كتابك «قبيلة من الأنهار» (2008) هناك ما يُشبه ردّ الجميل لشعراء وكتّاب عبروا ليل قصيدتك وارتفعوا بأشواقها، من أمثال جبرا إبراهيم جبرا ومظفر النواب ورشدي العامل ويوسف الصائغ وسعدي يوسف ومحمد الماغوط. هل هو نوع من «أدب الاعتراف» الذي يرسّخ آداب الصداقة الشعرية التي تكاد تنعدم في ثقافتنا الحديثة؟
أنا معك في أن الصداقات الشعرية تكاد تنعدم في حياتنا الثقافية. الحياة العامة أكثر صدقاً وأشد براءة. إنها ما تزال تحتفظ بقدر من الفطرة أو التلقائية، وما تزال أكثر احتفاء بالصداقة، وأكثر تعلقاً بقيم الوفاء. ما كتبته في «قبيلة من الأنهار» هو، إلى حد ما، سيرة ذاتية من نمط مختلف، سيرة باتجاهين : سيرتي وسيرة الآخر. وهناك تمـتـدّ، بيننا، سيرة النص باعتبارها سيرة ثالثة.
كيف تتخلق في داخلك القصيدة؟ وكيف تنقلها إلى حيّز الكتابة؟
قد تتشكل القصيدة عندي على شكل صورة مغبشة، أو إيقاع يتيم. قد يأتيان معاً، أو يأتيان منفرديـن، ثم يبدأ ذلك الإيقاع أو تلك الصورة بالاختمار، والتوسع، حجر ينـداح في بحيرة صافية، أو حفيف شجرة بعيـدة لا يكاد يسمع. ثم يكبر شيئاً فشيئاً كلما اقتربت منها.
وقـد تظل بداية القصيدة قابعـة في الظلّ فترة قبل أن تخرج إلى فضائها اللفظي، قـد تظلّ في الذاكـرة أرددها مع نفسي، أو في ورقـة مطويـة، أو قصاصة صغيرة. وقد أكتب قصيدة جديدة بينما تظلّ تلك البداية الشعرية قابلة لكل الاحتمالات. قليلة هي القصائد التي أنجزت كتابتها في جلسة واحدة، أو في يوم واحد. لا أميل إلى القصيدة الطيّعة التي تستسلم لمصيرها دون مقاومة. ويبدو لي أن الشاعر، أيّ شاعر، قد لا يحب القصيدة التي تأتي إلى سريره الشعريّ دونما تمنُّع، وقد ينظر إليها بشيء من الارتياب الفني أحياناً. وفي الغالب، لا يقودني إلى قصيدتي معنى مسبق، أو إطار معـدّ سلفـاً، وإذا حدث ذلك فإن للقصيدة، في الغالب، رأياً آخر. يحدث أحياناً أن أقترح على القصيدة أفقاً لفكرة ما، لكن هذا الأفق قـد يظل مضبباً، وقابلاً للتعديل على مدى كتابة النصّ. وهكذا فإن القصيدة تنفر من التفاصيل الملزمة، وذلك ما يحـدث لي، ولغيـري من الشعـراء كما أظن، في كثير من الأحيـان.
ومع أنني أميل إلى الكتابة ليلاً، إلاّ أن اندلاع الشرارة الأولى يظل عابراً لكل تموُّجات الزمن؛ فهو قد يحدث في الأزمنة جميعاً وفي الأمكنة كلها تقريباً. كما أن زمن الكتابة الشعرية مشوب بالبهجة والتوتر دائماً. وقد ترتفع مناسيب هذا القلق أو تلك البهجة بموازاة فعل الكتابة ذاتها؛ فحينما تستعصي عليّ القصيـدة أكون في أكثر حالاتي كآبـة وشـروداً، ولا أستعيـد طفولتي الأولى ومرحها الجميل إلاّ بعـد أن تسلمني القصيـدة قيادهـا، وتتضح أمامي مسالك الغابـة تماماً.



















