
«كيفما اتفق»! مقاربة في منهج تدريس فن الرواية لدى محمد أنقار
2021-12-30
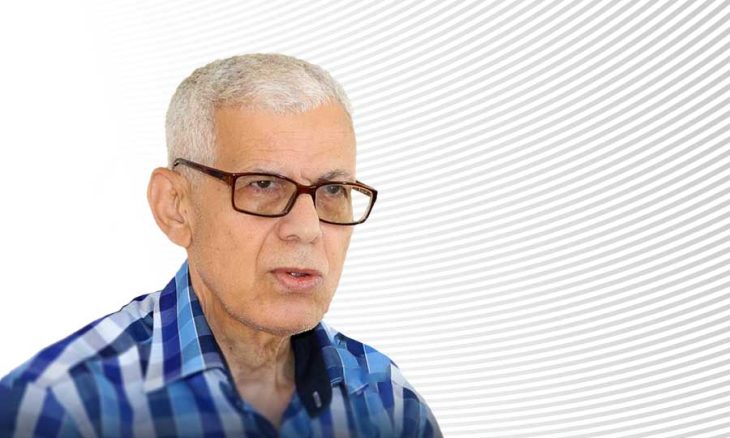
محمد سعيد البقالي
لطالما سعى الراحل محمد أنقار إلى بناء محاضراته الجامعية حول النقد الروائي بالاستناد إلى عملية إجرائية كان يقوم بها بمعية طلابه، وهي عملية يمكن اختزالها، في ما أشرنا إليه من خلال عتبة العنوان، على أنّ صيغة هذا الملفوظ كانت تجري على لسان محمد أنقار كلّما شرع في مقاربة عمل من الأعمال الروائية التي تدفعه إلى تدريسها ومقاربتها داخل أسوار الجامعة، وكأنه بذلك يروم افتراع منهج خاص في التّعامل مع فنّ الرّواية، ينبني أساسا على فاعلية الانطباع الأولي، وكذا الرؤية التأملية اللذين يحصلان مباشرة عقب تصفح رواية من الرّوايات بعيدا عن صرامة النقد ومناهجه، وإملاءات النظريات السّردية عموما، وهو في ذلك ينزع إلى تأصيل «الذائقة النقدية» وتشكيلها لدى الطلاب والباحثين، وكأنّه يودّ ترسيخ فكرة مُفادها أن الأهم في هذا المقام هو تلك الخبرة المكتسبة في التعامل مع النصوص الروائية، وَفق هذه الرؤية التي كانت تتقصى وظيفة في غاية الأهمية عرفت عند منظري السرد الروائي كهنري جيمس وبيرسي لوبوك وستيفن أولمان ومحمّد أنقار بـ»الصورة الروائية» مع التفاوت، بطبيعة الحال، في تنزيل المفهوم على أرض الواقع، لذلك أمكن اعتبارها إجراء منهجيا قمينا بضبط وظيفة الكشف عن الآليات الجمالية المتحكّمة في الإنتاج الأدبي، كما يقول محمد أنقار نفسه في مستهل الفصل الأول من كتابه «بناء الصورة في الرواية الاستعمارية»: الموسوم بالعنوان ذاته «الصورة الروائية».
في سياق هذه الرؤية كان محمد أنقار يدعو طلبته إلى فتح أيّ عمل روائيّ «كيفما اتفق» للوقوف على طبيعة «الصّورة الروائية» التي يختزنها المقطع السّردي، وبذلك يكون فعل تمرير هذا التصور الذي حمله معه طيلة سنوات تدريسه في كلية الآداب في تطوان، أيسر من أي استراتيجية أخرى ربّما لا تفي بالغرض على الوجه الأكمل. إنها محاولة لتشييد أفق نقدي وجمالي يقوم على ترسيخ وعي نقدي وجمالي تجاه النصوص الروائية أيضا، وما تكتنزه من صور، بل وما تفتقر إليه. وبعبارة أخرى فإنّ هذا الإجراء بمثابة ضابط من الضوابط النقدية التي لا غنى عنها في التعامل مع جنس أدبي ممتدٍّ كجنس الرواية.
إنّ إجراء «كيفما اتفق» شبيه إلى حدّ بعيد بتلك العملية التي يقوم القارئ الشغوف للأعمال الإبداعية عند تصفحّه لأي عمل روائي بعد انتقائه من رفوف المكتبات باحثا عن «صورة روائية» تستوقفه ليعلّل انجذابه لهذا الكتاب أو ذاك، وقد يسعفه في ذلك المجهود النقدي المبذول من قبل القارئ في سبيل تحصيل معرفة خاصّة لا تُتاح إلا لمن راكم استكناه النصوص الإبداعية الروائية، لتمثُّل عصارة ما كُتب، أو أن الأمر نظير استخلاص رائحة عطر أخاذ. هكذا إِذاً أضحت هذه العملية توجها نقديا مرتبطا أشد ما يكون الارتباط بمبحث الصّورة الرّوائية. والحق أن هذا التوجه أصبح آلية من الآليات المهيمنة في استنطاق النصوص الروائية، للوقوف على «مكوناتها وسماتها الجمالية» على نحو جلي وواضح.
لقد كان هذا الإجراء جزءا لا يتجزأ من مشروع محمّد أنقار الناقد والأكاديمي تنظيرا وممارسة في الوقت ذاته، وما ترديده لهذه العمليّة إلا لأجل فتح نوع من «الألفة» على حدّ تعبير عبد الفتاح كيليطو بين القارئ والنّصّ، من خلال صورة واحدة، فيكون استحسان العمل وسيلة وغاية عن طريق تلك الصورة كيفما اتفق. على هذا النحو تنطوي هذه العملية على قدر كبير من العمق إذا نظرنا إليها في إطار نسقها الشمولي، الذي يسعى إلى تجسيد صورة كلية للعمل الإبداعي برمته انطلاقا من صورة واحدة وحسب.
والحق أنّ هذا التوجه لم يكن اعتباطيا، بل إنّه يحمل في طياته الكثير من الإشارات الخفية التي تبدو، لأول وهلة، عابرة وحسب؛ فهذه العملية المرتبطة بتصفّح الأعمال الرّوائية تسمح بإعادة تشكيل النّصّ الرّوائي، انطلاقا من صورة واحدة مأخوذة اعتباطا لا عن غير سابق إصرار. علما أن هذا التوجه يسمح، كذلك، بإصدار أحكامٍ نقدية على العمل بكامله من خلال صورة واحدة أو اثنتين على الأكثر… ويبقى هذا الحكم النقدي في حاجة إلى تعليل حقيقي استنادا إلى إجراء تطبيقي لا يتعدى عملية غاية في البساطة «كيفما اتفق» بيد أن ذلك يبقى محفوفا بالمخاطر يستلزم كثيرا من «الحذر المنهجي» الذي قد يسقط فيه الكثيرون، إذا ما تم التعامل مع هذا الإجراء على أساس أنه عملية مستساغة، وفي متناول الجميع.
إن الصورة الروائية الجزئية التي تقدمه رواية «اللص والكلاب» في مفتتحها تتّسم حسب الباحث بـ»الحضور الفعلي» داخل النص، لتظلّ الصّورة الكلية في حالة غياب، يستحضرها المتلقّي بعد اطلاعه على المتن كلّه، اعتمادا على مجموعة من مرتكزات القراءة وقوانينها.
إنّ الإجراء الذي انطلقنا منه في هذه الورقة يمكن تلمس فاعليته التطبيقية والإجرائية، بالنظر إلى استهلال رواية «اللص والكلاب» الذي افتتن به الباحث الأكاديمي محمّد أنقار. يقول نجيب محفوظ: «مرة أخرى يتنفس نسمة الحرية، لكن في الجو غبار خانق وحر لا يطاق». إنّه مقطع سردي فذّ لا يمكنه أن يجعل القارئ عابرا له وحسب، وفي ذلك يقول محمد أنقار في تحليله لهذا المطلع السردي: «تلك ثلاث جمل تبدأ بها رواية «اللص والكلاب». في الجملة الأولى تصوير يقيّدنا، مبدئيا بقراءة ضيقة، نظرا لضآلة مجموع الكلمات ذات السمت المجازي، ولضيق أفق الصورة الجزئية الناتج عن الاستهلاك المتكرر للاستعارة التي تربط في طرفيها بين الحرية والهواء. لكن على الرغم من انحسار زاوية المجاز، فإن موضوع الحرية سيستثير لدى المتلقي وظيفة التساؤل، وسيحفزه على التقييم» «بناء الصورة في الرواية الاستعمارية. وإذا كان الباحث قد استرسل في تحليل هذا الاستهلال منتهيا إلى ضرورة تحليل الصورة ضمن مجموع علاقاتها الممكنة والمحتملة، بحثا عن توازنها وجماليتها ضمن نسق سردي كلي، فإن غايته من ذلك إنما البحث عن «التجانس المتكامل» بين «الصورة الجزئية» التي استهلت بها الرواية و»الصورة الكلية» بطابعها التجريدي الخالص.
إن المقطع السابق، أو لنقل انسجاما مع هذا التوجه النقدي، إن الصورة الروائية الجزئية التي تقدمه رواية «اللص والكلاب» في مفتتحها تتّسم حسب الباحث بـ»الحضور الفعلي» داخل النص، لتظلّ الصّورة الكلية في حالة غياب، يستحضرها المتلقّي بعد اطلاعه على المتن كلّه، اعتمادا على مجموعة من مرتكزات القراءة وقوانينها.
من هنا استطاع محمّد أنقار، أن يجعل من استهلال رواية «اللص والكلاب» لنجيب محفوظ، على سبيل المثال، مرجعا حقيقيا لهذا الإجراء؛ أي كيفما اتفق، وكأنه يهدف إلى جعل طلابه يتطلعون إلى امتلاك «حدس فني» يمكن التوصل إليه من معايشة طويلة للنصوص، إضافة إلى طول الدربة والمراس بلغة القدماء، وهو ما من شأنه أن يتوصل معه كذلك إلى ما تختزنه المقاطع السردية من تصوير تعوّض الصورة المشاهدة، حتى تغدو العملية، في نهاية المطاف، محصلة خبرة طويلة، وممارسة تأملية نقدية للنصوص الروائية زمنا ليس بالأمر الهين.
يستحق محمد أنقار، بالمناسبة، كل التّقدير والثّناء لكونه استطاع أن يقدّم قراءات نقدية تعتمد في إوالياتها هذا الإجراء لبلوغ الدلالات العميقة للنص الروائي، انطلاقا من صورة روائية تبدو للناظر، لأول وهلة، معزولة عما يسبقها أو يلحقها من صور أخرى، بل إنه يستحق كل التقدير، لأنّه جعل من هذه الممارسة النقدية أمرا قابلا للتداول على نطاق واسع بوصفها عملية مستقلة لا تمتّ بصلة إلى مناهج تحليل الخطاب أو مختلف النظريات والمناهج المعاصرة التي يتسلّح بها الدّارس لفتح قنوات تواصل حقيقية مع النّصوص. كلّ ما في الأمر إنّ العملية برمّتها لا تخضع لتلك الصّرامة المنهجية التي تتقيد بها الدراسات التي تأخذ بعين الاعتبار الولاء للمنهج على حساب النص، وهو ما يجعل معظم هذه القراءات إسقاطية لا تفسح المجال لحضور النص أولا وقبل وكل شيء.
كاتب مغربي


















