
الحوارية النصية وأسئلة المتخيل الشعري في منجز عبد الأمير خليل
2021-12-17
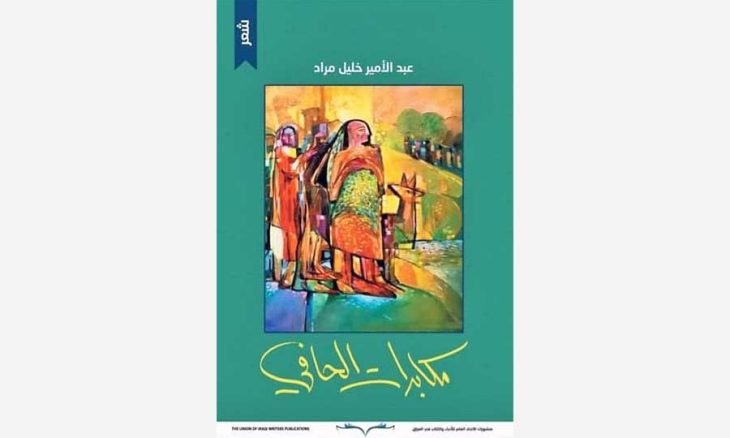
عمر رعد
إن أبرز مفهوم للنص الأدبي أنه بناء يتشكل من مداخل حوارية بين النصوص بملكة التخيل، لخلق فرص التقاء بين متون إبداعية يراهن المبدع على إعادة تشكيلها خارج أصولها تحت سلطة الحوارية، التي تعمل على استدعاء مصادر متنوعة تمثل المهاد الأولى، التي تشكلت المعاني في حدودها؛ فيكون النص الأدبي لوحة تتشكل ضمن فاعلية حوارية وامتصاصية لنصوص أخرى، وهذا المعطى يجعل الشاعر كما هو حال المتلقي أمام أسئلة المتخيل في طبيعة الحوارية، وفي إطار ذلك تتأسس مقاربة عميقة تستوعب متناصات بنيوية: لفظية/ دلالية أو اختزالية/ تضمينية، تدخل النص بعملية إعادة صياغة وإنتاج بدرجات متفاوتة ضمن مسارات حوارية النصوص.
تحقق نصوص الشاعر عبد الأمير خليل تنوعات تناصية تنسجم مع خصوصية التشكيل الشعري، بمساحات التعالق والتماس والامتداد لتصيرها بناء تبئيريا لا يتجزأ من بناء شعري تتمازج مع الوحدات الأخرى في إنتاج المعنى في القصيدة، وإذا تتبعتا قصيدة (أنبؤوني يا بناة العالم) نجد أن عبد الأمير خليل يجعل فضاء القصيدة بحوارية مع بنى قرآنية اشتغل بمدلولات متخيلة تستند إلى انزياحات دلالية: تراكمية/ تقابلية تؤسس جمالياتها التناصية، يقول:
أنا رجل يسعى من أقصى
المعمورة
والجودي يجاهد كي تكتمل الصورة
وحمامة نوح تحفر باسم الله سمو
الأطيان
إذ يحاور هذا النص مع القصص القرآني فيشكل رؤيا مرمّزة بمضامين متحولة في الدلالة، فالشاعر يعمد إلى صياغات تصرف النص إلى مبتكرات المعاني، فتزيح دلالته الثابتة في النص الأول سعيا نحو تشكيل دلالي جديد بسهم بتحولات تتصل بتلك المعاني، إلى جانب لبوسها الجديد في هذا النص، فالتعبير بـ(أنا رجل يسعى من أقصى المعمورة) يتشكل بحوارية نصية تخيلية مع قوله تعإلى: «وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتبِعُوا الْمُرْسَلِينَ» (سورة يس: 20) وما بين النصين علاقة تجاور في الإطار الشكلي الذي تتقابل فيه آلية التشكيل السياقي بين النصين، غير نص الشاعر هو نص يجنح إلى التعبير عن المجال الذاتي المتعلق بشخصية الشاعر؛ ليكشف عن هويته ووجوده الإنساني وسمو المجد وتعالي المنزلة، وبفعل المحاورة التناصية تصبح الصورة مغايرة عن مهادها؛ لتناسب خصوصية أنا الشاعر، فهو كما (الجودي) ثابت الجأش الذي رست عليه سفينة النبي نوح (عليه السلام) لكنه لا قرار له فهو كالجود في ثباته، كالساعي في العطاء، وهما ركيزتان تحولتا إلى بنية تضيف الشاعر معنى سرعة الحركة من أجل غاياته، فهو ما زال (يجاهد) ويكتمل المعنى بتوظيف (حمامة نوح) وهي تجهَد ساعية نحو مجدها، وما في هذه الصورة من إحالات تبرز سمو الغاية في عملية الحفر والبناء، يزيدها توظيف (الطين) هو رمز للطهر والنقاء.
تعمل الحوارية في نصوص عبد الأمير بخاصية التعالق بين النصوص بعضها ببعض، لتنهض بمؤشر أسلوبي يعمل على إعادة تشكيل النص على مستوى البناء اللغوي والتشكيل الدلالي، ما يعني أن النص الشعري يتأسس ضمن تركيب بنيوي معقد في حالة نفي الدلالة أو إثباتها أو انشطارها، وحتى انعكاسها عن دلالتها الأولى، فينفسح إلى تشكلات جديدة يمكن من خلالها بث قراءة تعيد المتلقي إلى النص الأول، ففي قصيدة (كتاب العبور) تتحاور القصيدة مع شخصية النبي يعقوب، وحدث الحزن وشدة البكاء وبياض عيناه، حيث فقده ولده النبي يوسف، عليهما السلام، ومكر أخوته به، كما قال تعإلى: «وَتَوَلى عَنْهُمْ وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَابْيَضتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ» (سورة يوسف: 85) فالشاعر يُدخِل نصه في محاورة للنص القرآني بتوظيف جزئي للمعنى ليتحاور مع الذات في موقفه من الحياة فيقول:
هذي يدي بيضاء لست بلاقط
إلا الحصى من دوحة الأيام
وعلى النياحة استريح كأنني
يعقوب يبكي رقدة الأقلام
فيعقوب عليه السلام (ابْيَضتْ عَيْناهُ) والشاعر يعمل بمغايرة ترتبط بمدلول حسي للإحالة على الطهر والنقاء، فيعمل مؤشر بياض اليد ليعبر عن الموقف الحب المتشكل في الذات، فحوار الشخصية (يعقوب) تعني وجود مشتركات متقابلة في حالة البكاء الدائم، الذي تحولَ إلى مؤشر حسي ونفسي، حين يبكي في رقدة الأقلام، فالبكاء سرد شعوري يوازي عملية الكتابة. ينفتح النص الشعري الحديث على مرجعيات تؤسس لبنيته وينفسح لها فضاءه النصي، ويعد توظيف الشخصيات: الأدبية، الدينية، التراثية، إلخ، مداخل إلى عوالم المخيلة لإنتاج دلالات جديدة، تبعا لرؤى الشاعر ضمن إطار ترميزي، ولو تتبعنا عبد الأمير خليل في استدعائه الشخصيات فسنجد أنه يعمل بمساحة تجزيئية، تشكل صوراً تناصية مع أحداث أو مواقف تتصل بتلك الشخصية، ومدى تعالقها مع ذاتية الشاعر، ولعل شخصية (بشر الحافي) التي قدمها لخلق أبعاد تتصل بالمعنى الذي يفسر الموقف النفسي الذي رشح للمعاني والأخيلة، في قصيدة (من أحوال الحافي وأماليه)
أنا بشر الحافي
وركابي مملوءات حشفا
فربيب المرجانة لم يمنحني ذهبا أو فضة
أنا ممسوس بالضمأ القتال
والجود على شفتي عباس
وعبوس
فالشاعر يتعرض إلى أحوال بشر الحافي، وهو أحد أئمة الزهد والتصوف الذي عرف باستلهام معاني خاصة في العشق الإلهي، وعوالم الروح والعزوف عن سوى ذلك، وفق رؤى تتحصل بوسائل الاتصال والتواصل، فزاده (الحشف) ومتاعه الوصل، ولعل في قوله: (أنا ممسوس بالضمأ القتال) توظيف لمعاني تلك الأحوال، فالمَس حالة تعرض لأحوال ينقطع فيها المرء عن العالم الخارجي ليطير في وحدته مع مدارج اللاوعي، كذلك حالة (الضمأ) وهي إحساس بالحاجة للروي، والمراد هو تصوير لحالة الوصل وملازمة طلبها، فما بين المحبوب والماء مشتركات في كونها وسائل بث الحياة التي تبدو (عابسة) دونه، ومن هنا نفهم أن الشاعر يتناص مع الشخصية بفاعلية إيحائية، فالشخصيات التراثية في توظيفها الشعري تعمل بوصفها شهود عيان، تتدعم بوساطتها أفكار الشاعر ورؤاه فتقدم معالجات للواقع بطرقية جديدة بالاعتماد على المعنى الذي تحتمله أبعاد النص، ثم ليعمل التأويل على بيان وظائفها وإشاراتها الدلالية، وبذلك يكون الشاعر قد شكل قاموسه الاستدعائي وعالمه الشعري متسما بدرجة عالية من الانفعال الذي يتماهى وراءه التناص، فيحاور عوالم التراث والتاريخ والواقع متمازجة مع رؤاه، وقد تجلى ذلك أيضا في قصيدة: (من تجليات الشابي الأخيرة):
هذا أبي ينيخ كلكل العقيق
في وضينه
ويوسم الألفة بالبهاء كنجمة تنشر اليقين من بلاغة
الخنساء
ويدفع السطوة باليدين والحجول
والغمامة
لكنني أعثر بالعلامة
تصيح يا شقي
(ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر)
فالقصيدة تمثل حوارا يتجاوز حدود الزمنية بمفارقات تصويرية، ولاسيما في عتبة العنوان التي تعرض فيه إلى توظيف مواقف البطولة عند (أبي القاسم الشابي) الذي وُسِم بالمناداة بالحرية والتغني بأمجاد العروبة، والشاعر يوظف المعاني الثائرة توظيفا إيحائيا، محملا إياها أبعاد الواقع ومشكلاته، متعاضدا مع شخصية (الخنساء البكاءة) التي عرفت بالوفاء لروابط الأخوة، حين ملأت الأجواء بصوت النحيب على (صخر) المتمثل هنا بصوت المعاناة والوجع الإنساني، ليغطي ألم الهزيمة والضعف فيعكس تمثلات الواقع، الذي يشهد بكاء الإنسان المعاصر بالعِداء، وتضييع المعاني السامية في تحمل شرف البطولة وبناء المجد.
كاتب عراقي


















