
في كتاب «من الأدب إلى العلم» للاهاي عبد الحسين: أغلاط البحث الاجتماعيّ وهفوات اللاتخصص النقديّ
2021-12-14
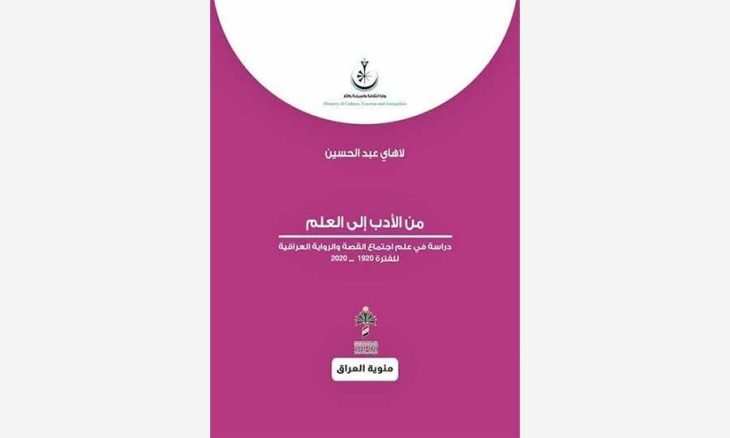
نادية هناوي
لا يسع أي باحث اجتماعي يشرع بنقد القصة والرواية ـ متبعا منهجاً اجتماعياً عاماً أو معتمداً على علم اجتماع الأدب ـ التملص من مراجعة التراكمات النقدية التي كتبت حول المنجز القصصي العراقي ولاسيما تراكمات النقد الواقعي والاجتماعي.
وكلما كان الباحث الاجتماعي على بينة من نظريات النقد والسرد ومناهجهما واصطلاحاتهما، كان أكثر تمكناً من التحليل بأدوات مناسبة وبنظر نقدي عميق. أما أن يكون الباحث محللاً اجتماعياً متخصصاً في التنظيم المجتمعي وذا روح إجرائية عمادها جمع الاستبيانات ووضع العينات وإحصاء معاملات التأثير، وفق معادلات وفرضيات مفروغ منها، فإن من العسير عليه الإيفاء بمتطلبات الإلمام بالمنجز السردي العراقي الذي مرَّت عليه مئة عام حافلة بالمحطات والمنعطفات والمسارات، كما يستحيل عليه أيضاً التحليل الفني وهو غير واقف على أرضية ما تراكم من نقد قصصي وروائي.
ونظرة سريعة على خريطة النقد الواقعي الاجتماعي لما أنجز من قصص وروايات عراقية ستكشف عن جملة مسائل لا تخفى على النقاد والباحثين المتخصصين، منها ما يتعلق بالبواكير التي كانت عسيرة بسبب التقاليد الاجتماعية والأدبية والتضييق السياسي، ومنها أن القصاصين وهم يمزجون الأدب بالسياسة، لم يكتبوا أدباً دعائياً، بل كانوا معبرين عن آمال الكادحين وتطلعاتهم، ومنها أن القصة العراقية ما اشتملت على أبعاد فنية إلا ارتباطاً بالحياة الاجتماعية العامة. وقد تماس النقد العراقي منذ بواكيره مع علم الاجتماع فأخذ عنه أساسات المنهج الاجتماعي ومنها مسألة تأثير المجتمع في الأدب، وأن الأديب ابن بيئته.. لكن هذا النقد تفاعل مع التغييرات التي طرأت مع مرحلتي البنيوية وما بعد البنيوية فظهر باحثون ونقاد عراقيون عنوا بتبني طروحات لوسيان غولدمان السوسيولوجية ثم توسع ميدان الدراسة السوسيولوجية في بلدنا وسائر البلدان العربية مع ما أنجز من رسائل وأطاريح جامعية، اعتمدت مفاهيم علم اجتماع الأدب ونظرياته، ولا يسعنا في هذا المقام تعدادها لكثرتها. ولا خلاف في أن عدم إدراك البون المعرفي بين منهج اجتماعي يتبنى التصور التقليدي للسوسيولوجيا، وعلم اجتماع أدبي يفنّد هذا التصور ولا يؤمن بوجود تأثير انعكاسي بين الأدب والمجتمع، يعني أن الباحث الاجتماعي لن يكون في منأى من الوقوع في أغلاط لن يكون له أن يقع فيها لو أنه تمكن من التخصصين النقد الأدبي وعلم الاجتماع الأدبي؛ وهو ما وقعت فيه المؤلفة لاهاي عبد الحسين في كتابها «من الأدب إلى العلم ..» الصادر عن دار الشؤون الثقافية العامة 2021 وتمثلت تلك الأغلاط في ما يأتي:
1 ـ العنونة بـ(علم اجتماع القصة والرواية العراقية) تؤكد اللادراية في أن التسمية المعتمدة والقارة علمياً هي (علم اجتماع الأدب) الذي تراه المؤلفة علماً جديداً، وتشكر من عرَّفها به وساعدها في (الدخول في هذا الفرع الجديد نسبياً في العالم، والجديد كلياً في العراق) وأنه (فرع مهني من فروع المعرفة الإنسانية.. من قبيل التفاوت الطبقي وقضايا المرأة ومشاكل الشباب ودور النظام السياسي الاستبدادي في التضييق على الحريات وممارسة القمع) ولأن المؤلفة اعتقدت أن (لا وجود لتعريف جامع شامل لما يعرف اليوم بعلم اجتماع الأدب) أعلنت بثقة عالية، أن كتابها يؤسس لهذا العلم ثم طالبت بـ(استحداث مادة علمية لعلم اجتماع الأدب بطريقة منظمة بدل الخوض فيه، دون تحضير كاف تمهيدا لإخضاع النتاج الثقافي في مجال القصة والرواية والشعر والفن للدراسة والتمحيص في مقبل الأيام).
وزاد الطين بلة تصورها أن علم اجتماع الأدب يدرس (قضايا ذات مضامين اجتماعية من قبيل العلاقات بين الاأشخاص والحب والزواج والسياسة والجريمة..). فعندها لا فارق بين النقد بمنهجية اجتماعية ذات منظور مرجعي ووثائقي خالص، والدراسة الاجتماعية، وفق علم اجتماع الأدب الذي ردم الهوة في فهم علاقة الذات بالموضوع والوعي بالعالم، بل هي لا تعرف عديد الدراسات العراقية في الأقل التي انجزت في هذا المضمار.
2 ـ منهجية الكتاب هي الأخرى كشفت عن خلط كبير بين التصور التقليدي الذي تمثله المنهجية الاجتماعية، والتصور البنيوي المحايث للاجتماعية الذي يمثله علم اجتماع الأدب. ويتضح هذا الخلط منذ المقدمة (تنطلق هذه الدراسة من فكرة أن الكاتب والروائي في النهاية ابن بيئته الاجتماعية والثقافية، يتأثر سلبا أو إيجابا بهما، ما يجعل من العمل الجاد الذي ينجزه مصدرا مهما وشهادة تتأهل (كذا) للاحترام بقدر تعلق الأمر بالمزاج الاجتماعي، والأجواء العامة للمجتمع وليس بالضرورة الجوانب العلمية والتوثيقية المؤكدة فيه). وإذا انتقلنا من المقدمة إلى متن الكتاب فسنجده فقيراً في توظيف مصطلحات اجتماعية معينة أو تطبيق مفاهيم علمية بعينها على القصة أو الرواية. وكل الذي فعلته المؤلفة هو رصد المضامين والثيمات، وفي حدود النظرة التقليدية لعلم الاجتماع والمتمثلة في التأثير والانعكاس حسب.
3 ـ استعراضية الإطار النظري، مهدت المؤلفة لمتن الكتاب بمقتطفات مقتضبة وعائمة لبعض علماء الاجتماع العام، وليس علم اجتماع الأدب باستثناء لوكاش، الذي لم تعد إلى مؤلفاته، وإنما نقلت ما قاله أوبراين كينيث عنه ومن ذلك ما سماه (الواقعية الادبية) دون إحالة على كتب لوكاش وهي مترجمة في أكثرها. وكان حرياً بها أن تشير إلى أهم مرجعيات علم اجتماع الأدب التي أسس قواعدها لوسيان غولدمان، ومن بعده بيار ماشيري وبيير زيما وغيرهما، لا أن تجمع فرويد بعلي الوردي، وتقع في مغالطات نسبة علم اجتماع الأدب لماكس فيبر وكارل مانهايم وايميل دوركهايم، وإسقاطات وضع كارل ماركس في مقدمة المؤسسين لعلم اجتماع الأدب مع أنها نفسها تعترف (بأنه لم يتناول الأدب القصصي والروائي على وجه التعيين) وبلا إحالات على كتبهم، الأمر الذي جعل هذه العروض المقتضبة مفككة ومرتبكة واستعراضية بالعموم.
4 ـ المفارقة العلمية التي كشف عنها متن الكتاب بالمساحة الزمنية المفروشة على مدى (مئة عام) وبالمادة التطبيقية المحدودة بـ(سبعة روائيين) ما يجعل قول المؤلفة عن كتابها إنه (مشروع استقصائي لأفكار ومقاييس ومشاعر مبدعين حملوا العراق في ثنايا تفكيرهم، حتى عندما طردوا من جنته مجبرين لا مختارين) قولا مبالغاً فيه وغير مقبول.
عموما نقول إن الشطب على أكثر من خمسة وتسعين في المئة من نسبة المنجز السردي في العراق، لم يكن له من مبرر سوى المداراة على اللادراية بخريطة هذا السرد أصلاً.
ولا نجد هذه المفارقة غريبة؛ أولا أن لا معايير فيها بررت المؤلفة اختيارها السباعي هذا، وثانيا الخلط في فهم فكرة التمثلات الجمعية التي يدعو إليها علم اجتماع المعرفة الذي هو فرع آخر غير علم اجتماع الأدب (هذا ما حدث مع كل الروائيين المدروسين هنا، عاش محمود أحمد السيد مراحل من حياته القصيرة خارج العراق، وكذلك فعل غائب طعمة فرمان وفؤاد التكرلي وإنعام كجه جي وفلاح رحيم وجاسم المطير، لعل عبد الحق فاضل الروائي العراقي الوحيد الذي لم يغادر العراق إلا بصفة دبلوماسي لفترات قصيرة أبقته عمليا على صلة مباشرة بالمجتمع) وثالثا ما ذكرته عن هؤلاء السبعة وأنهم (لم يتوسموا منصبا حكوميا أو سياسيا متقدما خلال سني حياتهم المهنية، ما وفر لهم فرصة التحرر النسبي من الولاءات التي ينطوي عليها المنصب والوظيفة) وكأن الكتّاب العراقيين وعلى مدى مئة عام، وفي ما عدا هؤلاء السبعة، كانوا أصحاب ولاءات ومناصب، ولم يكن بينهم من غيّبته السجون واضطهدته السياسة ومن طحنته الفاقة أو من كلفته مواقفه المبدئية حياته، ولا وجود لمن ضيعته المنافي، أو ألهبت معايشته الواقع العراقي مخيلته مع أنه لم يغادر مدينته قط.
عموما نقول إن الشطب على أكثر من خمسة وتسعين في المئة من نسبة المنجز السردي في العراق، لم يكن له من مبرر سوى المداراة على اللادراية بخريطة هذا السرد أصلاً، والدليل قول المؤلفة: (بعد تجميع أعمال الكتاب والروائيين السبعة، ممن شملتهم الدراسة الحالية ظهر الكثير من المشتركات، لقد ساهم كل كاتب وروائي بتطوير وجهة نظره في المجتمع العراقي، دون أن يكون هناك دليل على أنهم فعلوا ذلك بصورة منظمة أو مقصودة.. إنهم تصرفوا بمثل ما تصرف الروائيون في كل مكان في العالم.. لم يكتب أي منهم بطلب من مؤسسة عمل اشتغلوا فيها.. وهذا ما يجعل من هذه الروايات شهادة صادقة). فهل يبحث الأديب عن عمل وهو يكتب رواياته؟ أم أنه يعبر من خلالها عن هموم مجتمعه وقضاياه؟ ثم ما علاقة الوظيفة الشخصية بالإبداع الروائي، لكي تستثني عبد الحق فاضل الذي تراه (عمل دبلوماسيا بيد أنه نجح في المحافظة على مسافة من الوظيفة)؟
5 ـ ابتهاج المؤلفة بفكرة أن يكون كتابها موسوعة مع أنه (غفل) أمر المنجز النقدي، ولاسيما النقد الاجتماعي الذي تراكم عبر قرن كامل حول القصة والرواية و(غيّب) أيضا الجزء الأعظم من المنجز السردي، لاسيما تلك النتاجات المهمة التي تركت بصمات في مسيرة السرد العراقي. والمحصلة هي أن الكتاب يضع أمام القارئ صورة غير دقيقة، ولا أريد أن أقول مشوهة، للسرد العراقي وتاريخه الحافل بالإنجازات.
وإذا قيل إن الكتاب بصفحاته الخمسمئة يدلل على جهد موسوعي، فنرد بالقول إن منضدي الكتاب تقصدوا جعله كبيراً كي يبدو ملائماً للوضع تحت يافطة (مئوية العراق) من خلال:
أولا /تقليص عدد سطور كل صفحة. ثانيا/ المسافات المتروكة بين سطر وآخر. ثانيا/ مساحة البياض الجانبية والفوقية والتحتية في كل صفحة. ثالثا/ المساحة التي خصصت للهامش والتي شغلت أكثر من ربعي المسافة السفلية للصفحة، علما أن أغلب إحالات الهوامش قصيرة تستعمل الصيغة (المصدر نفسه) وهي مغلوطة أكاديميا، كما أن المجموعات القصصية والروايات هي مراجع وليست مصادر.
6 ـ غياب المفاهيم الاجتماعية جنبا إلى جنب فقر العدة النقدية، والسبب عدم اكتراث المؤلفة بتوظيف مفاهيم السرد، حتى أنها وقعت في أخطاء دللت على عدم معرفتها بوجهة النظر والمخيلة السردية وجماليات الشكل ومغزى الوظيفة السردية، وغير ذلك، بينما انعدم التوظيف لمفاهيم علم اجتماع الأدب كرؤيا العالم والكلية والوعي القائم والممكن والزمرة الاجتماعية والمحايثة السوسيولوجية والبنية الدلالية وتماسك البنى اللغوية وغيرها. ولعل أهم دلائل هذا الغياب ما اشتمل عليه متن الكتاب من نثر إنشائي للقصص والروايات، وبانصراف كبير نحو رصد مضامين كل قصة ورواية على حدة، وحسب ورودها في أعمال كل روائي دون أدنى رجوع لأي كتاب في النقد القصصي والروائي. وعادة ما تأتي النثريات الإنشائية في شكل قطعة تلخيصية، أو قطعتين تحتلان وسط كل صفحة تعلوها عنوانات، لا تمييز فيها بين عناوين الأعمال المقروءة وعناوين المضامين التي تستلها المؤلفة. ومن أمثلة ذلك (هياكل الجهل/ نزاهة النظام التعليمي/ جهالة الجمهور/ المتعجرفة/ المتمدينون/ الحب الخالص/ مواجهة العلم بالعلم: إرث الأمة/ الغرب المتعصب) و(هياكل الجهل) عنوان قصة لمحمود أحمد السيد والباقي مضامين.. وعلى هذه الشاكلة يستمر الحال مع سائر القصص وإلى آخر الكتاب.
7 ـ البحث عن المضامين، هو الذي خيّب أفق توقع القارئ المتطلع إلى تلمس ما في السرد العراقي من جماليات أسلوبية فضاع دور علم اجتماع الأدب في هذا التلمس، كما أن تلخيص الروايات أضاع جمالياتها وذهب بجهود كتّابها وفوّت على قرائها فرصة الاستمتاع بما في كل قصة من مفارقات فنية تقصَّد الساردون وضعها فيها. ولو اكتفت المؤلفة بتثبيت القصص كما دونها كتّابها، لاسيما في طبعاتها الأولى لكان في ذلك خير للقراء كثير. أما ذكرها سيرة الأديب قبل قصصه فبرهان آخر على عدم التفريق بين تقليدية النظرة الاجتماعية، وعلم اجتماع الأدب الذي لا يريد مساءلة الأديب ولا تهمه سيرته، بل المهم مساءلة سرده، كما أن موضوع هذا العلم هو التحليل المحايث للسرد أي الإبانة عن شبكة الدلالات الباطنية التي يتوفر عليها السرد القصصي والروائي، مع بيان علاقة الكون السردي بالعالم الواقعي، وأنهما مستقلان عن الكاتب وسيرته الشخصية ومعنيان بالحضور الكامن للصيرورة المتمثلة بسلوك كل شخصية سردية ووجودها التاريخي.
حددت المؤلفة العمر الإبداعي لكل اسم روائي مدروس بمدة زمنية، وكان حريا بها أن تفصل في أسباب هذا الحصر الزمني، هل جاء بناء على ضوابط نقدية او اجتماعية؟ أم هي التجربة الشخصية والسردية معا؟ أم هي طبيعة المجتمع وتحولاته؟
8 ـ الهفوات البحثية، التي حصلت بسبب اللاأدرية بالمنجز السردي وغياب الرؤية النقدية ببعديها النظري والتطبيقي؛ ومن تلك الهفوات:
ـ التغافل عما كتبه مؤرخو الأدب ونقاده من الذين كانوا سبّاقين في دراسة القصة والرواية، مثل باسم عبد الحميد حمودي وعبد الإله أحمد وعمر الطالب وشجاع العاني مؤلف كتاب (البناء الفني في الرواية العربية في العراق) وهو مرجع أكاديمي مهم، لا يمكن لأي باحث التغافل عنه، كونه درس الرواية العراقية منذ بداياتها حتى عام 1980. وقد أدى هذا التغافل إلى فهم خاطئ للأعمال الروائية والقصصية، فرواية مثل «النخلة والجيران» رأتها المؤلفة حظيت بالاهتمام، وتجد في هذا الاهتمام كثيراً عليها (أن ما قيل فيها قد يكون أضفى عليها ما ليس فيها). أما بالنسبة إليها فإنها (تسجيل انتقائي ارتبط بإحساس وخيال الكاتب لمرحلة محددة لعلها أربعينيات القرن الماضي في بغداد، بل هي أربعينيات القرن الماضي فعلا). ولن نرد على هذا القول، لكننا نقول إن إهمال المؤلفة المتراكم النقدي الذي كتب حول رواية (النخلة والجيران) أضاع عليها فرصة معرفة السبب الذي بوأ هذه الرواية موقعها الحقيقي في خريطة المئة عام من السرد.
ـ اعتبار إنعام كجه جي هي (السيدة الوحيدة) التي (رواياتها المتقنة لغويا وقواعديا .. تعقبت حال المجتمع العراقي في مشاهد ولمسات عبر قرن كامل من الزمان) فتجاهلت لطفية الدليمي وعالية ممدوح وسميرة المانع ومن الروائيين الذين كتبوا رواياتهم خارج العراق برهان الخطيب وفاضل العزاوي، أو من جيل لاحق كنجم والي ومحسن الرملي وعبد الله صخي وغيرهم.
ـ اهمال المؤلفة الواضح لجماليات القصة القصيرة وعناصر الشكل الروائي وعلاقته ببنية الوسط الاجتماعي، فضلا عن قصور فهمها للوظيفة السردية ولماهية الجنس الروائي الذي رأته (أقرب إلى تسجيل تجارب اجتماعية شخصية ومعارف ومشاعر مروا بها أو خبروها تفاوتت، من حيث العمق والتحليل العمودي) ولم تدر أن الرواية بنظر مؤسسي علم اجتماع الأدب مثل لوكاش ولوسيان غولدمان هي (بحث عن قيم أصيلة في عالم منحط)
ـ لا أهمية نقدية لديها في التمييز بين جنسي القصة القصيرة والرواية ومن ثم هما برأيها جنس واحد، يرادف أحدهما الاخر.
ـ حددت المؤلفة العمر الإبداعي لكل اسم روائي مدروس بمدة زمنية، وكان حريا بها أن تفصل في أسباب هذا الحصر الزمني، هل جاء بناء على ضوابط نقدية او اجتماعية؟ أم هي التجربة الشخصية والسردية معا؟ أم هي طبيعة المجتمع وتحولاته؟ ولان علم اجتماع الأدب عندها هو نفسه علم الاجتماع العام، غاب عنها هذا الفارق الكبير بين قبول اعتبار الإبداع القصصي والروائي انعكاسا لوعي جماعي، وبين رفض هذا الاعتبار الذي يقول به منظرو علم اجتماع الادب، مؤكدين أن الحياة الاجتماعية تعبر عن نفسها من خلال حلقة الوعي الجماعي.
ـ ارتباك تنظيم الكتاب، أولا في المقدمة التي تداخلت معها عناوين جانبية وخلا فهرس المحتويات من ذكرها. وفي الخاتمة التي جاءت مقتضبة جداً وفيها أكدت المؤلفة أن الأسماء السبعة التي درستها تدخل في الواقعية الأدبية وتنسبها للوكاش مستندة إلى الباحث الغربي، الذي نقلت عنه ولم تتأكد هل قال لوكاش ذلك فعلا؟ وأين؟ ومن بعد ذلك تذكر سمات منجز كل قاص وروائي بسطر ونصف السطر فقط بهذه الشاكلة ( سعى عبد الحق… وقدم غائب… اتبع فؤاد….وتضع انعام….وجاء فلاح….) وتركت جاسم المطير.
والغريب أنها مع كل هذا الاقتضاب حاولت استدراك ما فاتها لكن بعد فوات الأوان وبسطر يتيم فيه قررت أن هؤلاء الروائيين السبعة عملوا (وفق فكرة بورديو.. في مفهوم الهابيتوز) وهي محاولة غير موفقة في المداراة على ما في الكتاب من هفوات ذكرنا بعضها وكثير منها لا يسعنا عرضه هنا.
وقد نعتذر للمؤلفة أنها كانت على عجالة من أمرها، لاسيما في الفصلين الأخيرين.. لكننا لن نعتذر للمؤسسة التي كلَّفتها فوق طاقتها وحددت لها سقفاً زمنياً لا يتناسب مع ما للمنجز القصصي والروائي العراقي من خزين أصيل وكبير لم تكن هذه المؤسسة على بينة منه وربما لم تتخيله أصلاً.
كاتبة وأكاديمية من العراق


















