
الشاعر الحداثي والواقع المأزوم في تجربة الجزائري عياش يحياوي
2021-12-14
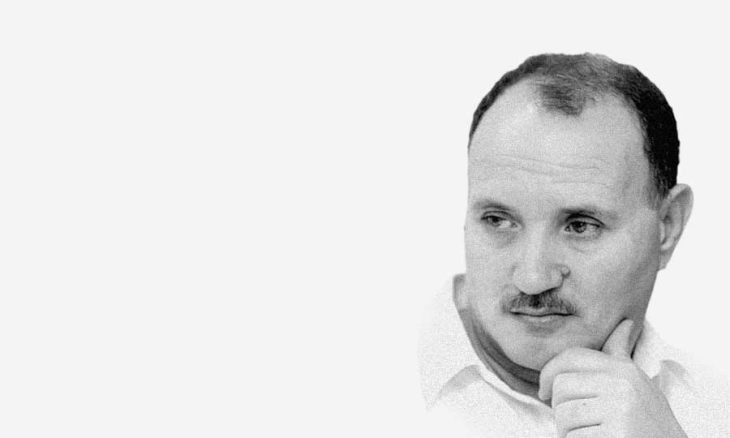
مصطفى عطية جمعة
تشكل تجربة الشاعر الجزائري عياش يحياوي (1957-2020) نموذجا لجيل الحداثة الشعرية العربية في الجزائر؛ وعندما نقرأها نكتشف كثيرا من الخطوط الممتدة بين شعرية الحداثة في مشرق العالم العربي ومغربه، ونعرف أن شعراء الحداثة شكلوا جيلا فيه الكثير من أوجه التلاقي، مع احتفاظ كل شاعر بخصوصية تجربته الشعرية.
فالسؤال المحوري الذي ينطلق منه يحياوي في ديوانه «ما يراه القلب» هو: لماذا يموت الشاعر والوطني المخلص، بينما يحيا الفاسدون الذين سرقوا أحلام الناس ورغباتهم، وكذلك مستقبل من هم في البيوت؟ إنه سؤال جمع الحاضر والمستقبل، فالحاضر يموت فيه المخلصون، والمستقبل المتمثل في حياة الأسر في البيوت، التي تعد أطفال المستقبل، وتحلم بغد أكثر جمالا.
من يتبنى بلادا وينقذ سنبلة الروح
من غرفة النوم هذا المساء
ألا هل لأطيار أحلامنا من سماء؟
هل رأى النسر في ما رأى جبلا
أتسلقه لتراني بلادي
هنا، تعود الذات الشاعرة إلى النداء العام، وهي تتأمل أحوال بلادها، وما سادها من تداعيات وتراجعات، وينظر إلى وطنه كيتيم ضائع، يبحث عمن يتبناه، كي ينقذ روحه من الفناء. إنه يرى بلاده متخبطة في مسيرتها. وتتطور نظرته فيتعجب أن يجدها بلا سماء، أي هي أرض لا تغطيها سماء، فيتساءل (ألا هل لأطيار أحلامنا من سماء؟) ليرسم لوحة سيريالية، أن تكون هناك بلاد لا سماء لها، فلا تجد الطيور فيها براحا لتطير فيه، وتتسع اللوحة أكثر، مع سؤال الشاعر المركب: (هل رأى النسر في ما رأى جبلا) فكأنه يسائل النسر عن جبل عال، ولا نعرف مغزى السؤال إلا لنكتشف أن ذات الشاعر باحثة عن مكان عال، تتسلقه، لتصرخ في بلادها، وفي أهلها، أن يسمعوا صوتا لها، فلديها ما ستبوح به. وما هذا إلا مزيد من اغتراب الذات، التي ترى البلاد بلا سماء، والأرض بلا جبال، والطيور عاجزة عن الطيران، فالبلاد طاردة لأبنائها، وطيورها، وحتى نسورها، لأن سماءها منعدمة الوجود.
فالملمح الأساسي في التجربة هو اغتراب الذات الشاعرة، وشعورها بدناءتها في هذا العالم، وأنها لا قيمة لها، فلا بديل لها إلا الصراخ، حيث يرسم الشاعر مشهدا سرديا طريفا في قصيدة «الشرفات» مكوّنا دراما لطيفة، شاركت فيها الديوك والأشجار والشواطئ:
سأستأجر الشرفات
وأملأها بالديوكِ
تصيح معي
إلى أن يجفَّ دمي
أصيح إلى شجر في المدينة يعرفني
وأتاجر بالنصر والأمنيات الصغيرة
أجعل من خنجري معبدا للرقاب
وأفتح روحي على شاطئ ليس مني
إلى أن يغيب الذي أشتهيه
وأبكي إلى أن أزغرد بالحشرجات
وأفنى، وروحي معلقة فوق خيط رفيع
بباب المدينة
إذا أردنا تفكيك السردية الشعرية السابقة، وأعدنا روايتها نثرا، فإن الذات الشاعرة عزمت على الجهر بمكنون صدرها، وما تختزنه من آلام، فأعلنت عزمها على استئجار عدة شرفات، وستحشد فيها ديوكا، لتصيح معها، وتظل تصيح، حتى يجف الدم من الجسد، وساعتها ستلجأ الذات الشاعرة إلى شجر المدينة، تشتكي له، له يتجاوب معها في غرضها من الصياح، الذي سيكون إعلانا عن المتاجرة بانتصار زائف، وأمنيات صغيرة، وتظل الذات راكضة في الشوارع، حتى تصل إلى الشواطئ، ويكون حالها ما بين بكاء متصل، يتحول إلى زغرودة متحشرجة، حتى تفنى الذات، وتصبح روحها جسدا، معلقا مشنوقا فوق خيوط على باب المدينة.
إنها أزمة ضياع الذات الشاعرة في وطن يتخبط، وواقع يتألم، عندما تعجز عن إيجاد مناصرين لها، فتلجأ إلى الديوك والأشجار، وتلوذ بالشواطئ والطرقات، بضاعتها الكلمات، التي تصبح شبيهة بالخنجر، ومن ثم تصبح معبدا للرقاب، وفي النهاية تتدلى ميتة على باب المدينة، يراها الناس جميعا، وقد لا يحفلون بها.
يتأسس الفضاء الذهني هنا على أحادية الذات في مواجهة العالم، وعلى تشيؤ الذات، لتصبح محاورة للديوك والأشجار والشواطئ، وعلى الجانب الآخر، يتأنسن الأحياء والجمادات، وتشارك الذات في صياحها. الذات الشاعرة الحداثية ذات مكبوتة وبديلها الصراخ سواء بالكلمات أو بأصوات الديوك، وتستجير بالكائنات حولها، لأنها فاقدة التواصل مع بني الإنسان، إنها ذات تعبر عن مآلات الإنسان العربي. وهو ما يفسر اللغة والبنية التي تُكتبُ بها قصائد الحداثة؛ وكأنها تخط شعورها وإحباطها على الورق شعرا، بل إنها تستجير بالورق لتكتشف مأساتها.
وسندرك أن تعامل يحياوي مع اللغة، لم يكن مجرد وصف لحالته النفسية، وإنما تعامل معها وفق المنطق الحداثي، الذي يجعل اللغة معبرة عن الوجود، وهو ما يشير إليه عز الدين إسماعيل بقوله: «لم يعد الشاعر المعاصر يحس بالكلمة على أنها مجرد لفظ صوتي؛ له دلالة ومعنى، وإنما صارت الكلمات تجسيدا حيا للوجود، ومن ثم اتحدت اللغة والوجود في منظور الشاعر، أو صار هذا الاتحاد بينهما ضرورة لا بديل لها، وقد نتج عن هذا الموقف – الإحساس بضرورة الاتحاد بين اللغة والوجود- أن تميزت لغة الشعر المعاصر في مجمله، كما تميزت لغة كل شاعر على حدة». وكي نفهم كيفية الاتحاد بين اللغة والوجود، نعود إلى فلسفة الحداثة ذاتها، وكيف أنها سعت إلى الارتقاء فوق التفاصيل الصغيرة، ونثيرات الحياة اليومية، دون أن تهملها، فنظرت إلى الوجود كله، وتعاملت مع أزمة الإنسان الحديث، وواقع حياته في وطنه، ومآلات الأحداث، خاصة في عالمنا العربي، عندما أفاق الشعراء بعد سنوات النضال والتحرير ضد الاستعمار، على واقع بائس اجتاح أوطانهم، وهو ما اتضح في تجربة يحياوي، وكيف أنه قرأ الواقع، وتأمله من علياء، واكتشف كم البؤس المعيش، وانعكس على مفرداته، التي شعّر فيها جزئيات الواقع: الديوك، الشواطئ، المدينة، حنجرته، باب المدينة، إلخ، وقدّم مشهدا سرديا شديد السخرية، واللامعقولية، والعبثية، والإدانة، بلغة إذا نظرنا إليها بصورة مجملة سنكتشف لوحة سيريالية في ملامحها، وحركية في تفاصيلها، وهو ما يؤكده عز الدين إسماعيل عن لغة الحداثة بأنها: تتولد نتيجة للحفر، والتنقيب في سراديب الواقع، إنها لغة تتجاوز قشرة الوجود إلى أعماقه، وليست الكائنات والظواهر الكونية في منظور الشاعر إلا الحروف التي ينسج منها الوجودُ الكلي لغتَه..
ومن شدة اغتراب الذات، يضمحل جسدها، وتصبح أقرب إلى الشفافية، يقول في قصيدة بعنوان «الصعلوك»:
ليس لي إلا هواء الرئتين
والطريق الطالع الجافي
وأظفار اليدين
وحذاء لم يطأ غير دمي
والجسد المأزوم بين وردتين
عنوان القصيدة مفتاحها، فـ»الصعلوك» يعيدنا إلى الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، الذين تمردوا على قبائلهم، وعاشوا بعيدا عنها، مفضلين حريتهم الشخصية على تبعية قبلية عمياء، وخضوع كلي لسلطان القبيلة وشيخها ومنطق أعرافها. فالصعلوك كلفظة تحمل دلالتين: دلالة لغوية تتصل بالفقر والحرمان من أسباب الحياة. ودلالة اجتماعية تتصل بالوضع الاجتماعي للفرد في مجتمعه، وبالأسلوب الذي يسلكه في الحياة لتغيير هذا الوضع. وقد استند يحياوي إلى هذا الإرث الدلالي من الشعراء الصعاليك في الجاهلية، ويضيف عليه، فالشاعر الحداثي متمرد بطبعه، وقد أبان هنا عن تمرده، معتزا بفرديته، قانعا بأقل القليل، ألا وهو امتلاء رئتيه بالهواء النقي، والعيش على حافة الحياة، غير عابئ بحرمان، ويكرر مفردة الحذاء، التي تحيلنا إلى عنوان الديوان ثانية، لكن الحذاء هنا مقتصر على دمه.
كاتب مصري


















