
سؤال الهوية والبنية السردية في « أتربة على أشجار الصبار»
2021-11-19
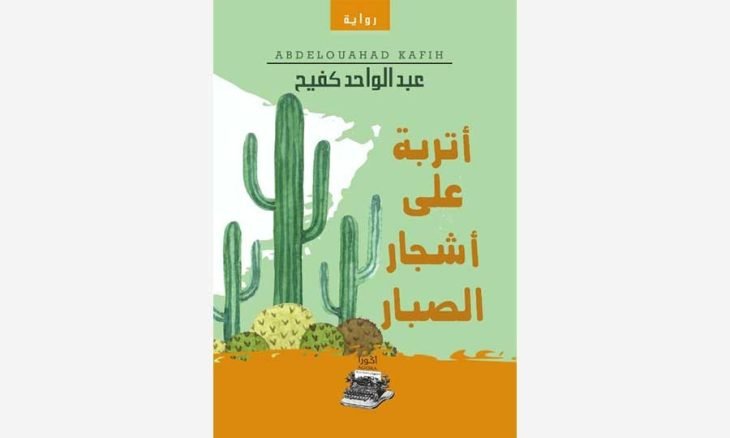
عبد الغني فوزي
يبني العمل الروائي عوالمه المحكية بين الواقع ـ بما فيه المرجع ـ والمتخيل. وبالتالي ، لا بد من متن أو مداخل تصاغ ، ضمن حكاية لها رأس تطل منه أو رؤوس. لهذا، لا بد من تلك الخلفية الثرة، بالنسبة للكاتب، لصياغة عوالمه، وفق ضوابط أو جماليات، تتعدد بتعدد التجارب و الرؤى.
فبقدر ما نقرأ نصوصا سردية؛ تنطرح أمامنا طرق وأنفاس سرد. وفي ذلك يختلف الكتاب ـ على سرادهم ـ في كيفية صياغة المتن وفي الإبداع والعمق . ذلك، أني أظن أن خلف كل رواية قلق منثور. خطرتني هذه الفكرة المركبة؛ وأنا أتداول تصفحا الرواية المعنونة بـ»أتربة على أشجار الصبار» للروائي عبد الواحد كفيح، الصادرة مؤخرا عن دار أكورا في طنجة المغربية.
رواية تتشكل من أنفاس روائية، ترصد مسارات أسر صغيرة بين البادية والمدينة؛ في تتبع كثيف للتفاصيل واليومي، الذي يدخل في باب الساقط والمنسي من التاريخ. ولكنه يشتغل على مساحة أوسع في المخيال والوعي الجمعيين. من هنا تنطرح عدة وشائج بين الرواية واليومي المتبدل، بين الرواية والتاريخ ، بينها والذاكرة …فكان العنوان مركبا، ومصاغا وفق هذه الرواية . كأن الأمر يتعلق بصياغة ذات خلفية ثقافية وأنثروبولوجية، تشخص الانغراس طينا في وجود شائك. نتساءل في هذا الرصد عن تجلياته، وعن الآليات المعتمدة في الصوغ السردي.
المتن السردي
تسوق كل رواية أحداثا متقطعة (مختارة وتم التفكير فيها)، عبر مسارات حكاية ما، تتخلق بين الواقع ـ بما فيه المرجع ـ والمتخيل. وعليه فالرواية قيد الدرس تصور سردا الحياة بين القرية والمدينة، تركيزا على نمط العيش في قرية مقذوفة لقدرها. في تبئير لمفاصل هذه القرية من فقيه (غريب) الذي حطه السيل واستولى على البلدة وعبادها؛ نظرا للفهم السطحي وغير العقلاني للعامة. والغريب، أنه اغتنى؛ وتطور ذلك إلى سلب الأموال وكل ما يريده، بواسطة توظيف الدين من أجل مصلحة ذاتية. ورد في رواية «أتربة على أشجار الصبار»: «اعتاد الفقيه الزعيم على عقد اجتماعاته في زاويته، فيأتيه العديد من الشيوخ العلماء والفقهاء الوجهاء للمسامرة والذكر والمديح . كلما مثلوا بين يديه اضطربوا في حضرته وهم يتحدثون له راكعين. كما يليق بجوقة من الكومبارس يؤدون أدوارهم بإتقان في مسرحية سمجة انطلت مشاهدتها على ضعاف القوم، الذين تقبلوا قدرهم ذاك بسهولة ووداعة، معتقدين اعتقادا حازما أنه فعلا يستحق الركوع وحتى السجود». وامتدت تلك السطوة إلى سلب أسرة أرضها. فاختارت هذه الأخيرة الهجرة إلى المدينة. هجرة متدحرجة عبر طريق طويلة وشاقة. لينتهي الأمر بهذه الأسرة إلى هامش المدينة. فتنوعت المعاناة من سكن وفقر… وغير خاف، أن أفراد هذه الأسرة حملوا إرث القرية هناك وظل ساريا في أجسامهم، ما أدى إلى تصادم القيم، لكن شخصية محمد ساعدت أسرتها على البقاء، من خلال تأقلمه مع حياة المدينة وهوامشها. فاختار مواجهة العنف بالعنف. وفي المقابل، وبشكل متواز، كانت الرواية تناظر بين حياة القرية والمدينة، من خلال نموذجين، بلدة مريم وما يجاورها، ومدينة غول كما تسميها الرواية. ففي البادية سعى الحكي إلى بناء استراتيجية تمثلت في تقديم صورة عن نمط عيش القرية، حيث حضور شخوص على قدر كبير من الفعالية والتأثير: يتعلق الأمر بالفقيه وسيطرته الشاملة، والعطار ودوره في الترابط وتبادل الأخبار، فضلا عن الشيخ والمقدم… وفي المقابل، يتابع السارد الإحاطة بتفاصيل حياة الأسرة المهاجرة التي قررت العودة مرة أخرى لمنبتها القروي والانتقام من الفقيه، باعتباره سببا حقيقيا في اقتلاعها.
والغريب مرة أخرى، أن تجد الفقيه فارق الحياة، فتنوعت التأويلات في سياق علاقته بالقائد، عن سبب وفاته . فمثلما كانت بداية الفقيه في القدوم غريبة ، كانت كذلك في رحيله الغامض والمحير. إنه متن متشابك الأحداث، غاص في المواقف، من خلال اختلاف مواقع الشخوص ضمن أمكنة مؤطرة وطابعة للأحداث، ما أدى إلى حضور ثنائيات عدة منها : الواقع والمتخيل.. ما هي حدود كل واحد منهما؟ الواقع والغرابة، البادية والمدينة، التقليد ـ الحداثة، العقل ـ اللاعقل…
رواية تتشكل من أنفاس روائية، ترصد مسارات أسر صغيرة بين البادية والمدينة؛ في تتبع كثيف للتفاصيل واليومي، الذي يدخل في باب الساقط والمنسي من التاريخ.
جماليات الحكي
غير خاف، أن الرواية ـ قيد الدرس ـ تسعى إلى تقديم ذاك التعدد عبر حلة سردية تقدم وتؤخر، تحذف وتضيف… استنادا هنا إلى معالم تتمثل في القرية، المدينة كمؤطرين كبيرين للأحداث. ومن جهة ثانية، تنسيب الأحداث المتدفقة بين ماض وحاضر، في اعتماد على الذاكرة كرافد للحكي؛ وفي الآن نفسه مبرزة لعلاقة الشخوص بالتحولات، ما أدى إلى الاستغراق في ثيمة الحنين والانكسار. في هذا السياق، فالرواية اهتمت أكثر بالحياة النفسية والاجتماعية للشخوص. فضلا عن العقليات والأفكار. الشيء الذي أفضى إلى ترصد سكنات وحركات الشخوص. كأن السارد يحرس أنفاسها. فتحولت مسارات الحكاية إلى مشاهد ساخنة، يمكن الحديث هنا عن مشهد الفقيه، مشهد الأسرة المهاجرة، مشهد العطار، مشهد المقدم. نقرأ من الرواية: «رأت الميلودية أن المقدم في قريتها له من السلطة أكثر بكثير مما لدى مقدم الحومة في المدينة. فهناك في البلدة يكفي أن يذكر اسم المقدم والشيخ حتى يهرول الدم في العروق والأوردة، فالمقدم هو الآمر الناهي، القابع على الدوام على صهوة بغلته المسرجة، مرتديا الجلباب والسلهام كالعريس، له عز ومهابة وسطوة وجاه». مشاهد قد تقدم نفسها كحكايات صغرى، ضمن حكاية أم تتمثل في نمط عيش أهل البادية، بين القرية والمدينة. وفي المضمار نفسه، فالرواية هذه، اعتنت بامتدادات الشخوص التي تقيم في اللغة أحيانا، أو قل اللغة المتربة، أي أنها تطل من استعمالها على العالم من زاوية ما، على حس مكاني وزماني بالمرحلة. فالفقيه شاهد على مرحلة ولو من خلال لغته، والعطار ودوره، والميلودية وقصفها للعالم باللغة الساخرة.. فحضرت الدارجة من خلال حوارات وزوايا نظر. لكننا، نرى الرواية تنظف هذه الدارجة أو تقوم بتليينها، من خلال الاستعمال الفصيح. إنها تعددية وحوارية لغوية تدل أيضا على خصوصيات وكينونات. فكان النص الروائي سجلا لغويا غاصا بالخطابات والطرق الجدالية والحجاجية، من تعليق ونقد ونقائض.. في هذا الدرج، لا بد من استحضار السخرية السارية بين التلافيف، السخرية المتأتية من غرابة بعض الأحداث، ومن التخفي في ممارسة الأفعال. هذا فضلا عن سارد يسعى إلى حياد معلن، لأنه يرمي إلى تقديم الأحداث والمواقف، في اتجاه توجيه وتثبيت رسائل عديدة حول المكان والزمان، حول التاريخ والمهمش، حول الأحداث وترتيبها. لهذا نرى السارد، يطرح سلاحه خلفا أحيانا، مستفزا القارئ، من حين لآخر، مخيرا إياه بين اختيارين، وإلا قد تنقلب الحكاية على صاحبها.
على سبيل الختام
تعزز الحقل الروائي والعربي بهذه الرواية «أتربة على أشجار الصبار»، الغنية دلاليا وجماليا. ولم يأت ذلك من فراغ أو خبط ، بل نرى الكاتب عبد الواحد كفيح ساعيا إلى مراكمة فعل سردي، سواء قصصيا أو روائيا، له خصوصية في الرفد و البناء، عمادها الانفتاح على الهامش واستحضار الساقط والمنسي، وفق مشهدية سردية. وبقدر ما تتوالى إصداراته السردية، تتوالى إبحاراته في المعنى والحلة. في هذا السياق، فلي اليقين أنه على وعي دقيق بالطرائق التي ما فتئ يطورها، من خلال مستويات لغوية تسعى إلى توفير إقامة مرتعشة للشخوص أو الهويات المنسية والمقصية. وها هي عناوينه الكبرى تبدو موجهة وعميقة، باعتبارها ذات خلفية أنثروبولوجية وثقافية، فـ»أتربة على أشجار الصبار» ذات حضور دقيق في الرواية، ظهر ذلك، في سياق رحلة تلك الأسرة إلى المدينة، أتربة قليلة على صلة قوية بوجود شائك «أشجار الصبار»، بما فيه وجود الرواية .
شاعر وناقد مغربي


















