
«القلعة البيضاء» رواية التركي أورهان باموك: التماهي الغامض في الشخصيات
2021-04-11
 هاشم شفيق
هاشم شفيق
يغوص الروائي التركي أورهان باموك، الحائز على جائزة نوبل، في عوالم غرائبية وهو يتناول موضوعة الشرق والغرب، من خلال حكاية تشبه السحر والأساطير، وهي منتوج المُتخيَّل البارع والخيال الغازي لمطارح الرؤى، والأمكنة المفعمة بالحكايات والتواريخ، والإمثولات النادرة.
أورهان باموك الذي درس العمارة والصحافة، تجلت مآثره في الرواية، وارتقت به إلى مصاف الكتاب الكبار، حيث بات مقروءاً في أكثر من مئة دولة، وترجمتْ أعماله وهي قليلة قياساً بالآخرين، إلى ثلاث وثلاثين لغة أجنبية، وأصبح في تركيا، بلده، أيقونة كتابية لا يستطيع حتى النظام البوليسي أن يرفع صوته أمامه، ولقد صرّح باموك عن ذلك لمجلة سويسرية حين قال إن «مليون أرمني قد قتلوا على هذه الأرض، وثلاثين ألف كردي، لكن لا أحد غيري يجرؤ على قول ذلك».
تطرح رواية أورهان باموك «القلعة البيضاء» حكاية تبدو للوهلة الأولى بسيطة وأنت تبدأ في قراءتها، ولكنها بالتدريج تأخذ بالتصاعد الرؤيوي، والتمادي في تأكيد عمل المخيلة، وترك الموحيات والاستيحاءات تجلب الأفكار والحكايا، والتداعيات الباطنية في رسم التوليفة الخيالية، ومن ثم إبحارها في عوالم غريبة، ولكنها أليفة بحكم جمالها التعبيري، والخيال المجنّح والعابر للأفكار والنمطيات، والرؤى المطروقة والمتداولة.
تبدأ الحكاية بهذه العبارة «وجدت هذا المخطوط في عام 1982 في قعر صندوق مليء بقرارات وسندات تمليك وسجلات محاكم ودفاتر رسمية، بنى الغبار عليها طبقة في أرشيف قائمقامية غبزة، حيث اعتدنا على قضاء أسبوع من كل صيف فيها، لفت نظري فوراً لأنه مجلد بجلد أزرق يذكرنا بالأحلام، ويتلامع وسط وثائق الدولة، ومكتوب بخط مقروء، كأن يداً غريبة كتبت على الصفحة الأولى، من أجل إثارة فضولي بشكل أكثر، عنوان « ابن المنجد بالتبني» ليس ثمة عنوان آخر، وبيد طفلية رُسم على هوامش الكتاب وأجزاء صفحاته الفارغة أناس ذوو ألبسة كثيرة الأزرار، ورؤوس صغيرة، وقد قرأته بمتعة كبيرة، ولأنني أحببته كثيراً، ولم أجد في نفسي اندفاعاً لنسخه على دفتر، ولأن القائمقام الشاب نفسه لا يستطيع تسمية تلك الزبالة أرشيفاً، لذلك لن يحبسني إذا أسأت استخدام خدمتي، فسرقته ودسسته في حقيبتي بلمح البصر».
المخطوط يتحدث عن إبحار سفينة إيطالية من نابولي إلى البندقية حين هوجمت من قبل سفن تركية فيها اتراك ومغاربة، أسروا تلك السفينة وحولوها إلى الأراضي التركية، ليخضع كل من فيها لأوامر باعتناق الإسلام، أو القتل في حال لم يُسْلم من كان عليها، أو يلاقي السجن والإهمال وربما التعذيب، وهكذا كان حال بطل الرواية الذي وقع في هذا المصير الشائك والمربك، والذي سوف يغير كل حياته، وهو يعيش بين الباشا والسلطان وحاشيته من العلماء والأطباء والفلكيين، وحتى الشعراء من الأتراك.
هكذا سيعيش المختطف، وهو من أبناء فلورنسا، بعد أن دخلوا أسطنبول وفق مراسم مبهرجة، وفي احتفال عام سيستعرضهم السلطان الصبي، ويتفرّج عليهم في حفل فيه مفرقعات واحتفالات بالنصر، سيعيش كعالم وطبيب وفلكي، وهو ليس طبيباً بل قارئ ملم ببعض المعلومات عن التشريح والحالات الأخرى التي تطرأ على الكائن البشري، كالحمى وارتفاع ضغط الدم وسرعة النبض، وغيرها من العوارض الصحية التي يتعرض لها الإنسان خلال سِنِي حياته، وبهذا سينجو من سجن صادق باشا، في منطقة غلاطة، ليكون مدار حسد من المسيحيين الآخرين الذين رفضوا تغيير ديانتهم، فأرسلوا إلى التجديف في العنابر، وهو أيضاً وضع في العنبر، ولكنه نجا بطريقة ما، نتيجة ذكائه وفطنته، والحظ الذي قد يحالف أحدهم أحياناً، بعد أن ذاق الويلات في السجن، وربطه بالسلاسل كالعبيد، وعمله في الحجارة تحت ضرب السياط، وحين عُرف في السجن بأنه يعالج المرضى، راح المرضى يعرضون عليه القروح والأدواء، حتى وصل خبره إلى السلطان الذي أرسل في طلبه، ومن هنا ستتغير حياته بالكامل، حين يمثل بين يد السلطان المريض بضيق التنفس والسعال، في الحال يحضّر الطبيب الدواء من خلطة عشبية عبر مطبخ السلطان، وبعد أيام من تناوله سيصح السلطان ويشفى، ويزداد الطلب عليه «كانوا يطلبونني في الليل إلى بعض المنازل، أقدم العلاج للقراصنة المسنين المصابين بالروماتيزم وللجنود المصابين بحرقة في المعدة، وكنت أسحب دماً من المصابين بالحكة والمصفّرين والمصابين بالصداع، وفي إحدى المرات عندما شفي ابن أحد الخدم الذي كان مصاباً بالتأتأة بعد أسبوع من تناوله الشراب الذي حضرته له، وبدأ يتكلم أسمعني شعراً» .
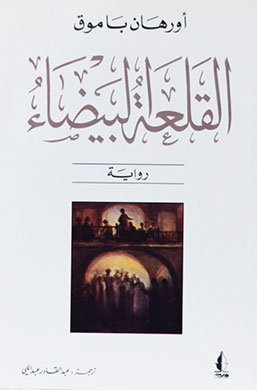
في يوم ما، عاد السلطان وأرسل في طلبه، فجاء من يأخذه إليه، في الطريق كان يفكر بأن المرض ربما قد عاوده مرة أخرى، وحين مثَل بين يديه، وجد هناك رجلاً يشبهه، فخاف، كأنه هو، كان السلطان يعرف أنه يفهم بالفلك والهندسة والعلم، فقال له وهو شاخص في حضرته: هل تفهم بالمفرقعات المقذوفة في الهواء، فأجبته فوراً بأنني أفهم، فقدمني إلى الشخص الآخر الذي يشبهني، ولقّبه بالأستاذ وطلب مني مساعدته في العمل، وقال: أننا سيكمل واحدنا الآخر وعلينا أن نقدم عرضاً شيّقاً له من خلال حفل المفرقعات هذا .لكن الذي أثار هواجسي وأقلقني هو «عدم انتباهه للشبه الذي بيننا، حين كنت أشعر أنه ينظر إليّ، مرة أو اثنتين، شعرت أنه يدرك تشابهنا ويتصرّف متجاهلاً هذا الأمر، كأنه يلعب لعبة أو يجربني أو يحصل على معلومات لا أستطيع فهمها، لأنه في الأيام الأولى كان ينظر إليّ دائماً بتلك الطريقة، يتعلم أمراً ما، وعندما يتعلمه يزداد فضوله، ويبدو أنه متردد في خطو خطوة جديدة من أجل ترسيخ تلك المعلومة».
من هنا بات المتشابهان يعملان في البيت الذي يسكنان فيه، مرات يخرج الطبيب ليتجول حول المكان ومن ثم يعود، والأستاذ كان يذهب إلى الحانة ليشرب ويخالط السكارى، ويتعلم ويسمع الأخبار من هذا وذاك، ويشتري الكتب، تلك التي تعلّم وتطرح أفكاراً حول الكوزموغرافيا لفهم قواعد الفلك والرياضيات والفيزياء، وكان الأستاذ دائم الاضطهاد لشبيهه، أو تلميذه، لكن شبيهه كان أذكى منه، وأدرى بأسرار العلم، فبينما كان الأستاذ يتظاهر بالعلم، ويتشاوف على تلميذه الورع، والذكي، والفطن للأمور وللعوامل والمجريات المحيطة به، كان الأخير يتعلم التركية، من دون اتقان كامل، كونه وافداً جديداً للبلد، وكونه إيطالياً أولاً ونصرانياً ثانياً، مما كان يدفع الأستاذ للتساؤل عن تأخره في اعتناق الإسلام حتى الآن، بالرغم من تقدمه في اللغة التركية، ومعرفة كل ما يحيط باسطنبول من أسرار ومفاهيم، وطرز معمارية وجمالية في هذه البلدة الساحرة التي أدهشته بفتنتها، بالرغم من حنينه لبلاده، والشوق الحارق للأهل والخطيبة هناك.
كان الأستاذ وتلميذه يقضيان اليوم بالعمل والمطالعة، والمساءلة والاستزادة بالعلم، والنهل منه على مدار الساعة، بحيث يجلس الاثنان كل يوم حول منضدة واحدة يتذاكران ويكتبان. كان ما يكتبه الأستاذ لا يروق للتلميذ، ويعدّ كتابته عادية ومفككة، وغير سليمة، من ناحية الأداء والأفكار والأسلوب الذي يكتب به الأستاذ مادته الأدبية والعلمية، حول الكواكب والنجوم، وعلم الفلك وعلوم الجغرافيا، فكان التلميذ يصحح له عمله، وأحياناً كان يري عمل تلميذه للسلطان الذي كان يعرف بدوره أنه لتلميذه، وليس له البتة.
كان السلطان يريد تزويج الطبيب التلميذ من فتاة جميلة لكي يُسلم، ولكن التلميذ الطبيب لا يريد الزواج، ولا يود من خلال ذلك تغيير دينه، وهذا ما أغضب السلطان، قبل أن يُحرّر من قبل الأستاذ حين مرّ في الغابة السلطانية ولاحظ الطبيب بين أيدي جلاديه، لقطع عنقه، فكفله الأستاذ وجلبه إلى بيته، بحجة الإفادة من علمه، مما سيُقنع السلطان فيما بعد بذلك.
لذا سيعيش الطبيب أو التلميذ مع الأستاذ في بيته، يتعلمان ويدرسان ويقترحان المشاريع للسلطان، حتى اقتطع لهما السلطان لجهدهما المبذول اقطاعية فيها حديقة، وكانت حلم الأستاذ بغية تأسيس مجمع علمي، سيُعرف بالرصد خانة، لرصد الكواكب والنجوم، وحركة الفلك والتنبؤ بالجو، وما سيحصل للمناخ من تحوّلات عبر دورات الفصول، فالأستاذ هنا سيضطهد تلميذه الألمعي، سيسرق أفكاره ورؤاه، ويحاول جبره على كتابة يوميات حياته، وذكرياته الماضية، لكي يتسنى له فيما بعد أن يسرق حياته، في محاولة منه لدفن ماضي التلميذ والسفر إلى فلورنسا، حيث أهل التلميذ وخطيبته وأصدقاؤه هناك، وصولاً إلى حتلال مكانه، بالإستيلاء على الخطيبة بواسطة الشبه الذي بينهما، وتعلم الإيطالية من خلاله، أي التلميذ ومن ثم محو كل ماضيه وحاضره.
تنبئ رواية «القلعة البيضاء» باتساع رقعة مفهومها الدلالي وواقعها السحري، وتماهي شخصياتها، والتداخل فيما بين الأستاذ والتلميذ. لقد عملا معاً لمدة خمسة وعشرين عاماً، وهما بين الكتب القديمة، حتى توصلا إلى ابتكار سلاح للسلطان يحارب به قوم «اللّيه» أي البولون في حملته التاريخية عليهم، وحين دنت ساعة الحرب وبدأت، خسر السلطان الحرب، بعد أن ساعدت المجر والنمسا «الليه» ولكن المفاجأة ستكون بدخول الكاتب الذي سيكتب سيرة الاثنين، وهو إيطالي، وسيكون بمثابة الشخص الثالث، والمؤلف للكتاب الشائق هذا.
أورهان باموك: «القلعة البيضاء»
ترجمة: عبد القادر عبد اللي
دار المدى، بغداد 2019
152 صفحة.


















