
بين الفلسفة والأدب علاقة ملتبسة دامت قرونا طويلة
2020-09-16

أبو بكر العيادي*
رغم التقارب الملحوظ بين الفلسفة والأدب منذ نهاية القرن الثامن عشر، لا تزال الفلسفة في عمومها منفصلة عن الأدب، تستفيد منه في بلورة مفاهيمها وإيضاح مصطلحاتها لتقريبها من الفهم، ولكنها تنكر عليه أن ينافسها في توليد أفكار فلسفية، رغم أن بعض الفلاسفة، مثل سارتر وكامو، اقتحموا مجال الخلق الأدبي لجعل فلسفتهم نابضة بالحياة، مستوحاة من الواقع المعيش.
من النادر أن نجد مؤلفات الأدباء جنب كتب الفلاسفة، فالفلسفة شيء، والأدب شيء آخر، ما يوحي بأننا أمام مجالين مختلفين، وهي فكرة رائجة في أذهان الناس، ولاسيما المشتغلين بالفلسفة، بادية للعيان في رفوف المكتبات التجارية والعامة وحتى المدرسية، حيث لكل مادة جناح خاص بها، فلا يمكن أن نعثر على كتب الفلسفة جنب القصص والروايات والدواوين الشعرية، وكأن الأدب في واد والفلسفة في واد آخر.
مثل هذا التصنيف يعكس الفكرة الراسخة منذ القدم بأن الفلسفة تنطق بالحقيقة، في حين أن الأدب جُعل للمتعة والتسلية من خلال خطاب غايته تحقيق جمالية فنية، اعتمادا على الصور الاستعارية والمجاز والبلاغة، رغم أن ديدرو مثلا كتب يقول في “محادثات حول الابن الطبيعي” إن “الحكيم كان في ما مضى فيلسوفا وشاعرا وموسيقيّا.. تلك المواهب انحرفت عند انفصالها عن بعضها بعضا؛ ضاقت دائرة الفلسفة، وافتقر الشعر إلى الأفكار.. فلم تعد الحكمة بعد فقدانها لتلك الأعضاء قادرة أن تبلغ سماع الشعوب بنفس الفتنة”.
ولعله يقصد المرحلة السابقة لسقراط، حيث كان التواصل قائما مع هيراقليدس وبرمينيديس وأمبادوقليس وأناكسيماندروس وسواهم ممن حاولوا اكتشاف مبدأ كل شيء في العالم، وما وراءه.
علاقة تناقض

العلاقة “المتوترة” بين الفلسفة والأدب ضاربة بجذورها في غياهب العصور، فقد صوّر أفلاطون الشاعرَ كوجهٍ مغاير للفيلسوف، يتمثل العواطف والمشاعر لا العقل، والإلهام لا المعرفة، حيث يقول “الشاعر شيء خفيف، شيء مجنَّح، شيء مقدّس، لم يتوصّل بعدُ إلى الخَلق حتى يصبح الإنسانَ الذي يسكنه إله، ويفقد رأسه، فلا يعود ذهنه ملكا له”. فالشاعر في تصور أفلاطون هو ذلك الكائن المسكون، الهاذي، المأخوذ بنشوة باخوسية، لا عبقرية له إلا إذا نطق إلهٌ في فمه، ولا جدارة لديه إلا بما يأتيه من إشراق خارجي. والفرق بين الفيلسوف وجهده في عقلنة الظواهر واضح جليّ في نظره، لأن العمل الفلسفي يضع في مقابل الإلهام والمشاعر الفكرَ الجدلي، الخالص والمطلق، بوصفه ملكة أسمى لا ترتهن لتملُّك عرَضيّ.
هذا الموقف الأفلاطوني المناهض للأدب الشعري، الذي يغلظ حينا ويلين حينا آخر بحسب الحوارات، يبلغ ذروته في “الجمهورية”، كنظام سياسي لا مجال فيه للشعراء، ولا سبيل للخرافات، لكي لا يتعلم الأطفال سوى السرديات التي لا تسيء إلى الحقيقة.
يقول أفلاطون “هل ندَع بمنتهى السهولة الأطفال يستمعون إلى أدنى حكايات يقعون عليها، حاكها أول قادم، فيستقبلون في أرواحهم آراء تخالف في معظمها ما ينبغي أن يحوزوه عند النُّضُوج؟ لن نسمح بذلك بأي وجه من الوجوه. ينبغي علينا إذن أن نبدأ بالتحكم في صنّاع الحكاية”.
ولئن كان أفلاطون يدين الشعر، لاسيما شعر المحاكاة، بِاسم الحقيقة، فما يسرده الشعر في نظره لا ينمّ عنها، لأن إنتاج الشعراء لا ينقل إلا المظاهر، ويظل بعيدا كل البعد عن المعرفة الجوهرية. ثم إن الشعر لا يقلّد الفضائل التي ينبغي أن ينشأ عليها المواطنون الصالحون، بل إنه يقلد في الغالب المشاعر الأكثر دونية في المعيش اليومي.
ومن ثَمّ اعتبر أفلاطون أن كل ممارسي الشعر، بدءا بهوميروس، إنّما يقلّدون مظاهر متصنّعة من الفضيلة، ولا يبلغون الحقيقة. “فخبير الشعر، يزين بكلمات وجملٍ كلَّ فن بالألوان التي تناسبه دون أن يتقن شيئا آخر غير فنّ التقليد”. أي أن الشعر في رأي أفلاطون لا يفرز سوى صورة بعيدة كل البعد عن الواقع، وأن ذلك راجع لا محالة إلى طبعٍ ما قبل عقلاني متأصل، وراجعٌ أيضا إلى هدف يخصّها ألا وهو الجمال وليس الحقيقة؛ ثم زاد عليه أرسطو بأن جعل القول الشعري أدنى مرتبة من القول البرهاني الفلسفي.
المنعرج الفكري
ظلت نظرة الفلسفة إلى الأدب على ذلك النحو حتى القرن الثامن عشر، فإيمانويل كانْت مثلا يلاحظ إلى أي حدّ يحيد بنا الخطاب المبنيّ على الجمالية عن التركيز على الأفكار، بل يعترف صراحة بأن قراءة روسو تكلّفه جهدا مضاعفا: “ينبغي أن أقرأ وأعيد روسو إلى أن يكفّ جمال التعبير عن إرباكي، عندها فقط أستطيع أن أفهمه كما ينبغي”. ورغم أن فلاسفة تلك الحقبة لم ينكروا على الأدب بحثه عن الحقيقة، واعترفوا بقدرة السرد على تفسير العالم وتأويله، فإن ما قاله كانْت عن قراءاته المتعددة لفهم روسو يقيم الدليل مرة أخرى على التنافر القائم بين الحكم الذّوقيّ والفهم العقلاني.
في تلك اللحظة من نهاية القرن الثامن عشر وقع الفصل الرسمي بين الأدب والفلسفة، وكان كانْت من أشهر من كرّسها حين وضع سدّا منيعا بين الحقيقي والجميل، مؤكدا على أن إخضاع الخطاب التأمّليّ لحكم ذوقي معياريّ يُضعِف محمول العقلاني، إذ جاء في “نقد ملَكة الحكم” قوله: “الفن يتوقف في مكان ما، ما دام ثمة حدٌّ فُرض عليه، ولا يمكن أن يذهب أبعد منه”. وهكذا أُدرج الأدب ضمن الفنون، واعتُبر خطابا تغلب عليه المشاعر والانفعالات، ويطغى فيه الشكل على المضمون، بينما عُدّ الفكر الفلسفي تمثّلا للموضوعية والكونيّة. ما يعني أن الأدب يعرَّف أول ما يعرَّف بهيمنة الخيال والخلق الحدسي البديهي، لا هدف من ورائه سوى إثارة الإعجاب والمتعة، وأن ثمة من يفكّر في مقابل من يُسلّي.
|
لئن تطوّرت العلاقة بين الأدب والفلسفة في الاتجاهين، فإننا، نحن العرب، مازلنا نصرّ على الفصل بينهما |
ولكن الفلسفة الحديثة ما لبثت أن تجاوزت تقسيم العمل هذا، إذ غالبا ما صارت تهتم بالأدب، وتستقي منه أمثلة لإيضاح مفاهيمها، ما يدلّ على أن الرواية أو المسرحية أو القصيدة يمكن أن تكون حمّالة لفكر فلسفي، رغم قلة اهتمامِ تلك الأجناس بالموضوعية والكونية اهتمامَ الفلسفةِ بهما، مثل مسرحية “أنتيغونا” لسوفوكليس حول معنى القانون الشرعيّ، أو رواية “الجريمة والعقاب” لدستويفسكي عن قضية الوعي الأخلاقي، أو قصائد غوته في “الرّب والرّوح والعالم” عن التناهي.
صار ينظر إلى الأدب على أنه يحوي أيضا دروسًا فلسفية يمكن أن يستفيد منها رجال الفكر، وهذا ما أقرّ به فيلسوف متأخر هو موريس ميرلو بونتي، حين أكّد بأن الأدب والفلسفة لا يمكن أن يتواصل فصلهما عن بعضهما بعضا، لأن “التعبير الفلسفي يتحمّل نفس ما يتحمّله التعبير الأدبي، إذا كان العالم قد جُعل على نحو لا يمكن التعبير عنه إلا داخل ‘حكايات’، ومشارًا إليه بالإصبع”.
بيد أنّ هذا الكلام لا يتبعه في الواقع فعل، فلئن صار الفلاسفة مقتنعين بثراء النصوص الأدبية، لا يتوانون عن الاستئناس بها والاستلهام منها فإن الأدب بقي في نظرهم إمّا محصورا في دوره الترفيهي، أو وسيلة إيضاح للفكر التأملي تتيح فهمًا أسهل لما تقوله الفلسفة بكيفية أدقّ وأعمق من خلال الترميز والمفاهيم. أي أن الفلسفة تستخدم الرواية مثلا لجعل التجريدي قابلا للإدراك، وهذا معناه أن الأدب لا يفكر بنفسه، ويحتاج دائما إلى الفلسفة للعثور على تأملات عميقة في طيّاته، وأنه يحتوي لا محالة على أفكار ولكنها تَرِد عن غير وعي، وكأن للكتّاب فلسفة تلقائية تأتي عفو الخاطر دون سابق تخطيط، ثم يأتي الفيلسوف ليستوحي من الطابع الخاص للحكاية رسالةً ذات أبعاد عقلانية وكونية.
انتصار الأدب
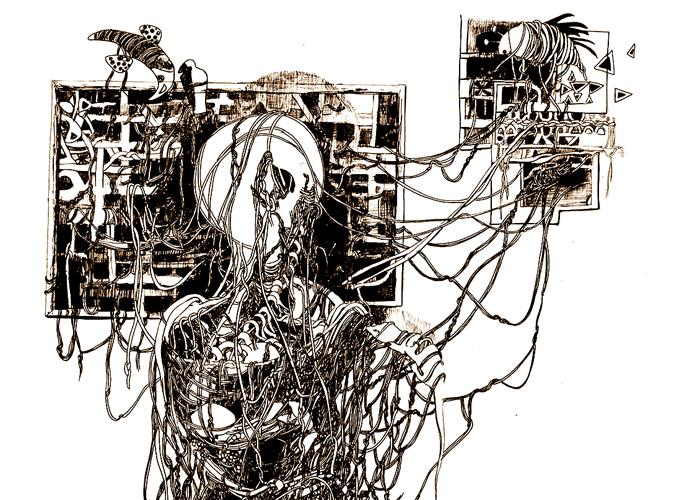
إن الأدب لا يمكن أن يظل مجرّد خزّان لأمثلة يستمدها الفلاسفة لتأكيد نظرياتهم، لأن الأدب يفكّر، حتى وإن لم يكن بطريقة استدلالية مبنية بإحكام، أو من خلال منظومة تأملية منهجية، فالكاتب يملك طريقة خاصة في إنتاج الفكر، تقوم على استعمال مخصوص للغة، وكتابة تحمل معنى، وينشرها في نص يتواشج فيه الشكل والمضمون، دون مفاهيم ولا مصطلحات.
الأدب نوع من الفكر الذي لا يحتاج إلى إضفاء شرعية عليه، يتبدى في فضاء تجري فيه أحداث منصهرة داخل نص يسرد حكاية، ويسرد في الآن نفسه فكره، بعيدا عن المفاهيم التي عادة ما تحمل اللغة إلى منتهى الإغراب والتعمية وتجعل النص غريبا عما هو حسيّ وإنساني. وهذا ما يميز الرواية مثلا عن الفكر التجريدي أو العلمي البرهاني، فهي تتمثل مشكلات الواقع وما وراءه في نسيج حكائي، تنزاح به من التجريد إلى التجسيد.
ولئن كانت الفلسفة تفخر بتمثل المعرفة والعقل، وبالملكات التي تسمو عن الإلهام والمشاعر، فإن هذا التفريع الثنائي من الصعب أن يبقى على حاله، خصوصا منذ نهاية القرن الثامن عشر، عندما دخلت العلاقة بين الفلسفة والأدب منعرجا جديدا، بظهور أشكال كتابة مستحدثة تتحدى الفلسفة التقليدية وتستولي على ثيمات كانت في ما مضى حكرا على الفلسفة.
من أشكال الكتابة المستحدثة مشروع فريدريخ شليغل عن الشعر المتعالي (وهو عند كانْت صفة للمعاني والمبادئ التي يعتبرها خاصة بالفكر وحده) وكان قد صاغه كنوع من الفلسفة الاستعارية، هدفه السمو بالفلسفة حتى تمضي إلى أبعد مما بلغته، ففي اعتقاده أن الشعر هو الذي ينجز مهمة فلسفة أحبطتها حدود اللغة.
|
اعتبر أفلاطون أن كل ممارسي الشعر، بدءا بهوميروس، إنّما يقلّدون مظاهر متصنّعة من الفضيلة، ولا يبلغون الحقيقة |
إن إعادة الاعتبار الإبستمولوجي للأدب، التي نشهدها منذ عصر الأنوار جاءت كنتيجة لأزمة الفلسفة العقلانية التي عقبت ذاتانية كانْت، ما فتح الباب أمام فكر فسلفي أدبي، تحوّل بالتباساته إلى مرآة ينعكس على صفحتها الشك الإبستمولوجي للحداثة، وبذلك وضعت هيمنة الفلسفة موضع شك، وتراجعت الحدود بين الفلسفة والأدب، وبرزت أسئلة جديدة: كيف ننظر إلى أدبية الفلسفة؟ كيف ننظر إلى المحتوى الفلسفي للأدب؟ وأيّهما أقدر على تناول القضايا المعرفية والجمالية والميتافيزيقية والأخلاقية، الفلسفة أم الأدب؟
هي أسئلة ما انفك يطرحها ضمنيّا أو بصريح العبارة عدد من الفلاسفة والكتّاب ومنظّري الأدب، ويبدو من خلالها أن الأدب يمنح التأمّل الفكري بوتقة تجارب فريدة، إذا صمدت أمام البعد الشمولي للمفهوم أو التصنيفات الشكلية للحكم الأخلاقي، يمكنها أن تساهم في بلورتها وحتى مراجعتها. والسبب أن الأدب يغتذي من تلك التجارب التي تشكل سردية حياتنا، ويضيف إليها وجهات نظر تأملية متنوعة، من المؤلف، وشخصياته، والسارد، وحتى القارئ.
لئن تطوّرت العلاقة في الاتجاهين بظهور فلاسفة جدد يحاولون الأخذ بأساليب الأدب، فضلا عن محموله الفكري، فإننا، نحن العرب، ما زلنا نصرّ على فصل الفلسفة عن الأدب، ونميز بين “صانع الحقيقة” أي الفيلسوف، و”صانع الأوهام” أي الكاتب المبدع، وندعو صراحة إلى “أن يلزم كل ذي صناعة صناعته” كما قال أحدهم، فمن الشائع أن يستلهم الكاتب أفكارا من الفلسفة ويستشهد بمقولاتها، ولكن من النادر أن تجد فيلسوفا عربيا يهتم بالرواية ويغترف منها مقارباته الفكرية.
- كاتب تونسي


















