
عدد الفلاسفة الكبار لا يتجاوز العشرين على مدار 2500 سنة
الفلسفة كحل وحيد للاستعصاء التاريخي
2020-09-07
 هاشم صالح
هاشم صالح
يجمع العارفون على أن الفيلسوف بالمعنى الحقيقي للكلمة هو ذلك الشخص الذي أحدث خرقا في تاريخ الفكر، أو ثغرة في جدار التاريخ المسدود. الفيلسوف هو ذلك العبقري الذي حل المشكلة الاستعصائية للعصر. كل شخص لا يفعل ذلك لا يمكن أن نعتبره فيلسوفا حقيقيا. من هنا ندرة الفلاسفة الكبار على مدار التاريخ. الفيلسوف بالمعنى الذي نقصده هو فلتة من فلتات الزمان. إنه ذلك الشخص الذي تشكل ولادته حدثا هائلا أو ظهورا ساطعا على صفحة التاريخ. لماذا نعظمه إلى مثل هذا الحد؟ لأنه حل للناس المشكلة التي تؤرقهم، لأنه فك الانسداد التاريخي.
ومعلوم أنه في كل مرحلة من مراحل التاريخ هناك مشكلة مستعصية أو انسداد فكري لا يستطيع فكه إلا الفيلسوف العظيم. بهذا المعنى فالفلاسفة الكبار هم ظهورات أو منارات إشعاعية أو انفراجات في قلب الانسدادات. ليس في كل يوم يظهر فيلسوف كبير! فمثلا عدد الفلاسفة الكبار لا يتجاوز العشرين على مدار 2500 سنة من تاريخ الفلسفة. وحتى هؤلاء يمكن اختصارهم إلى تسعة أو عشرة أسماء: أفلاطون، أرسطو، ديكارت، سبينوزا، جان جاك روسو، كانط، هيغل، ماركس، نيتشه، هيدغر. أعتذر عن هذا التعسف. فهناك آخرون لا يقلون عبقرية وأهمية.
وكل واحد من هؤلاء حل المشكلة المستعصية لعصره. كل واحد منهم اكتشف الحقيقة المخبوءة أو المطموسة في عصره. ولذلك نشعر بعد قراءتهم بأن الكون اتسع، والظلمات انقشعت، والكابوس زال.
فمثلا سبينوزا حل مشكلة الأصولية اليهودية - المسيحية. ومعلوم أنها كانت الاستعصاء التاريخي الأكبر في عصره. وكانت تقلق ذلك العصر وترعبه. لماذا؟ لأنها كانت تدخل الشعوب الأوروبية في حروب أهلية لا تبقي ولا تذر. وهي الحروب الطائفية التي جرت بين المذهبين الأساسيين: المذهب الكاثوليكي البابوي والمذهب البروتستانتي اللوثري. لقد حل سبينوزا المشكلة فلسفيا من خلال عقلنة الدين وتنظيفه من الشوائب والخرافات وحشو الحشو والترهات. وكلها أشياء متراكمة على مدار العصور وتهيمن على عقلية عامة الشعب.

كان الدين كله مختصرا لديه بعبارة واحدة: الإيمان بالله وحب العدل والإحسان والتضامن الفعلي مع الفقير والمسكين وابن السبيل. الدين هو المعاملة الحسنة والنزاهة والصدق ومكارم الأخلاق. هذا هو الدين في نظر سبينوزا، هذا هو جوهر الدين. كل ما عدا ذلك تفاصيل. أما الحقد على الآخر لأنه ليس من دينك أو مذهبك فهذا ليس من الدين في شيء وإنما مجرد تعصب أعمى. وهذا ما كان سائدا في عصر سبينوزا كما هو سائد عندنا حاليا. السائد كان هو المقولات الطائفية والفتاوى التكفيرية التي تملأ عقول عامة الشعب وتحشوها حشوا بأفكار التعصب وتحرض الناس على بعضهم البعض طائفيا ومذهبيا. هذا هو المفهوم السائد للدين في عصر سبينوزا. ولكن لحسن الحظ فإن أوروبا الحداثية المتنورة تخلصت منه حاليا وتجاوزته كليا بفضل سبينوزا ومن تلاه من كبار الفلاسفة الذين ثقفوا أوروبا وهذبوها وعلموها. ما الذي فعله سبينوزا بالضبط؟ هذا ما يجيب عليه فريدريك لونوار في كتابه «معجزة سبينوزا»، وغيره ممن كتبوا عن الفيلسوف.
لقد فكك سبينوزا العقائد الطائفية والفتاوى اللاهوتية التكفيرية للدين أو لرجال الدين. لقد قضى عليها قضاء مبرما من خلال كتابه العبقري: مقال في اللاهوت السياسي (المسيحي - اليهودي). وهو ما ندعوه حاليا عندنا بالإسلام السياسي. ولكن أين هو المثقف العربي الذي يتجرأ على ما فعله سبينوزا قبل 350 سنة بالضبط؟ سبينوزا لم يصفق لدعاة المسيحية السياسية أو المسيسة ولم ينبطح أمام الإخوان المسيحيين كما ينبطح بعض المثقفين العرب حاليا أمام الإخوان المسلمين. وإنما فكك مقولاتهم من جذورها تفكيكا وأسقط مشروعيتهم اللاهوتية أو الدينية وعراهم على حقيقتهم.

وكشف كيف أنهم يستغلون الدين بكل براعة مكيافيلية لغايات شخصية انتهازية لا تخفى على أحد. ولكنها تخفى على عامة الشعب البسيط المتدين أو ما ندعوه حاليا بالشارع العربي أو التركي فيتبعهم دون نقاش ويجعلهم يربحون الانتخابات بكل سهولة لأنه لا يمكن أن يكون ضد الدين. يا أخي هل أنت ضد الدين؟ أعوذ بالله، معاذ الله. إذن صوت لي! ولذلك يمنع المغرب استخدام الجوامع والمقدسات في الحملات الانتخابية المسيسة. لماذا؟ لأن من يستخدمها سوف يربح الانتخابات بشكل أتوماتيكي حتى دون انتخابات!
بنقده الراديكالي هذا لرجال الدين فتح سبينوزا المجال لتشكيل الدولة المدنية العلمانية الحديثة التي تعامل المواطنين كلهم على قدم المساواة بغض النظر عن أصولهم ومشاربهم. وهذا يعني أنه حل مشكلة العصر أو استعصاء العصر إذ أعطى الشعوب الأوروبية المتصارعة المفتاح الذهبي لتجاوز العقلية الطائفية والحروب المذهبية.
لقد تصدى للأصوليين على أرضيتهم الخاصة بالذات ودحرهم دحرا. إنه بطل الفكر مثل أستاذه ديكارت. لماذا نقول ذلك؟ لأنه حرر الروح من كوابيس اللاهوت الظلامي والتدين القاتل. هذا ما فعله سبينوزا. لهذا السبب نقول بأن ولادته كانت تشكل ظهورا أو حدثا خارقا في تاريخ الفلسفة. ورغم أنه لم يعش أكثر من 45 سنة إلا أنه استطاع أن يحدث خرقا في تاريخ الفكر البشري. هل هذا قليل؟ ولذلك ظل الأصوليون يلعنونه حتى الساعة. ولا تزال فتوى التكفير تلاحقه حتى اللحظة. ثم يقولون لك بعد كل ذلك: يا أخي ما فائدة الفلسفة؟ ما فائدة الثقافة والمثقفين؟ فائدتهم عظيمة والكلمة عندهم أقوى من الرصاصة! بشرط أن يكونوا عباقرة في حجم سبينوزا أو ديكارت أو كانط أو هيغل إلخ...
- تلامذة سبينوزا
ننتقل الآن إلى عصر التنوير، أي عصر فولتير وديدرو وجان وجاك روسو وكانط ومن تلاهم من فلاسفة الأنوار. وجميعهم من تلامذة سبينوزا بشكل أو بآخر وإن كانوا قد تجاوزوه وأضافوا إليه إضافات جديدة باهرة. فهؤلاء غيروا بشكل راديكالي منظورنا لفهم الحقيقة أو تصورها. لا ريب في أن سبينوزا سبقهم إلى ذلك ولكنه كان معزولا في عصره أي القرن السابع عشر أما هم فقد شكلوا تيارا طويلا عريضا في القرن الثامن عشر. فالحقيقة أصبحت نقدية وتحريرية في آن معا. بمعنى أنها لم تعد تصدق كل مقولات رجل الدين بشكل أتوماتيكي حتى ولو كان البابا شخصيا!
وإنما ينبغي تفحصها أولا ووضعها على محك العقل والتمحيص قبل قبولها أو رفضها. وبالتالي فهي نقدية بالدرجة الأولى تجاه خرافات الأصوليين التكفيريين وأحقادهم الطائفية والمذهبية التي يبثون سمومها في أوساط الشعب الطيب البسيط الجاهل بل والأمي في معظمه آنذاك. وتجرأ الفلاسفة على القول بأن العلة كائنة في الشعب ذاته! ولذلك ينبغي إخراجه من مستنقع التخلف والجهل والتبعية العمياء لرجال الدين.

بمعنى آخر لكي يحصل التغيير المنشود المنتظر ينبغي أن نبتدئ من نقطة البداية: أي تثقيف الشعب وتعليمه وتهذيبه وبالأخص تنويره. ولتحقيق ذلك خاض فلاسفة الأنوار معارك طاحنة مع رجال الدين المهيمنين على عقلية الشعب كما يهيمن شيوخ الفضائيات على الجمهور المسلم في وقتنا الراهن. وعندئذ ظهرت المؤلفات الكبرى كرسائل فلسفية، ورسالة في التسامح، والقاموس الفلسفي، لفولتير. ولا ننسى بالطبع كتابات جان جاك روسو التي فككت المفهوم الأصولي الطائفي القديم للدين المسيحي وقدمت عنه مفهوما عقلانيا وتحريريا رائعا.
وهذا ما ينقص العالم العربي حاليا بشكل موجع. هذا وقد نزل روسو إلى قلب المعمعة عندما تصدى لمطران باريس الذي كان قد هاجمه سابقا وكفره. ولذلك رد عليه روسو بكل جرأة وشجاعة بل وأفحمه في نص قوي خالد. ولا أعرف كيف تجرأ، وهو الأقلوي البروتستانتي، على تحدي أكبر شخصية كاثوليكية في فرنسا! هنا تكمن عظمة جان جاك روسو. لقد فجر النواة التراثية الصلبة للانغلاقات الدينية في قلبها أو منتصفها. وتدفقت عندئذ الشلالات والأضواء وانفك الانسداد التاريخي وتنفس الناس الصعداء. وعرف الناس عندئذ أنهم وصلوا إلى بر الأمان وأن الفكر المنور والمنتظر قد ظهر. (بين قوسين: وهذا ما شعر به الفرنسيون بعد ظهور ديكارت، والألمان بعد ظهور كانط أو هيغل. وحدهم العرب لا بواكي لهم...). وحرر روسو بذلك الطاقات المحبوسة أو المكبوتة للشعوب الأوروبية. بمعنى آخر فقد حررها من كابوس الظلامية الدينية التي كانت مهيمنة على أوروبا آنذاك وتكاد تخنقها خنقا وتشلها شللا بالصراعات الطائفية والحروب المذهبية. كان المفهوم الظلامي القديم للدين يشكل أكبر انسداد أو أكبر استعصاء تاريخي بالنسبة للأوروبيين كما هو عليه الحال عندنا حاليا. مسافة التفاوت التاريخي بيننا وبينهم من هذه الناحية تقدر بمائتي سنة أو حتى ثلاثمائة سنة.
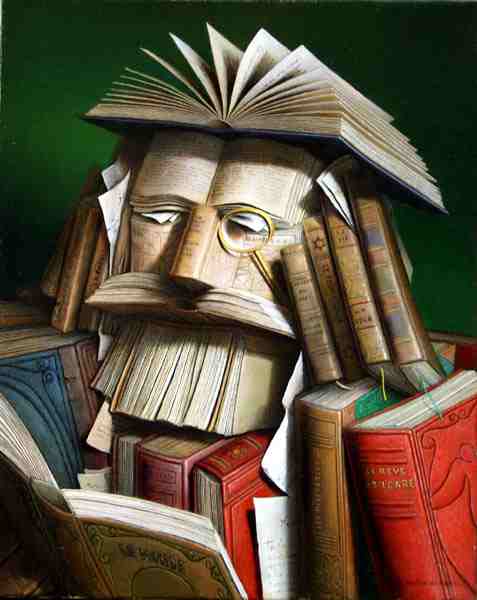
- داء الأصولية
المفهوم الأصولي التكفيري كان مهيمنا على العقلية الجماعية منذ مئات السنين وبالتالي فله مشروعية تاريخية. ورغم ذلك فقد استطاع الفلاسفة زعزعته أو زلزلته أو تفجيره من الداخل... كانت الطائفية تمثل آنذاك الداء العضال الذي ينخر في أحشاء أوروبا وتجعل الناس يكرهون بعضهم بعضا بل ويذبحون بعضهم بعضا على الهوية. لم يكن أي جار يطيق جاره إن لم يكن من طائفته أو مذهبه. ولذلك كانت أحياء الكاثوليكيين منفصلة كليا عن أحياء البروتستانتيين.
ثم ظهر روسو وقال هذه العبارة الأساسية: كل من يكفر الآخرين ينبغي طرده من الدولة والمجتمع. وكان يقصد بذلك حزب الإخوان المسيحيين البابويين الذين يشكلون الأغلبية العددية ويخيفون الآخرين بذلك. كانوا يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة الإلهية المطلقة أو المسيحية الحقة لمجرد أنهم أكثرية وأن الآخرين زنادقة وكفار ينبغي استئصالهم. وبالتالي فلاهوت التكفير أو فقه التكفير هو سبب دمار أوروبا سابقا والعالم العربي حاليا. والواقع أن الجماعات التكفيرية هي التي ينبغي استئصالها وليس العكس. لماذا؟ لأنها تشكل خطرا ماحقا على السلم الأهلي والوحدة الوطنية للبلاد. وأخيرا نقول بأن عظمة فلاسفة أوروبا تكمن في أنهم استطاعوا تفكيك المفهوم التكفيري الظلامي الراسخ في العقليات الجماعية رسوخ الجبال وإحلال المفهوم التنويري المتسامح محله. وهذا الشيء لم يحصل حتى الآن في العالم العربي بل إن الذي يحصل حاليا هو العكس تماما!


















