
ما بعد الكولونيالية وقضايا الهجنة والترجمة الثقافية
2020-06-06

إدريس الخضراوي*
قليلة هي الدراسات في السياق العربي التي استفادت في بناء أدواتها وافتراضاتها النقدية من دراسات ما بعد الكولونيالية، ذلك المشروع العلمي الذي يَسعُ مجاله مساحة جغرافية واسعة، كما يغطي حقبة زمنية طويلة ترتدّ إلى القرن الخامس عشر، من أجل قراءة التحولات في المجتمعات العربية على صعيد الأفكار والقيم وأنساق الحداثة، وذلك رغم الأهمية التي يكتسيها هذا المنظور النقدي الذي ظهر أول مرّة في الجامعات الأميركية، منذ سبعينيات القرن الماضي، وما أدّى إليه ذلك الظهور من فتح منافذ إلى مسارات جديدة في قراءة الزمانية ما بعد الكولونيالية، وهي الحقبة التي ما عَادَ معها في الإمكان قراءة التاريخ وتأويله على أساس الصورة العامة العالمية التي وضعها هيغل، بعد أن تفكّكت تلك الرؤية للتاريخ المدفوعة بفكرة التقدم، وأصاب التدهور المجتمعات الصناعية، واشتدت أزمة الحداثة، كما تعمق الانفصال بين الإنسان والكون، والكلمات والأشياء، والرغبة والتقنية، والفرد والمجتمع، وبات معروفًا أن الكثير من "كونية" أنماط التفكير الغربية هي تعبير عن الاستيلاء والهيمنة[1].
إذًا، باستثناء بعض الأعمال القليلة التي لعبت جهود إدوارد سعيد، ومجموعة من المثقفين العالميين، دورًا كبيرًا في تبلورها، فإن هذا التيار النقدي لا يَزالُ يَفتقرُ إلى الاعتراف الكامل، في وقت نُلاحظُ فيه أن ميدان ما بعد الكولونيالية يحظى ليس فحسب بالقيمة الرفيعة في الفضاء الأنغلو أميركي، وفي إسبانيا والبرازيل والهند وأفريقيا، حيث تتعدد النصوص التمهيدية والكتيبات الإرشادية، والمجلات المتخصصة، وحتى الموسوعات المنخرطة في جوانب مختلفة من المقاربات التي يتناولها هذا الحقل، وإنما أيضًا يَتزايدُ الاهتمام به من قبل الباحثين في مجالات النقد الأدبي والعلوم الاجتماعية.
وإذا كان اقتبال دراسات ما بعد الكولونيالية في فرنسا، وهي من بين الإمبراطوريات الاستعمارية سابقًا، لم يَخلُ من عوائق ومشاكل، إذ لم تظهر الكتابات الأولى في ميدان البحث إلا بَعدَ مرور أكثر من ربع قرن على ظهورها أول مرة في الولايات المتحدة الأميركية، كما تَعكسُ ذلك كتابات جان مارك مورا[2] ذات القيمة الكلاسيكية، فإن انتقالها إلى الحقل الثقافي العربي لم يكن هو الآخر في منأى عن تلك العوائق، إذ نلحظ غيابًا صارخًا للنصوص والأعمال الأساسية لأبرز منظريها، أمثال ستيوارت هول، بول غيلروي، غاياتاري سبيفاك، ديبيش شاكرابارتي، وغيرهم، إضافة لما يشبه الريبة، أو التوجس، من إدراجها ضمن المقرّرات الدراسية في الجامعات.
فأغلب الباحثين الذي يشتغلون بها ينتمون إلى مسالك الأدب الإنكليزي، والدراسات المقارنة. ونعتقد أن الوضع الذي يوجد فيه هذا المشروع، سواء في
"سبب العوائق أمام الدراسات ما بعد الكولونيالية، في فرنسا، أو في العالم العربي، لا يَرتدّ فقط إلى ما يوجّه لهذا التيار الفكري والنظري من انتقادات تُطاولُ منهجه، أي اعتماده المقاربة البينتخصصية، التي يصفها بعض مناهضيها بأنها غير علمية، وإنما يرتبط أيضًا بالأبعاد السياسية لهذا التيار الفكري"
فرنسا، أو في العالم العربي، لا يَرتدّ فقط إلى ما يوجّه لهذا التيار الفكري والنظري من انتقادات تُطاولُ منهجه، أي اعتماده المقاربة البينتخصصية، التي يصفها بعض مناهضيها بأنها غير علمية[3]، وإنما يرتبط أيضًا بالأبعاد السياسية لهذا التيار الفكري. بالنسبة إلى فرنسا، فإنّ دراسات ما بعد الكولونيالية تَطرحُ أسئلة قويّة مستفزّة حول الماضي الاستعماري لهذا البلد وعواقبه السلبية على المناطق التي كانت مستعمرة في السابق.
وإذ يجادل هذا التيار الفكري بأن العقل يعمل بتنوع في مختلف الثقافات، وأن التجربة التي يعيشها الإنسان في التاريخ تقدّم أوفى دليل على أن التابع قادر بمفرده على أن يكون صانعًا لمصيره، فإنه يعيد النظر في ما ترسّخه الإمبريالية على أنه "رسالة تمدّنية" نهضت بها أوروبا تجاه العالم غير الأوروبي، وهو ما يضفي المشروعية على مبادئها السياسية والثقافية، بافتراض وجود غاية هي تحرير البشر في أرجاء الأرض. وفي السياق نفسه توجّه ما بعد الكولونيالية نقدًا حادًا للحركة القومية والأنظمة الثورية التي تحملت مسؤولية قيادة العالم العربي بعد تصفية الاستعمار.
فمن منظور نقادها، فإن هذه النّخب السياسية فشلت ليس فقط في تحقيق الاستقلال في القرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي استمرار تبعيتها للإمبريالية الاقتصادية العالمية، مما حال دون التصفية الكاملة للاستعمار، وتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني، وإنما أخفقت أيضًا في تحقيق نهضة شعوبها. إن شدة هذا النقد المضاد تنعكس كذلك في الموقع الذي يحتله تقييم التجارب النضالية السّابقة ضدّ الاستعمار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وكذلك مفاهيم التحرر والأصالة والتوكيد الذاتي[4] في مرآة النقاشات ما بعد الكولونيالية في السّياق العربي.
لست هنا في وارد الحديث عن تلقي دراسات ما بعد الكولونيالية، بل إن ما أرومه هو إبراز الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع العلمي في العالم المعاصر، والإمكانيات التي يتيحها لفهم الظواهر المعقّدة التي يطرحها العيش في عالم معولم تخترقه ثقافات وأفكار وتوجّهات مختلفة.
ومن أجل ذلك، سأتوقف عند دراستين تشيع فيهما لغة النقد الثقافي ما بعد الكولونيالي، وبالتالي تنطويان على مجهود يَتّسمُ بالجدّية والقدرة على الاستفادة من هذا الحقل في الإضاءة على كثير من الظواهر التي تَعترضُ الثقافات في المرحلة الراهنة. أما الدراسة الأولى فهي بعنوان: الفرانكوفونية، ما بعد الكولونيالية والعولمة[5] للباحث الفرنسي إيف كلافارون، والثانية بعنوان: حداثات عربية من الحداثة إلى العولمة[6] للباحث المغربي خالد زكري. ما يَجمعُ بين هاتين الدراستين حديثتي الصدور (2018) ليس فقط كونهما تندرجان ضمن المشروع العلمي لما بعد الكولونيالية، وإنما أيضًا ذلك الضّرب من الاستثمار المتبصّر، والذّكي، لأدوات ومفاهيم النقد ما بعد الكولونيالي، لقراءة التجاذب بين الثقافة والقوة، والكشفِ عن الأهمية التي تكتسيها عمليات التهجين الثقافي في اجتراح "فضاء ثالث"؛ وهو مصطلح وضعه الناقد الهندي، هومي بابا، ليشير به إلى ما يَفرضهُ العيش في العالم ما بعد الكولونيالي المطبوع بالتوترات والصراعات من حاجات دائمة إلى الحوار والتفاوض والمقاومة وتخطي السرد الاختزالي للمركز والأطراف[7].
1- بعيدًا عن الفرانكفونية.. قريبًا من ما بعد الكولونيالية
من المناسب أن نُشيرَ بخصوص عمل إيف كلافارون: "الفرانكفونية، ما بعد الكولونيالية والعولمة" إلى المكانة العالية التي يَخصّ بها المؤلف هذه المفاهيم الثلاثة الأساسية التي يَتكونُ منها العنوان، أي الفرانكفونية، وما بعد الكولونيالية، والعولمة، والجهد الذي يبذله من أجل اختبار علاقاتها البينية انطلاقًا من متن أدبي واسع مكتوب باللغة الفرنسية.
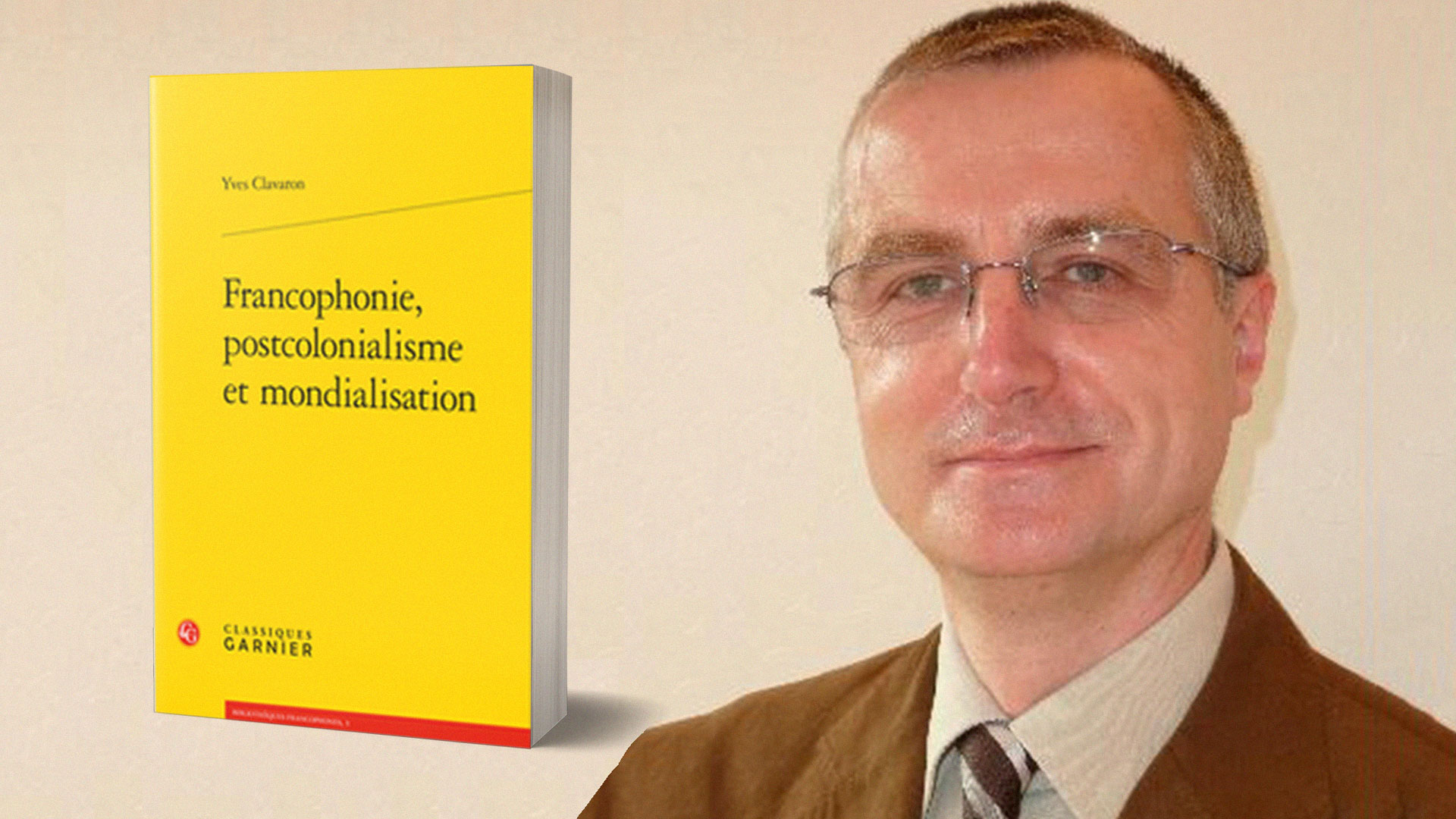
ومن المعروف أن هذا الأرشيف ليس "الأرشيف الوحيد المتاح، ذلك أن المرحلة التي أعقبت تصفية الاستعمار شهدت أيضًا توسيعًا وترسيخًا شديدين لتقاليد أدبية في عدد من اللغات
المحلية"[8]. غير أن ما يُحسبُ لكلافارون، وبخلاف كثير من النقاد الغربيين الذين كتبوا عن مجموعة من النصوص من آسيا وأفريقيا، وهي عملية دارت في البلدان المتروبولية منذ مئتي عام، وأدت إلى ما يسميه إدوارد سعيد "الاستشراق"[9]، هو المنظور المختلف المتبع في الكتابة عن الأدب المكتوب باللغة الفرنسية. وإذًا، يتعلق الأمر بإنشاء عالم أدبي جديد خالٍ من الأصفاد الوطنية، وإعادة التفكير في هندسة الأدب المكتوب باللغة الفرنسية بطريقة أكثر انفتاحًا، من أجل دخول ما بعد الفرانكوفونية[10].
يمكن القول إن الفكرة الأساس التي يجلّيها المؤلف ترتبط بالموقع، أو المكانة، التي من المفترض أن يحتلها الأدب المكتوب بالفرنسية في سياق العولمة. فإذا كانت الفرانكفونية تدور حول المركز الذي تمثله العاصمة الفرنسية باريس، فإن الأدب العالمي المكتوب بالفرنسية يطمح لأن يكون عالمًا متعدد المراكز. إن النهوض بهذا الأمر يقتضي القيام بمراجعة نقدية لمفاهيم الفرانكفونية وما بعد الكولونيالية والعولمة في سياق معولم من أبرز سماته أنه يتيح اجتماع "جماعات إثنية كبيرة من مختلف البلدان المستعمرة سابقًا في المتروبولات بطريقة تدفع شرائح واسعة إلى أن تطلق أنواعًا جديدة تاريخيًا من الطلب على الاندماج في الطبقة المتوسطة المتخصصة المأجورة وأنماط تعليمها وعملها واستهلاكها وتقويمها الاجتماعي وترقيها الوظيفي"[11]، وبالتالي لم يعد ممكنًا مع هذا الوضع المعولم التفكير في آداب ما بعد الكولونيالية، أو الآداب المهاجرة، على ضوء ثنائية اللغة - الأمة، كما أن هذا السياق المختلف قد ألقى بظلاله على المفهوم التقليدي عن الدولة - الأمة Etat-Nation وحدودها التي لم تعد منيعة.
إن قراءة دقيقة لآداب ما بعد الكولونيالية لا تستوفي شروطها، كقراءة، إلا بالأخذ في الاعتبار البعد العالمي. وبما أن الفرانكفونية ما فتئت تَتَعرضُ لانتقادات قوية بسبب صلتها بالاستعمار الفرنسي من جهة، وطابعها المنغلق من جهة ثانية، فإن السّعي لفهم أعمق للآداب المكتوبة باللغة الفرنسية، يقتضي الانطلاق من فرضيات مغايرة من شأنها ليس فقط الإسهام في الخروج من التمثيلات الاجتماعية والسياسية الوطنية، وإنما أيضًا توسيع دراسات ما بعد الكولونيالية بإثرائها بمفاهيم جديدة تمكّن من تفكيك التواريخ الخطية للمعنى والحقيقة، والكشف عن قواعد لعبها.
هكذا يتبدّى المسعى النقدي الكلافاروني المغاير للرأي النقدي السّائد، بوصفه يَهدفُ إلى الانتقال من الفرانكفونية التي باتت موضوعًا معرّضًا للاستخفاف إلى دراسات ما بعد الكولونيالية، بالرغم من كون النظرة إليها في السياق الفرنسي، حيث يسيطر الخطاب النقدي الحداثي، هي نظرة ريبة وشك، إلى الدّرجة التي بدا معها أن بيان الأدب العالمي Manifeste pour une littérature-monde الذي نشر في جريدة لوموند بتاريخ 16 مارس/آذار 2007 مُنحَ اعترافًا غير كامل بسبب ما يتخلله من أبعاد ما بعد كولونيالية تمثلت في الأساس في الإلحاح على أن إحدى المهام الأشد قوة التي ينبغي أن ينهض بها هذا الأدب هي الانتصار للحوار بين مختلف المناطق الفرانكفونية، وإعادة التفكير في العلاقة بين المركز والهامش، من خلال ظاهرات الهجرة، والمنفى، والشتات.
بهذا المعنى، يَتضمنُ الأدب العالمي باللغة الفرنسية الأدب الفرنسي، ويشجع على إعادة التفكير في النماذج الإقليمية التي تشكل حقل اهتمام دراسات المناطق Area studies من خلال إعطاء الأولوية لـ عبر الوطني وعبر الإقليمي. والهدف من ذلك هو تفكيك التراتبية التي عملت الفرانكفونية على ترسيخها، والتي تميل إلى ترك الأدب غير الأوروبي في الهوامش[12].
في هذا السياق، إذًا، يمكن لدراسات العولمة Globalization Studies أن تمثل، بحسب كلافارون، العلاج الفعّال في مرحلة انتقل فيها الوعي النقدي من الاهتمام بعمليات الإمبريالية الثقافية والاستعمار الجديد، إلى العناية بالظواهر المتعلقة بالازدواجية، والنسبية والعلاقات البينية في مجتمع معولم تغذيه التدفقات العابرة للحدود. وثمة مقترحان أساسيان يبرزهما صاحبُ "الانتفاضة الثقافية".
أولهما أن تراجع نفوذ مفهوم الدولة - الأمة قد أفسح المجال أمام أشكال جديدة من الممارسات الثقافية والأدبية تتميز بكونها عابرة للأوطان، كما أنها هجينة ومضادّة للإمبريالية، أما الثاني فيتمثل في دفاعه عن ما بعد الفرانكفونية post-francophonie التي يعبّر عنها أدب عالمي جديد باللغة الفرنسية، يَنبثقُ من رماد التحالف القديم المفكك بين اللغة والأمة، ويتخطى الحدود الثقافية والوطنية واللغوية، كما يدعو من خلال طابعه المناهض للإمبريالية وسمته العالمية، إلى العناية بالمشكلات البيئية.
بهذا المعنى، توفّر دراسات العولمة إمكانية واسعة لفكّ الارتباط بين أدب عالمي مكتوب باللغة الفرنسية، وإن كانت المفارقة الساخرة في هذه العملية هي قيام أدب عالمي على أساس اللغة الفرنسية، في الوقت الذي تمثل فيه ما بعد الكولونيالية المسعى المتاح للرد على الهيمنة الغربية، وبين فرانكفونية ما انفكّت تتعرّض للنقد والمساءلة بناء على أدوات جديدة تَستكشفُ حدودها، وهو ما يعطي المشروعية للتفكير في ما بعد الفرانكفونية على المستوى العالمي، كما تهيئ المجال لعملية توسيع المقترب ما بعد الكولونيالي كي يستوعب قضايا وإشكاليات جديدة من قبيل عمليات الانتقال والتبادلّ؛ التدفقات، والهجرة، والتهجين الثقافي، التي معها تنزاح الدولة الأمة من مواقعها الأثيرة.
من الصعوبة بمكان تقدير مسعى كلافارون إلى إعادة قراءة الأدب العالمي باللغة الفرنسية من دون الانتباه إلى المساحة التي يجترحها لتطوير دراسات ما بعد الكولونيالية، وذلك بتحريرها من المنظور النقدي المقارن الذي ظل لفترة طويلة مشدودًا إلى الآداب القومية والعلاقات بينها.
فإذا كان من الثابتِ أن النموذج التأويلي ما بعد الكولونيالي قد تطور في ميدان الدراسات الأدبية، وفي علاقة وطيدة بالأدب المقارن، فإن دراسات ما بعد الكولونيالية يُمكنُ أن تنفتحَ على أفق جديد واسع وعالمي، يَستوعبُ الفرانكفونية وغيرها من المناطق اللغوية. ومن بين المهام الأساسية التي ينبغي القيام بها، إعادة بناء الأدب المقارن وفق ما كان يَطمحُ إليه إدوارد سعيد، أي إفساح المجال أمام آداب الأطراف، وتجميد المركزية الجغرافية الأوروبية. وبدل الارتهان إلى مقاربة للأدب تَتمحورُ بالأساس على ما هو وطني، من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لمقاربات متعددة التخصصات، والاهتمام أكثر بالآداب غير الأوروبية التي تنطوي على رؤية جديدة للعالم. فالآداب والنصوص والمنتجات الثقافية والفنية المختلفة، تغتني وتتعزّز قيمتها الفنية من خلال تداول لا يتوقف عند حدود بلد، أو قارة، بعينها، ولكنها في رحلتها نحو القراء تتعرّض لضروب من التعديل والتحويل من خلال المنظور والقراءة والتلقي الذي يتسلط عليها من ثقافات أخرى.
وعلى هذا الأساس، فإذا كان الأدب والدراسات الأدبية قد شهدا مع العولمة تحولات كبيرة، فقدت معها الأمّة قيمتها المرجعية، أمام التدفقات المعممة العابرة للحدود، فإن ما ينبغي أن يثير الاهتمام بالنسبة للناقد ما بعد الكولونيالي ويستنهض مسعاه، هو التركيز على النصوص المستثناة من التدفق العالمي.
بهذا المعنى، يُمكنُ بناء منظور ما بعد كولونيالي لأدب عالمي باللغة الفرنسية متحرر من المركزية الفرنسية التي تعطي لنفسها الحقّ في رؤية كل أدب لا يَتمثلُ تقليدها برؤية دونية، حتى إذا كان هذا الأدب يفوق تقليدها ثقافة واقتراحًا جماليًا. فإذا كانت الرؤية السائدة اليوم حول العالم تَميلُ إلى إعطاء الأولوية للمزج بين الثقافات، والتوفيق بين الاختلافات، فإنّ الفضاءات ما بعد الكولونيالية؛ الفرانكفونية، أو الأنغلوفونية، تسعى لخلق فضاءات للتضامن والمصالحة اعتمادًا على التهجين والترجمة الثقافية، كما تنفتح على الأسئلة الإيكولوجية في إطار تصور للنقد البيئي قابل للاندماج في ما بعد الكولونيالية، بشكل يمكن معه التفكير في نقد بيئي ما بعد كولونيالي écocritique postcoloniale يتولّد من رحم العلاقة بين الوعي البيئي والجمالية الأدبية، كما ينهل مبرّرات وجوده من معين المقاومة، ويسائل مختلف المركزيات؛ كالمركزية العرقية والأوروبية واللغوية، إضافة إلى مفهوم الإنسانية الغربي.
وعليه، فإن هذا النقد الذي يجمع بين الانشغال بالظواهر الطبيعية وطرق الوجود في العالم، والبحث عن عالم جديد، من شأنه أن يتيح كذلك، بعيدًا عن التضادات الثنائية؛ مستعمِر ومستعمَر، عالم أول وعالم ثالث، الجمع بين البحث عن الهوية وإعادة امتلاك المجال، والولوج المنصف إلى الموارد الطبيعية.
2- التهجين الثقافي أفقًا
أيًّا كان الحكم الذي يُمكنُ أن يطلق إزاء دراسات ما بعد الكولونيالية، فإن استدخال هذا المشروع في خانة الفضاء الثقافي العربي الحالي، هو عمل ذو فائدة كبيرة، خاصّة في ما يخصّ توجيه البحث نحو مجموعة من الظواهر الثقافية، مثل ظاهرة التهجين والترجمة الثقافية، باعتبارها ظاهرة مميزة للمجتمعات العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار.
ومن هذا المنظور، تبرز قيمة الكتاب الثاني الذي نتناوله في هذه المقالة بعنوان: "حداثات عربية.. من الحداثة إلى العولمة" للباحث المغربي، خالد زكري. تتردد في هذا الكتاب أصداء أبرز منظري ما بعد الكولونيالية، أمثال إدوارد سعيد، وهومي بابا، ومفكري دراسات التابع، خاصة سبيفاك، وبارتا شاتارجي، الذين، وإن تركزت أعمالهم على تاريخ الهند، فإنها ألهمت عددًا من الباحثين إلى كيفية نصب الكمائن للعدو في أرضه، باستخدام مصطلحاته الخاصة[13]، وبالتالي دراسة علاقة الشعوب التي حصلت على استقلالها بالدول التي كانت تستعمرها.
|
"يَستفيدُ زكري من هذا الإبدال الواسع لدراسة اللقاء الصّعب بين العرب والحداثة خلال حقبة زمنية تَمتدّ من أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى الوقت الرّاهن" |
يَستفيدُ زكري من هذا الإبدال الواسع لدراسة اللقاء الصّعب بين العرب والحداثة خلال حقبة زمنية تَمتدّ من أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى الوقت الرّاهن. يَنطلقُ الباحث من متن رحلي عربي متنوع، يَشملُ رفاعة الطهطاوي، وفارس الشدياق، ومحمد الصفار، إضافة إلى نصوص دعاة الحداثة العربية، أمثال فرح أنطون، وشبلي الشميل، وقاسم أمين، وطه حسين، وسلامة موسى، وعلي عبد الرازق، وكذلك نصوص المفكرين السلفيين، كالأفغاني، ومحمد عبده، وشكيب أرسلان، للإضاءة على السياق الذي قاد العالم العربي نحو الحداثة الغربية في وقت لم يكن يتوفر فيه على الأدوات الضرورية لاستيعابها وتملّكها[14]. وإذا كانت المكتبة العربية تَحفلُ بأعمال كثيرة تناولت ما سمي بصدمة اللقاء بالغرب، وأفصحت
"يَستفيدُ زكري من هذا الإبدال الواسع لدراسة اللقاء الصّعب بين العرب والحداثة خلال حقبة زمنية تَمتدّ من أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى الوقت الرّاهن"
بشكل متفاوت عن النقد المزدوج للأنا والآخر، خاصة منذ فترة الستينيات، فإن ما يعطي دراسة خالد زكري القيمة النظرية والمنهجية هو نقاط الارتكاز التي تقوم عليها، والمستمدّة أساسًا من المرجعيات النقدية والنظرية لحقل ما بعد الكولونيالية؛ تسريد الأمة، الجماعة المتخيلة، الوعي ما بعد الكولونيالي، تفكيك المركزية، الذاتيات الجديدة، الترجمة الثقافية... إلخ، مما أتاح له بناء رؤية جديدة ليس فحسب من أجل فهم أشكال الحياة التي يولدها العيش في عالم معولم يتسم بالتهجين الثقافي، ويتطلب القدرة على الانزلاق بين الثقافات المختلفة، وإنما أيضًا من أجل التقاط ما يغني الحداثة العربية ويشرعها على فضاءات رحبة بوسع العالم.
الفكرة الأساس التي ينطلق منها زكري في هذا الكتاب هو أن اللقاء بين الثقافة العربية والحداثة الغربية، مثله مثل أي لقاء بين ثقافات مختلفة، لم يَخلُ من ظهور أشكال من الصراع والتوتر والازدواجية، وهذا أمر طبيعي لا يَمكنُ أن تستثنى من الوقوع فيه أية زمنية يُمكنُ وصفها بأنها زمنية تحوّل وانتقال. وعليه، فإن بناء الذات الفردية والجمعية في عصر النهضة كان يتم في فضاء تخترقه ثقافات متعددة. فهناك من جهة الثقافة العربية بتعبيراتها المتنوعة ذات الرسوخ العقدي والتاريخي، ومن جهة أخرى الثقافة الغربية التي تمثّل بالنسبة للعربي ثقافة إدهاش واستفزاز في الوقت نفسه.
لقد تولدت عن هذا الوضع أنماط مختلفة من التنظير برزت ليس في خطابات مفكري النهضة فحسب، وإنما أيضًا عند المفكرين العرب بتعدد تياراتهم خلال الستينيات، سواء الذين تبنوا الحداثة الغربية كخيار لا مناص للعرب منه لتحقيق التقدم واللحاق بالغرب، أو الذين لاذوا بالحاضنة الثقافية بمرجعيتها الدينية والتاريخية، وفكروا بالهوية على أنها مكتملة وناجزة، أو من يمثلون الخيار الثالث القائم على النقد المزدوج. ومن بين التحدّيات الأساسية التي تواجه هذا الخيار ازدواجية المشاعر، أو التناقض الوجداني.
ويرى زكري أن الازدواجية التي تتخلل الحياة اليومية وعلاقة الثقافات ما بعد الكولونيالية بالعالم الغربي لا يزال رنينها مسموعًا في الوقت الراهن، لأن التمثيلات الاستعمارية عملت على تجريد المستعمَر من أية إمكانية كي يمثل نفسه بنفسه. وعليه، ففي غياب أدوات نقدية ملائمة، غالبًا ما يُنظرُ إلى هذه الازدواجية بنظرة سلبية، بينما هي في الواقع يمكن أن تُمثل حالة منتجة.
في هذا السياق، يلاحظ الباحث أن العرب فهموا الحداثة بشكل مختلف عن الغرب، لقد زاوجوا في الوقت نفسه بين العودة إلى الجذور والانفتاح على الإمكانات التي يتيحها العالم المعاصر، مما حال، ولا يزال، دون النّجاح في تحقيق الحوارية، أو التمفصل الضروري لهذا الانتماء المزدوج[15].
من المنظور ما بعد الكولونيالي، يتبيّن أن التفكير في الحداثة العربية، سواء من زاوية المطابقة، أو الاختلاف، مع الغرب، قد يؤدي إلى الوقوع في شرك الاختزال، وبالتالي عدم الوعي بأهمية التاريخ والسياق، وبالواقع الثقافي المتعدد لهذه المجتمعات. ورغم ضروب الاختلاف التي أفرزتها التحولات الجوهرية التي مرّت بها المجتمعات العربية في تاريخها الحديث، فإن أغلب قادتها السياسيين، كما يرى المؤلف، يلتقون في الموقف الرّافض للتهجين والتعددية الثقافية[16]. هذا الرّفض لا يرتدّ فقط إلى التصلّب الأيديولوجي، بل يجد تفسيره أيضًا في كون التفكير في التهجين الثقافي من شأنه أن يدعم المطالب المتزايدة من أجل الاعتراف بكل المكونات الثقافية والهوياتية المشكّلة للمجتمعات العربية. ومن المعروف أن هذه المطالب لم تصبح موضع اهتمام من قبل بعض الحكام العرب إلا خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي، بفعل الفورة التي شهدها المجتمع المدني، وتوسّع الحركات الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية.
لا شك أن هذا الوضع يفسّر مآلات الحداثة العربية، حتى مع انطلاق ثورات الربيع العربي، وما حملته من آمال كبيرة بالنسبة لشعوب المنطقة لاجتراح زمنية مختلفة قوامها المساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. فالانكسارات التي طاولت مجموعة من التجارب العربية، والإخفاق في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية، يُظهرُ أن الفكر العربي بحاجة إلى مواجهة سؤال أساس: هل تبلورت سياسة لتحرير الذات العربية ما بعد الكولونيالية؟
يعدّ طرح هذا السؤال مسألة ملحة، لأن هذه السياسة، إنْ تحققت، من شأنها، بحسب خالد زكري، أن تقدّم أجوبة عن الصراعات الثقافية والتوترات حول الذاكرة والتاريخ، وبالتالي الإسهام في تحرير الذات العربية من الوقوع في شرك الانغلاق، سواء في السردية الاستعمارية، أو السردية القومية. ويقتضي هذا، إذًا، إعطاء اهتمام أكبر لمفهوم التهجين، لأنه يسمح لنا بالتفكير في الثقافة التي لا يمكن التنبؤ بها، والتي تظهر في حالات الصراع والتوتر السياسي[17]. وعليه، فالتحرر من القوة الجاذبة، إما في اتجاه التقليد، أو الحداثة، يتطلّب إعادة النظر والتعمّق والتأمّل، وبالتالي القيام بنقد جذري ليس فقط للتقليد، وإنما أيضًا
تحرير الذات العربية
|
"التفكير في الحداثة العربية، سواء من زاوية المطابقة، أو الاختلاف، مع الغرب، قد يؤدي إلى الوقوع في شرك الاختزال، وبالتالي عدم الوعي بأهمية التاريخ والسياق، وبالواقع الثقافي المتعدد لهذه المجتمعات" |
للإمبريالية. وعندما يُشدّدُ الباحث على أن ثمة حاجة ماسة إلى تدبير سياسي للتناقضات والصراعات التي تهيكل "الخيال الراديكالي" للمجتمعات العربية المعاصرة، وهو ما لم يسائله المفكرون في العالم العربي إلا بشكل ضعيف، فإن ذلك ليس المقصود منه التنكّر للماضي، وإنما المقصود منه تحرير الذات العربية من الإقامة الطويلة في ليل الذاكرة. إذ بهذا التحرر تنبجس تلك الإمكانية أمام الذات للمبادرة من أجل المشاركة في بناء فضاء ثقافي، حيث يصبح العيش المشترك ممكنًا[18]. من هنا، فإن السؤال المحوري الذي يمثل تحديًا كبيرًا هو: كيف يمكن الدخول في علاقة مثمرة مع الآخر في العالم الحديث، وقبول الفكرة التي مفادها أن الهوية في طور التكوين، وأنها مؤسسة على مبدأ الازدواجية المنتجة؟
انطلاقًا من هذا السؤال، يمكن فهم الأهمية النظرية والنقدية التي تكتسيها ظاهرة الازدواجية Ambivalence في المنظور النقدي للباحث. أولًا يعدّ هذا المفهوم أداة مركزية في شعرية الناقد الروسي ميخائيل باختين، فقد صاغه في إطار تناوله الملفوظ الروائي لكل من رابليه ودوستويفسكي انطلاقًا من الحدث الكرنفالي. بالنسبة لباختين، تتميز روايات دوستويفسكي بالطابع الحواري متعدد الأصوات الذي يضرب بجذوره عميقًا في التقليد الكرنفالي.
وبناء على هذا الفهم، فالرواية الحوارية تتأسس قيمتها الفنية والفكرية على القدرة على المزج والحوار بين مواقع متنافرة، بل متناقضة. وفي كتاب "حداثات عربية"، يرد هذا المفهوم لوصف موقع الذات العربية ما بعد الكولونيالية في سياق العولمة، حيث تعبّر هذه الذات في الوقت نفسه عن مشاعر واختيارات تتسم بالتناقض والتعارض مع محيطها الاجتماعي، وهي ظاهرة لا يُمكنُ قراءتها على أساس أنها حالة مرضية، بل هي حالة منتجة، لأنها تولّد الفضاء الملائم الذي يُتيحُ قيام حوارية عميقة بين المرجعيات الثقافية والعقدية من جهة، والقيم والرغبات الحديثة من جهة ثانية.
من هنا، يشدد زكري على مسألة مفادها أن العولمة خلقت سياقًا جديدًا لم يعد ممكنًا معه الركون للمفاهيم والتصورات السابقة عن الهوية باعتبارها ناجزة، أو مكتملة، كما لم يعد مقبولًا التفكير في الاختلاف الثقافي من خلال التضادات الثنائية، كالأنا، والآخر، أو الشرق والغرب، لأن الحوار بين التراث والحداثة الغربية أضحى مسألة ضرورية من أجل اجتراح مواقع جديدة للتلفظ والإفصاح، أو "فضاء ثالث" يتعيّن بوصفه محصّلة ضروب مختلفة من التطابق والاختلاف التي تقوم بها الذات العربية ما بعد الكولونيالية، من أجل معاودة التفكير في شرطها الخاص، واستكشاف إمكانات جديدة للوجود.
لا ريب أن العولمة فككت النفوذ السّابق الذي كانت تتمتع به الدولة الأمة، كما أحدثت تحولًا كبيرًا في العادات، وأشكال الحياة في المنطقة العربية.
ورغم الهيمنة التي ما زالت تحظى بها الجماعات، وأشكال الانتماء التقليدية، فإن العولمة عرّضتها لاختراقات قوية بسبب الانضغاط الذي طاول مفهومي الزمان والمكان، والحركة الواسعة للأفراد، مما جعل المفاهيم السابقة القائمة على التعصّب تتراجع أمام القيم المدنية القائمة على التنوع البشري الخلاق، كما أن صورة الآخر الغريب تتهاوى أمام الحضور الذي بات يحظى به في المشهد العام.
وليس من قبيل المصادفة أن يحفل الأدب العربي المعاصر بالأبعاد المختلفة لهذا الوعي المدني، إذ يكفي أن نقرأ التجارب الإبداعية الحديثة، خاصّة في ميدان الرواية التي هي نوع هجين يجمع بين أشكال مختلفة، كي يتبدّى لنا هذا الوعي في ثنايا النصوص التي تحتفي بظواهر التعدّد والتنوّع والتغيّر. فالكتاب يبدعون في تركيب عوالم روائية واختلاق نماذج من الشخصيات تتمتعُ بالمساواة مع البطل، وقد تتخذ موقفًا معارضًا لوجهة نظر الكاتب، كما ترفض الخضوع للأوامر القائمة على إلغاء الشخصية. ومن ثم فهي تخوض صراعًا دائمًا مع المؤسسات الاجتماعية المحافظة دفاعًا عن كينونتها وحقها في الوجود المختلف.
مراجع:
[1] - إليزابيت سوزان كساب، الفكر العربي المعاصر، دراسة في النقد الثقافي المقارن، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2012، ص447.
[2] - Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Presses Universitaires de France, Paris 1999.
[3] - Nicolas Pancel, Le postcolonialisme, Collection Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, Paris 2019, p.103.
[4] - كساب، الفكر العربي المعاصر، ص455.
[5]- Yve Clavaron, Francophonie, postcolonialisme et mondialisation, Editions Classiques Garnier, Paris 2018.
-[6] Khalid Zekri, Modernités arabes De la modernité à la mondialisation, Editions La croisé des chemins, Casablanca 2018.
[7] - Homi K. Bhabha, Les Lieux de la culture Une théorie postcoloniale, Traduit de l’anglais par Françoise Bouillot, Petite biblio Payot, 2019, p.10.
[8] - إعجاز أحمد، في النظرية طبقات، أمم، آداب، ترجمة ثائر ديب، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 2018، ص120.
[9] - المرجع نفسه، ص122.
[10] - Clavaron, Francophonie, postcolonialisme et mondialisation, p.29-30.
[11] - إعجاز أحمد، المرجع نفسه، ص123.
[12] - Clavaron, Francophonie, postcolonialisme et mondialisation, p.30.
[13] - حميد دباشي، ما بعد الاستشراق المعرفة والسلطة في زمن الإرهاب، ترجمة باسل عبد الله وطفة، دار المتوسط، إيطاليا 2015، ص171.
[14] - Zekri, Modernités arabes, p.9.
[15] - Zekri, Modernités arabes, p.9.
[16] - Zekri, Modernités arabes, p.311.
[17] - Zekri, Modernités arabes, p.324.
[18] - Zekri, Modernités arabes, p.324
- باحث من المغرب.


















