
سردية… سرديات: توجهات غربية – تمظهرات عربية
2025-02-03
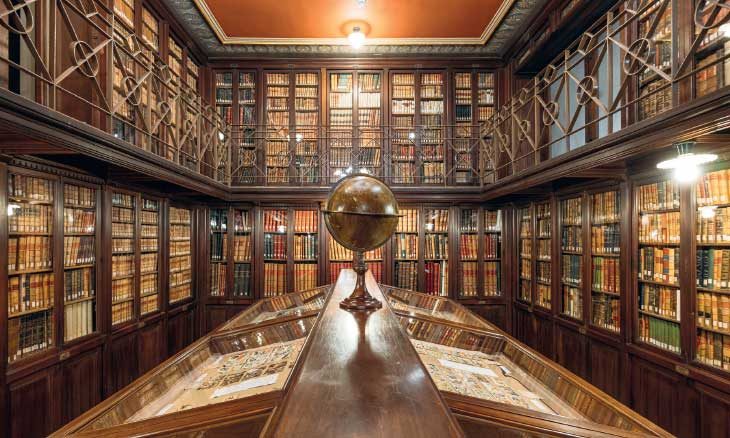 نادية هناوي*
نادية هناوي*
لأن علم السرد اليوم هو مجموعة علوم، تكثر أجهزته المفاهيمية. وكل جهاز يُوظَف حسب المتداول من النظريات والمنهجيات التي تفرض على من يستخدمها صيغا تحليلية خاصة إزاء أي مكون من مكونات الخطاب السردي، كالضمائر والفواعل والأبنية والمستويات والتقانات والمنظورات والدلالات.
وما تهيكلت أجهزة السرد إلا بشكل تدريجي وبعد عقود من التنظير والتوظيف، ابتداء من علمية البنية، وانتقالا إلى السياق والأعراف، وصولا إلى التجاور مع العلوم والفنون، على اختلاف التخصصات. وقد لاحت طلائع هذا التهيكل مع الشكلانيين الروس وحلقات كوبنهاغن وفرانكفورت، ثم اتضحت أبعاده مع صدور عدد خاص من مجلة «التواصل» Communications عام 1966 في باريس. وتضمن مجموعة أبحاث كتبها أعضاء جماعة الشعريات poeticsفكان ذلك إيذانا بالتأسيس العلمي للسرد وبجهاز مفاهيمي، وجَّه تحليل النص ـ شعريا كان أو سرديا- وجهة ما بعد بنيوية مع الميل بوجه خاص ومكثف نحو النصوص السردية على اختلاف أجناسها وأشكالها، فتوسَّعت ميادين التجريد النظري والتحليل الإجرائي. وحصل تحول نوعي في هذا المسار حين غدت المنهجية ما بينية، تجمع بين منهجين أُحاديين؛ أحدهما نصي، والآخر ما بعد نصي، فكانت شعرية تودوروف وحوارية باختين وسوسيونصية غولدمان وأنثروبولوجية شتراوس البنيوية، وبنيوية لاكان النفسية. وتصاعد نطاق التوسيع الما بيني حتى غدا لا نهائيا بتناصية كرستيفيا وأطراسية جينيت ونصه الجامع وسيميائية غريماس وخطابية تشاتمان وغير ذلك.
ولعل أكثر ما يميز الأجهزة المفاهيمية لعلم السرد البنيوي ما بعد البنيوي (الكلاسيكي) أنها استطاعت – بما قدمته من تجريدات وممارسات – أن تتجاوز بنية النص إلى ما حول النص من سياق وشيفرات وقنوات اتصال. وأصبح القارئ والمؤلف وما يماثلهما من كيانات ضمنية محط العناية. وكان من نتائج هذه التحويلات والتوسيعات أن اختص العلم بالمدرسة الفرنسية؛ إذ في ظلها تم إنتاج عدة أجهزة انبثقت عن نظريات الانفتاح والتناص والقراءة والاستقبال ونقد استجابة القارئ، فضلا عما لحق بها من مناهج وآليات إجرائية انفتاحية تفريعية معرفية جديدة، تقع تحت باب التداولية والتأويلية والألسنية التلفظية والدراسات الثقافية التي عنيت بنقد الثيمات مثل، النسوية والهوية والآخر والجندر والسلطة والتاريخ والأيديولوجيا، الخ.
هذا التوسيع الذي طرأ على الدراسة العلمية للسرد هو ما تعارف النقاد العرب على تسميته إفرادا (سردية) وجمعا (سرديات) غير أن نقاد المدرسة الأنكلوأمريكية وجدوا في التوسيع تقليدية. ولهذا أطلقوا عليه اسم (علم السرد الكلاسيكي) بكل ما يتضمنه من مفاهيم واصطلاحات تتعلق ببنية النص الأدبي وخارجيات الخطاب الأدبي وغير الأدبي، في حين أطلقوا مسمى (علم السرد ما بعد الكلاسيكي) على ما حققوه هم من مستجدات معرفية وتحولات افترقت أو خالفت في أجهزتها المفاهيمية علم السرد الكلاسيكي، وإن كانت قد بنت أساساتها عليه.
وتأتي منطقية الوسم بالكلاسيكية من سرعة وسعة ما قطعته المدرسة الأنكلوأمريكية من أشواط، لم تتمكن المدرسة الفرنسية من مجاراتها أو الصمود أمام مدّها العلمي، وإنما ثبتت عند ما انتهى إليه التوسيعيون البنيويون وما بعد البنيويين، فلم تضف جديدا إلا في إطار أنكلوأمريكي.
وبهذا لا تكون المرحلة ما بعد الكلاسيكية مجرد توسيع للمرحلة الكلاسيكية؛ إذ أن في ذلك ظلما للأخيرة كونها قامت بالتوسيع أصلا، وإجحافا بحق الأولى، لأن إنجازاتها لم تكن توسيعية، بل ابتكارية من ناحية الطريقة التي بها تعاملت مع المتراكم المعرفي، فاستطاعت تجاوزه بما وضعته من علوم سردية، أخذ كل واحد منها – في مرحلتنا الحالية – هيئته المستقلة بذاته ضمن حاضن معرفي واحد أنكلوأمريكي.
ولأن السرديات الكلاسيكية مرت بحقبتين متضادين هما، التضييق والتوسيع، انبرى علماء السرد ما بعد الكلاسيكي يؤسسون طروحاتهم ويبنون مفاهيمهم على خلفية ما وجهوه إلى المدرسة الفرنسية من مؤاخذات، وما كشفوه من ثغرات، خاصة الانتقادات الموجهة إلى كتاب جينيت (عودة إلى خطاب الحكاية) 1983 وأفادوا في الوقت نفسه من نظريات لم تحظ باهتمام كاف من لدن نقاد المدرسة الفرنسية. ومن ذلك مثلا نظريات الألماني فرانز ستانزال وكتابه (المواقف السردية في الرواية) وتُرجم إلى اللغة الإنكليزية عام 1971، أي قبل نشر كتاب (خطاب الحكاية) 1972 لجينيت. وكان لهيرمينوطيقية بول ريكور وثلاثيته حول (الزمان والسرد) أثر مهم في علم السرد ما بعد الكلاسيكي، فتعدى مناطق التداخل والبينية والانفتاحية اللانهائية، متخذا من الفلسفة الأمريكية بوجه خاص حاضنة مرجعية له أولا، ومنتقدا نظرية التناص ثانيا وغير مقتصر على دراسة السياق والأجناس وعمليات التلقي ثالثا. وهذا ما جعله علما تعدديا، وبوحدة مجزأة، وأجزاء موحدة، حيث الواحد ينضوي في الكل، لكن الكل لا يمثل الواحد. وهذا كله ساهم في الارتقاء بمنجز جماعة أوهايو – وهي امتداد طبيعي لجماعة شيكاغو أو النقاد الجدد – واختصت بمشاريع سردية مستجدة، تمخضت عنها وعن مراكز بحثية أخرى علوم السرد ما بعد الكلاسيكية.
وعلى الرغم من التعددية والتنوع في الاختصاصات والثقافات والأعراق والجغرافيات، التي بها تتباهى المدرسة الأنكلوأمريكية، فإن الوازع الحقيقي لها ولمدارس الغرب التي سبقتها هو الحصر والانتقاء والتحيز. وهو ما يتجلى واضحا على مستوى رسم الاستراتيجيات وبناء المشاريع من خلال: أولا اتخاذ اللغة الإنكليزية لغة موحدة ووحيدة في إنجاز الأبحاث السردية – وهذا ما كانت المدرسة الفرنسية قد اتبعته أيضا، حين عممت لغتها على الباحثين غير الفرنسيين ـ وثانيا حصر المنح والزمالات والشراكات بباحثين من أعراق وجغرافيات وجامعات تنتمي إلى بلدان متقدمة صناعيا، أو متحالفة استراتيجيا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأي عملية إحصاء لمشاريع علم السرد ما بعد الكلاسيكي، ستكشف أن أكثر العاملين فيها هم من الألمان مثل مونيكا فلودرنك ونسغار نونينج وجان البر، وأقل منهم من جنسيات أخر كالفرنسي جون بيير والصيني بيو شانغ ودان شين، إلخ. ولا وجود بطبيعة الحال لأي عنصر عربي في هذه المشاريع، في حين تكثر العناصر المنتسبة لجامعات الكيان الصهيوني.
وبدلا من أن نوحد جهودنا نحن النقاد باتجاه صنع مفارقة بحثية تفيد من هذه الثغرة الكولونيالية، فإنَّ المتحصل غير ذلك. ويتمثل في الانحياز إلى متراكم علم السرد الكلاسيكي مع التحفظ والتشكيك في أي اشتغالات تجري في منطقة المستجدات المعرفية لعلم السرد ما بعد الكلاسيكي. وعادة ما يتخذ التحيز والتحفظ ثلاثة تمظهرات:
– التمظهر الأول: إغداق الأسئلة من دون أي سقف بحثي نظري أو تطبيق عملي يشرعن التساؤل ويعطيه بعدا واقعيا، بل هي أسئلة مستغلَقة. ليس لأن لا طائل معرفيا من وراء الإجابة عنها، بل لأن بعضها يناقض بعضا من قبيل التساؤل عن الطريقة التي تحقق (لنا) الانتقال من السرديات الكلاسيكية إلى السرديات ما بعد الكلاسيكية ثم إلحاق السؤال بسؤال آخر ينسف قدرة هذه الـ(نا) على الانتقال. أو يتقدم السؤال حكم قطعي جازم بأن التعدد الاختصاصي خاص بالغربيين وليس عند(نا) مثله، ليأتي الاستفهام بعد ذلك استنكاريا تهكميا: إذن كيف ننفتح على السرديات ما بعد الكلاسيكية؟
– التمظهر الثاني: التعامل بعشوائية مع مفردتي (سردية/ سرديات) على أساس أنهما ثيمتان ثقافيتان عامتان تصلحان لأي موضوع من الموضوعات. وكثيرا ما تصادفنا عناوين مقالات تتعامل مع مفردتي «سردية وسرديات» بمجانية وبلا مفهومية ومن دون خبرة أو تخصص البتة. لا لشيء سوى ما يجده أصحاب تلك المقالات فيها من جاذبية، تلفت أنظار القراء إلى موادهم الإنشائية المدبجة بخواطر وتعبيرات شتى من دون أي اشتمال على مصطلح أو مفهوم سردي بعينه، بل هو التلفيق لا غير.
– التمظهر الثالث: يتمثل في بث روح القنوط والتشاؤم عبر الاشتكاء والادعاء بأن النقد الأدبي وصل اليوم إلى حد لن تقوم له قائمة غدا. وتتعدد الادعاءات فتارة تأتي من باب أن ما يجري من ملاحقة مجرد ترجمة وأن لا حظ للنقد العربي في المساهمة بتطوير السرديات العالمية، لا حاضرا ولا مستقبلا.
لا يخفى ما في هذه التمظهرات الثلاثة من نزعة غير سوية تضع العربة أمام الحصان، الأمر الذي يقطع الطريق أمام أي تقدم، بل هو يعادي ويصادي أي توجه تشم منه رائحة الملاحقة الجادة لراهن المدونة الغربية، مع أن كثيرا من هذا الراهن ما يزال في طور الاختبار، ولم يصل بعد إلى مرحلة الإنضاج. وفي هذا فرصة ينبغي أن تغتنم وليس سبة تَجلب لمن يريد اغتنامها المصائب. والمؤلم حقا أنّ الناقد العربي بدلا من أن ينبذ عنه الأحادية ويعمل بروح جماعية، أو في الأقل يجرب الشروع في تلمس الجديد في مجال العلوم السردية، تراه قانطا عبوسا مع أنه لم يحرث في الأرض بعد، يبث اليأس ويوحي بالعجز وهو لم يأت بشيء ذي بال، كي نصدق دعواه، ونشاركه لوعة شكواه.
وسواء استعمل القانط الأسئلة التهكمية أو اطمئن إلى أسلوب الشكاية وتبخيس الذات، فإن النتيجة واحدة هي، انتقاص مجهودات النقد العربي وتجهيل فواعله. وفي هذا تضامن غير مقصود مع الآخر (النقد الغربي) الذي هو أكثر براعة في تجاهل النقاد العرب إذ لم يقم على مدى تاريخه الممتد من القرن الثامن عشر إلى القرن الحالي بمدَّ أية جسور بحثية معهم، مستكثرا عليهم الفاعلية، مستنكفا من العمل معهم.
*كاتبة عراقية



















