
«شذور الذهب» للمصرية سيزا قاسم: ومضات معرفية في التاريخ والأدب
2023-09-04
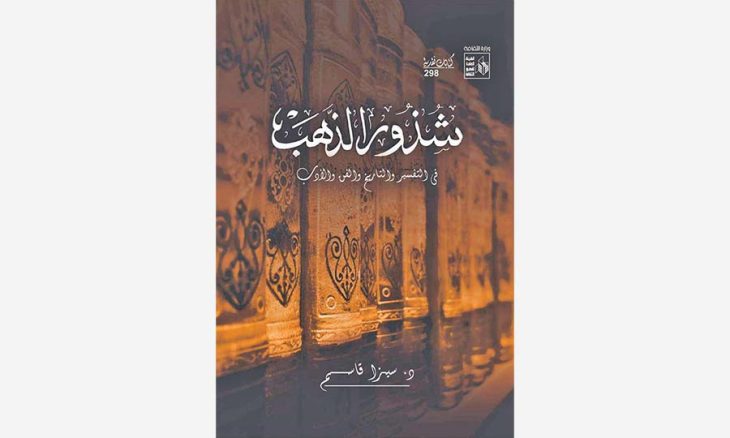
محمد عبد الرحيم
للناقدة المصرية سيزا قاسم العديد من المؤلفات التي أسهمت بشكل كبير في تقدم الدراسات النقدية العربية، وفتح آفاق أرحب أمام الدرس النقدي، ومن هذه المؤلفات.. «مدخل إلى السيموطيقا» 1986، «القارئ والنص: العلامة والدلالة» 2002، «بناء الرواية» 2004، «طوق الحمامة: تحليل ومقارنة» 2014 و»روايات عربية: قراءة مقارنة» 2020. ومنه نجد تركيز قاسم على داسة الأدب المقارن من وجهة نظر سيميولوجية، متجاوزة الاقتصار على تفسير النصوص إلى مجال أوسع ينتمي إلى الثقافة الإنسانية بشكل عام. ويأتي كتابها «شذور الذهب.. في التفسير والتاريخ والفن والأدب» ــ الصادر مؤخراً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة، سلسلة الكتابات النقدية ـ استكمالاً لرؤيتها ومنهجها النقدي، وليضم عدة موضوعات شارحة ومفسرة في التاريخ والأدب، سواء بالتطرق إلى نصوص عربية قديمة، أو مناقشة أعمال أدبية حديثة، من حيث التأويل والدلالة والتواصل والتداخل مع ثقافات أخرى. وسنحاول استعراض بعض من موضوعات الكتاب، خاصة المتعلقة بالحدث التاريخي ومنهج تدوينه، وعلاقة التاريخ بالأدب.
الخطاب التاريخي
تستشهد المؤلفة في البداية بعبارات لعابد الجابري في كتابه «نقد العقل العربي» من حيث كون الحضارة العربية هي حضارة فقه، كما اليونانية حضارة فلسفة، والأوروبية حضارة علم وتقنية. ومن الفقه تتعرض قاسم إلى منهج الكتابة التاريخية العربية عند كل من الطبري، المسعودي وابن خلدون، فقد تأثر هؤلاء بشكل أو بآخر بمدى قدسية النص، وهو ما انتقل بدوره إلى الخطاب التاريخي ـ الخبر والرواية التاريخية ـ فلم يجرؤ المؤرخ على نقدها أو تصحيحها، فقط.. بل التحقق من صحة النقل والإسناد وسلامته. وترى قاسم أن كلا من الطبري وابن خلدون، وبينهما المسعودي فقيه بالأساس. وتبدو الإشكالية في كيفية تناول كل منهما الحدث التاريخي وبالتالي كتابته، من خلال.. «تاريخ الرسل والملوك» للطبري، «مروج الذهب» للمسعودي، و»العِبَر» لابن خلدون، فبينما تبدو عفوية الإملاء لدى الطبري ـ المشافهة ـ نجد في المقابل انعزال ابن خلدون للتأليف، ثم المراجعة والتعديل المستمر حتى وفاته، ومنه فقد انتقل ابن خلدون من فكرة وسيلة المشافهة والمُتلقي السلبي للنص، إلى ما سماه (البصيرة) أي القدرة على النقد في عملية التلقي، ليصبح الأمر عقلانيا أكثر. أما المسعودي فانطلق من موقف (المُشاهِد) الذي يعتمد على المعايشة المباشرة للحدث، بديلاً عن الأخبار المتواترة، فكل من ابن خلدون والمسعودي حوّلا المخاطب من دور المستقبل الساكن إلى دور الفاعل، وبالتالي المُتأمل للحادثة التاريخية والناقد لها.
التاريخ والرواية
حقيقة الحدث هل نستمدها من التاريخ أم من الرواية؟ تدوين الأخبار أم الخيال الروائي؟ سؤال سيظل محل نقاش، خاصة مع انتشار الأعمال الروائية التي تستند إلى حدث أو واقعة تاريخية. هنا ترى سيزا قاسم أن هناك عاملاً آخر مهما يجب مراعاته عند مناقشة هذا الموضوع، مع وضع الذاكرة الجمعية في الاعتبار، ألا وهو (تمثيل الواقع). وتستشهد قاسم بمقارنة لافتة لعملين لصنع الله إبراهيم، أولهما «إنسان السد العالي» بالاشتراك مع رؤوف مسعد وكمال القلش 1964، ثم روايته «نجمة أغسطس» 1974. وترى المؤلفة أن «الخطابين تبادلا الأدوار، فبينما كان خطاب التخييل يُعري الحقيقة، أخذ خطاب الواقع يسدل عليها الستار ليخبئها عن الأنظار… إن ما فعله صنع الله إبراهيم في «إنسان السد العالي» هو تحويل الواقع إلى أسطورة.. لكن الخطير في الأمر هو وضع النصوص التخييلية موضع النصوص التاريخية وتصديقها وبناء القرارات عليها».
وتنتقل قاسم إلى «مدرسة الحوليات» وكيف بدأ التاريخ الالتفات إلى العادي والمألوف في حياة الناس، بمعنى الاهتمام بالحياة اليومية، والابتعاد عن الأحداث والشخصيات الكبرى، فتحول بذلك اهتمام المؤرخين إلى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فالتفت التاريخ إلى مصادر لم تكن تدخل في نسيج الكتابة التاريخية من قبل، وهو ما انعكس بدوره على علاقة التاريخ بالأدب.

















