
معاناة الفلسطينيين في قصص «قطة شرودنجر»
2023-09-02
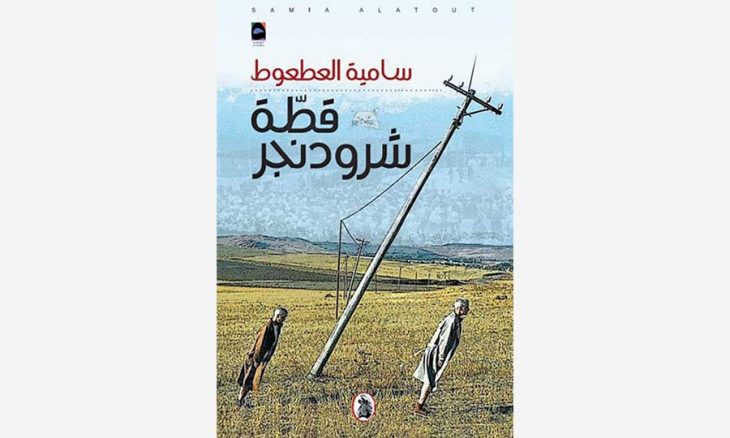
موسى إبراهيم أبو رياش
مجموعة «قطّة شرودنجر» القصصية أحدث ما صدر للقاصة سامية العطعوط، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وتضم عشرين قصة قصيرة وقصيرة جدا، موزعة على خمسة أقسام: «خشبة المسرح، سارة وغراهام، نساء على الحافة (نشوة محرّمة)، في الكتابة الموازية وقصص تسللت من دفاتر عتيقة». وتضمنت المجموعة موضوعات كثيرة؛ اجتماعية وعاطفية وعلاقات إنسانية وميتاسرد وغيرها. وتتناول هذه القراءة الواقع الفلسطيني والمأساة الفلسطينية المستمرة، كما صورتها المجموعة؛ كونها الحاضر الأبرز في قصصها.
قصة «عندما ولدت مرتين»، قصة حقيقية في جوهرها، حيث استشهد (محمد حجازي) أثناء العدوان على غزة عام 2008، وعندما أنجبت أمه طفلا سمته (محمد حجازي)، فاستشهد في عدوان 2012. وصورت القصة كأن الشهيد الأول عاد إلى رحم أمه، وولد من جديد، ولكن العدوان له بالمرصاد، فيموت شهيدا مرة ثانية. وكأني بالقاصة لو أكملت لولد ثالث واستشهد من جديد، وهكذا إلى أن تتحرر الأرض ويطرد الغزاة. وتؤكد القصة هنا أن أبناء فلسطين منذورون للشهادة، ولا تتوانى الأمهات عن الولادة وهن يعلمن مصير أطفالهن، فهذا قدرهن وقدرهم، ولكنهم جميعا لا يتراجعون ولا يترددون، ولا بدَّ أن يأتي يوم تسدد فيه فاتورة التحرير، فتعود الأرض إلى أهلها، وسيعيش محمد وسعد وغيرهم ويكبرون ويهرمون بين أهليهم، وعلى تراب وطنهم الذي ارتوى دما ودموعا من أسلافهم.
المعابر
تصور قصة «قطّة شرودنجر » معاناة الفلسطينيين على المعابر، التي أقامها الاحتلال الغاصب، والتي تقيد حركتهم، وتصعّب حياتهم، وتستهلك وقتهم وجهدهم، في ممارسة سادية متعمدة لضرب المعنويات وإذلال النفوس. وقد أدرك الفلسطينيون أن العدو يتربص بهم على المعابر، ويحاول أن يستغل أي حركة، أو حتى تعبير للانقضاض اعتقالا أو قتلا، ولذا هناك اتفاق غير مكتوب بين الفلسطينيين: «سِرْ ولا تنظر من حولك.. لا تلتفت.. تصنّع اللامبالاة.. ضَعْ قناعك اللامرئي.. وتوكل على الله»، ولكن يبدو أن إحداهن في الثلاثينيات من عمرها، نسيت الاتفاق لظرف قاهر، وانشغالها بأمر أهمها، فأفلتت منها ارتعاشة أو نظرة غير محايدة، فرصدتها أعين الجنود، فصوبوا نحوها رشاشتهم، فارتبكت وأسقطت حقيبتها، فأطلقوا عليها الرصاص.
على الفلسطيني أن يكون على المعبر مثل «قطة شرودنجر»؛ في حالة بين الموت والحياة، هو حي، لكنه في حالة جمود وسكون، ينبغي أن لا تصدر منه أي بادرة للحياة؛ وإلا أصبح هدفا لأعداء الحياة، ومن يرَ طوابير الفلسطينيين على المعابر، لن يدرك أنهم أحياء، وهم في الحقيقة، وفي تلك اللحظة، أموات، إلى أن يجتازوا المعبر، ترتد إليهم طبيعتهم وبشريتهم، ويخرجون من قفص شرودنجر وقطته.
قصة مؤلمة، أشبه بفيلم سينمائي؛ قصير زمنيا، لكنه طويل نفسيا، ولو قيّض لهذه القصة أن تحول إلى فيلم لخرج مبهرا محزنا مأساويا.
قصة «ثلاثة فئران» تصور جبروت الاحتلال الصهيوني، وأن حواجزه ومعابره لا تمنع الفلسطيني من العبور فحسب، إلا بعد تدقيق وتفتيش ومعاناة شديدة، بل إنها حتى تمنع الفئران ما دامت مقبلة من منطقة فلسطينية؛ فربما هذه الفئران مبرمجة لتكون سلاحا ضد العدو، وربما تكون مدججة بالأوبئة تستهدف الاحتلال، وربما تكون وسائل تجسس وعيون للمقاومة، وربما وربما، ولذا قامت مجندة مرعوبة، بقطع أذناب الفئران، وتوقيفها على الحاجز، فأراد صاحب الفئران أو صديقها، أن ينتقم ويقطع ذيل المجندة، وقبل أن يفعل، صرخت المجندة، فتجمع الجنود، وأصيبت عينه برصاصة مطاطية، وسط فرحة وسعادة وتهليل الفئران الثلاثة، ثم لم يعد يشعر بشيء، فقد اقتيد إلى مصحة عقلية. فهي قصة تصور رعب العدو من كل ما يمت للفلسطيني بصلة، ولا عجب، فأرض فلسطين وكل ما عليها من أحياء وجمادات وبشر وحجر، ترفض المغتصب، وتقوم بواجبها في المقاومة والنضال لطرد العدو، وأي بقاء لهذا العدو المتغطرس الذي يعاديه حتى الهواء الفلسطيني والتراب الفلسطيني، وعسى أن تكون فئران قصتنا كفئران سد مأرب، تقوض الجدران العازلة، وتزيل المعابر والحواجز، وتسبب فيضانا يقتلع العدو وينهي وجوده على الأرض المباركة.
مسرحية وقصة
تجسد قصة «القدس بين مسرحين»، مشهدا مسرحيا؛ حيث تنادى الأب وأولاده لقتل بنتهم غسلا للعار، وتنتهي المسرحية هنا، ولكن عندما تخرج البطلة (الممثلة المتهمة مسرحيا)، تصيبها رصاصة من رشاش جندي، في مقتل. فالعدو هنا، يفرض مسرحه على الأرض في ممارسة سادية برع فيها، فيحيل التمثيل إلى واقع، ويكمل المشهد المعلق، فيقتل الممثلة البريئة، في محاولة منه لتحويل حياة الفلسطينيين إلى كابوس دائم، ولا حق لهم في الحلم والتخيل والتعبير عن قضاياهم، بل لا بد أن يجعل حياتهم ضنكا وتعاسة ومأتما لا يتوقف. إنه العدو؛ عدو الحياة والحب والحلم والإنسانية والسلام والجمال، عدو الزهور اليانعة وأريجها الفواح، ونسيم الصبا وندى الصباح، عدو الطفولة والبراءة، عدو الأرض والسماء وكل الأنبياء والأولياء، بل هو عدو نفسه، وسيرتد كيده إلى نحره، وإنا لمنتظرون.
في قصة «البحث عن قصة جديدة»، يأتي القاص إلى مدينة نابلس، يسير في شوارعها وأسواقها القديمة، «تستعيد ذكرياتك، ذاكرتك الهرمة.. تبحث عن رائحة ما قديمة، ربما علقت في جوها منذ ثلاثين عاما، ولا تجدها.. تبحث لك عن قصة فاتنة، تشارك بها أمسية ما، لكنك لن تجد». وكأن هذه القصة تغمز من قناة بعض الكتاب الذي يعودون إلى مدنهم وقراهم بعد عقود، غرباء عنها وعن ترابها، لا يريدون إلا البحث عن مادة يكتبونها، وتسطع أسماؤهم كمبدعين لم ينسوا فلسطين، وما زالت تنبض في عروقهم وعلى صفحات كتبهم. وتأتي الصفعة مدوية «لن تجد أي قصة قصيرة هنا أو طويلة؛ فالشخصيات إما استشهدت أو سُجنت أو هُجِّرت. والحكايات علقت أحداثها على المحاسم (الحواجز)، والناس يتراكضون من جهة إلى أخرى، يصطدمون بجدران عالية، تحجب عنهم أشعة الشمس ونسيم البحر. وأنت، أنت تقف وراء الجدار العازل، تقرعه بقوة، تنادي على شخصياتك وما من مجيب! أنت تأتي إلى هنا تبحث عن قصة ما، فتصبح أنت نفسك قصة عالقة على الحدود، تبحث عن كاتب لها!». فالشخصيات التي كنت تعرفها قديما لم يبق منها أحد، والآخرون محاصرون بين المعابر والجدار العازل، الذي يحرمهم من كل أسباب الحياة، وهذا الكاتب الزائر الذي يستدعي شخصياته التي يعرفها، تحول هو ذاته إلى شخصية محاصرة، وقصة عالقة، تبحث عن كاتب ليكتبها؛ فقد جاء صيادا فأصبح صيدا!
تصور القصص السابقة وغيرها، أن الفلسطيني يعيش في واقع أليم، ومعاناة شديدة، وصراع من أجل البقاء والصمود، على الرغم من حواجز العدو وجدرانه العازلة ورصاصه الغادر، وكل آلات البطش والتنكيل التي يستخدمها، دون أن يرف له جفن، ولكن الفلسطيني بصموده وهو الأعزل، أقوى من عدوه، وإرادته من فولاذ، ويتمتع بعزم لا يلين، والصراع مستمر، ولكن النهاية محسومة بلا شك لأصحاب الأرض، الذين انتصروا وطردوا كل الغزاة الذي لم يتوقفوا على مرّ التاريخ؛ انهزم الغزاة، وأشرقت فلسطين بشمس أهلها.
كاتب أردني

















