
اللغة ومستويات السردية في رواية «77 خريفا»
2023-08-07
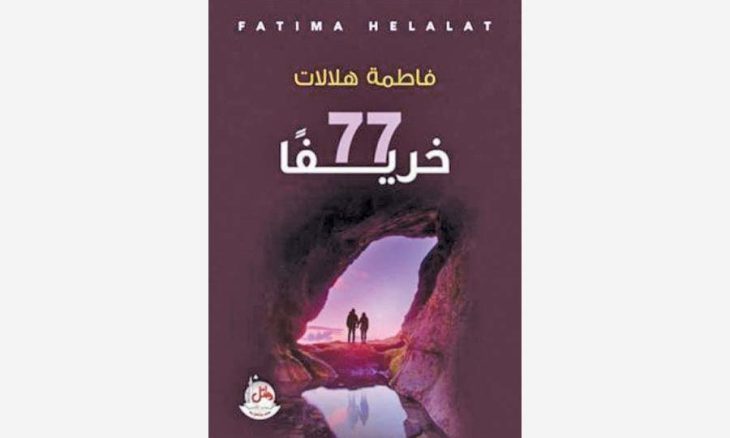
علي لفتة سعيد
تنتهج رواية «77 خريفا» للروائية الأردنية فاطمة محمد هلالات إلى ما يمكن تسميته بالرواية التعبيرية، التي تعتمد على مفعولي اللغة من الوصف الخارجي، والحالة النفسية التي يقودها الراوي/ الراوئية وهي تراقب الحركة من خارجها وداخلها سعيا منها إلى إعطاء الملمح السايكولوجي. ولهذا نجدها تأخذ مفعول اللغة الشعرية، في قدرتها على بناء المتن السردي الموصول إلى المبنى الحكائي. فهي لا تأخذ طريق الروي الحكائي في تقشير فكرتها، ولا أخذ الفكرة للوصول إلى الحكاية عن طريق تركيب أواصر الداخل والخارج، بل اتّخذت من التقسيم اللغوي في عملية التركيب للجملة السردية، ما جعل الأمر يأخذ انطباعا بأن الروائية جعلت من راويها الواصف يبني جمله في المتن السردي على أساس فاعلية اللغة ذاتها وقدرتها على منح الدهشة من جهة، ومنح التصاعد الدرامي من جهة ثانية. ولهذا نرى أن الكاتبة سعت إلى أن تجعل من المتن تشكيلا روائيا وقصصيا وشعريا أيضا من ناحية الشكل، فهي تجعل الحوار متقطّعا، أو أنها تجعل المونولوج متقطّعا بطريقة الترتيب الشعري، مثلما تجعل المتن موازيا للسرد القصصي في التعبير عن نهاية الجملة.
إن اللعبة التدوينية في هذه الرواية انبنت على ثلاثة أجناس أدبية وجنسين من الفن.
الأوّل: البناء الروائي، حيث وجود الصراع والحوار والتصوير والإخبار الذي تعتمده الرواية.
الثاني: البناء القصصي حيث الجملة القصيرة التي تتبعها جملة قصيرة سريعة.
الثالث: البناء الشعري حيث تضمن المقطع السردي روحية الشعر، أو نصّا شعريا يكون موازيا لمفعول القصة أكثر من اقترابه من مفعول الرواية في محاولة لمخالفة الكتابة الحكائية والاقتراب من الكتابة الشعر حكائية.
أما اللعبة في جنسي الفن فهما:
الأوّل: الفن المسرحي حيث أخذت في لعبتها وضع الحوار عبر الإشارة الخارجية/ قال.. وقلت/ مع الإشارة إلى الحركة المصاحبة لفعل القول.
الثانية: الفن السينمائي، حيث تعمل على تقطيع المشهد إلى عدّة مشاهد ترتبط بالحالة السردية الحكائية من جهة، والحالة التصويرية من جهةٍ أخرى، ما يجعل المستوى التصويري هنا بارزا في التبويب، وغاطسا مع المستوى الإخباري حيث تحتاجه العملية السردية.
وهي بهذا تعمل على أخذ الواقع من خلال فعل المخيلة وإشارات السيميائية، سواء للمكان الذي لا تريد أن تعطيه مباشرة (أنا أسكن صومعة هناك، وإن شئتِ كهفا.. سمّه ما شئتِ».
اللغة والشعر ومستويات اللعبة
تكاد الرواية تكون مبنية على أساس التنافر القصدي تارة، والتمازج اللغوي تارة أخرى. فالروائية جعلت من موضوع الرسائل مدخلا مهمّا للاتّكاء على خاصيّتين مهمّتين من خواص البناء السردي.
الخاصية الأوّلى: التفاعل بين بطلي الرواية، حيث لا إشارة للأسماء لهما إلا في السياق الوصفي، على العكس من أسماء الشخصيات الأخرى، ما جعل اللعبة تنتقل من هذا الاتجاه إلى الاتجاه الآخر، عبر توليفات ترتبط بالحدث العام (هذا الغروب له عيد ..سمعهم وهو ينزل الجبل يغنون أغاني العيد، المتنزه المكتظ المزين بالأضواء، الطريق المزدحم، الأطفال وملابسهم البهية الجديدة . وهي جالسة حيث هي).
الخاصية الثانية: الانتقال من البطلين إلى الأبطال الأخرين، عبر خاصيّة الرسائل التي وردت خمس عشرة مرة، والتي جعلتها ضمن المتن مرّة وضمن الحوار مرة أخرى وضمن صوت الشخصيات وما يرتبط بها. وهذه الرسائل جاءت على شكل نصوص شعرية أو حوار يمتلك من الشاعرية التي عوضت عن نقص المعلومة عن الشخصيتين وما يحيطهما، (يحدّثُ نفسهُ، وبين ربما وربما، وقع بصره على الرسائل، تذكر رسالة لها تحدّثُ فيها نفسها :
« وأُحادثكَ في نفسي
في كثير من الكلام
كنتُ أتمنى أن أحكيه
لو كنتَ معي
نحن في الحقيقة يا أبتِ لم نحيا).
وهذه جاءت لتحقيق غايتين تقودان إلى تعزيز البناء والتدوين قدرة اللحاق بسردية الحدث.
الغاية الأولى: التفرّد في البناء أو مخالفة البناء السردي المعتاد، الذي يراقب الحركة ويتابع الحكاية ويسلسلها ويعطي مفعول الصراع من خلال تنامي وتصاعد الفعل الدرامي.
الغاية الثانية: التخلّص من هيمنة الفعل السردي في الخاصة الأولى ومنح ذاتها على التوغّل في الصورة الخارجية وهو ما يجعلها تتخلّص من لعبة التصاعد الدرامي التي يتخذها الكثير من الروايات للوصول إلى عقدة المشكلة أو الفكرة.
ومن خلال تفاعل الغايتين تبدو اللعبة أكثر وضوحا للمتلقّي، خاصة أن المنتجة حاولت أن تعطي مفعول اللغة القدرة الكبرى، ومن خلالها يمكن أن تعطي مفعول الصراع والفعل الدرامي للحدث الذي يعد أحد أهم العناصر السردية في الرواية، ومنشّط القبول والجذب والإدهاش والتقابل التفكيري، ولهذا فإن كميّة اللغة كانت كبيرة جدا، إلى حدّ أن المستوى التصويري كان خاضعا تماما لمفعول اللغة وسحرها، فهو الذي يقود الحدث الوصفي مثلما يقود الحدث السردي مثلما يقود الصراع داخل المبنى الحكائي، فاللغة هنا بشاعريتها، وشعريتها تأتي من أنها الوقود الذي يحرّك ماكينة السرد، وهو أمرٌ صعبٌ ربما لا يتم قبوله من قبل بعض القراء، لكنه ربما يكون مقبولا من بعض المتلقّين الذين يبحثون عن تفاصيل نقطة الالتقاء ما بين التلقّي والرواية، خاصة إذا ما أخذت اللغة مكانة أكبر من حجمها المراد في المساحة السردية، لأن تحوّل السرد من ماكينة احتواء الصراعات إلى حالة السرد تعبيرية، ربما تكون فيها مخاطرةٌ كبيرةٌ، لأنها ستفقد حالات الترابط ما بين اللغة والصراع فتأخذ حيّزا أكبر ممّا هو مطلوب منها.
اللعبة انبنت على هذه التفاعلية ما بين اللغة من جهة، وكلّ المستويات السردية الأخرى، وهي بنائية تحتاج إلى كميةٍ كبيرةٍ من انزياحات اللغة ذاتها، وقدرتها على التعويض للمواد الأولية للعناصر التدوينية. ولهذا نرى أن اللغة أخذت العديد من النقاط.
النقطة الأولى: إنها لغةٌ شعريةٌ هدفت إلى منح الصورة إطارها اللّوني بهدف الإتيان بما يعزّز المساحة الكلية والاتساع في تمديد الحدث واستطالته، مثلما يعطي صورة الانتقال من السرد إلى التصوير الداخلي، حيث الانتقال من صيغة المخاطب إلى الغائب، حسب المتن في هذا المقطع أو ذاك. (وبينما تتدفق الروايات، وتجرُّ وراءها طُرَفا خفيفة الظل، وضحكات في مسمعه الأيمن، يخطف خبر الطفل البالغ ثلاثة أعوام الذي لقي حتفه غرقا على أحد الشواطئ، مع شقيقه ووالدته واثني عشر فردا معهم قبالة أحد الشواطئ التركية في مركبٍ بحري متجه إلى اليونان؛ هربا من الحرب مسمَعَهُ الأيسر).
النقطة الثانية: إنها لغة تبين القدرة التدوينية لدى المنتجة وما تزخر به من تفاعل بين ذاتها كشاعرة وتدوينها كروائية. (بحثتْ عنه.. انتظرتْهُ، لكنها لم تجده هذا الغروب، وعادتْ من حيث أتتْ مبحوحة، على الطريق ذاته).
النقطة الثالثة: إنها لغةٌ تجعلها في ما تراه تميّزا لها أنها تخالف مبدئية السرد وتقطيعها والمراوغة بين الأجناس الأخرى، حتى في السردية الأخرى كالقصّة القصيرة وحتى القصيرة جدا في بعض التفاصيل.
النقطة الرابعة: إنها لغةٌ تستطيع من خلالها إعطاء الدافع الداخلي للأبطال عبر التحكّم بالانتقالات من هذه الشخصية إلى أخرى، ومن هذا المكان إلى آخر، ومن لحظةٍ زمنيةٍ إلى اتّساعٍ زمني وتصويري.
النقطة الخامسة: إنها لغةٌ في إمكانها ممازجة جميع المستويات السردية، بما فيها المستوى التحليلي والقصدي والتأويلي وحتى الفلسفي، إذا ما أخذنا أن المستوى الإخباري في الرواية تحوّل إلى عنصرٍ من عناصر المشهدية وتصويره.
النقطة السادسة: إنها لغةٌ مكّنتها من دمج المقطع الشعري المبوّب عن طريق الرسائل تارة أو الشعرية تارة ثانية، ليكون ضمن المتن الشعري. (أمّا هي فوقفتْ مُتسمِّرة في مكانها تودّعُهُ، وشهدت تأبينَهُ مع الغروب الآخر، وهمستْ لهُ بوصيتها الأولى والأخيرة وهي تحتضنُ صورتهُ مُلقى على ذاك الشاطئ :
«أخبرهم
قبل أن تغيب
أنك للموت قد اختصرتَ الطريق
أخبرهم
أننا خنّاك وتركناك
للغرق وأحضان الحريق
أخبرهم يا صغيري
أنّ الحياةَ من موتنا.. لم تشبع
ومن بؤسِنا بعدُ.. لم تقنع
شرقيةٌ عيناك)
النقطة السابعة: أنها لغةٌ جعلت من عملية التدوين تتّخذ من مساري المضارع والماضي طريقا لبناء طريقة الحوار والتنقل ما بين (قال ويقول. سأل ويسأل/ يسألها) وهي ربما تكون فيها كميّة من ضياع الترابط مثلما تكون فيها كميّة من جعل المتلقّي يتلهى بالإزاحات الشعرية، أو الترقّب الصوري للمشهد، أو حتى الحصول على دهشة اللغة ذاتها، على حسب دهشة التدوين السردي.
(نازلا من صومعته، أصوات احتفالات قادمة من البلدة القريبة ..
يسألها ببعض التفاؤل والفرح :
ـ أي عيدٍ هناك؟
ـ يُقال إنه عيد الحب .
ـ آه، تذكرت، عيد القلوب واللون الأحمر .
قالت: «نعم، العيد أحمر
ووردهُ أحمر
وأحمرنا لون الخوف
ولون الدم)
إن الرواية التي أعطت للعنوان مكسبا للبحث عن هويته وغايته وقصديته وتأويله، إنما جاءت بفكرة أن اللّعب على اللّغة يعطي مفتاح السرد، وأن التدوين المتغيّر يعطي بناء سرديا يحتاج إلى مقدرة المتلقي لجمع حاصل مجموع الصراعات التي كانت تحت عباءة اللغة وشعريتها، خاصة إذا ما تمكّن من مسك تلابيب الفكرة التي استلّت من واقعٍ أسود ومأساوي إلى واقعٍ سردي، ربما لم يكن أمامها لفضح المسكوت عنه الذي احتاجه العنوان، وما تمخّضت عنه الحالة النفسية للبطلين، ودلالة الأرجوحة والصومعة في أعلى الجبل، والشجرة القديمة في حديقة قديمة، من أجل إحداث فتقٍ في هذا المسكوت في واقعنا العربي.

















