
كتاب «شعرية الحضنة وشعراؤها»: رصد أدب شمال شرق الجزائر
2022-10-31
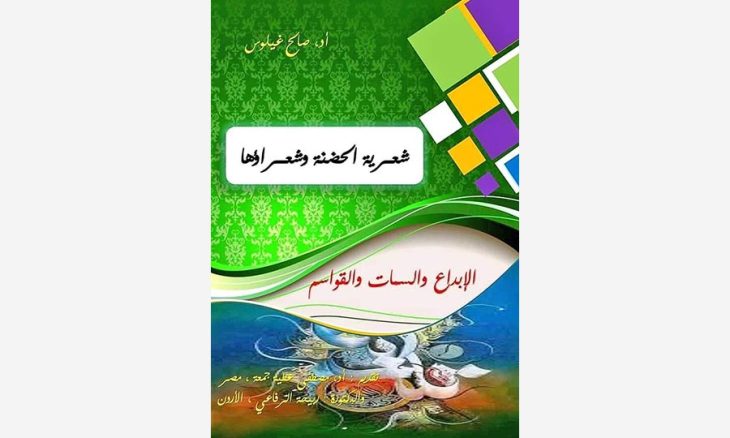
مصطفى عطية جمعة
يأتي كتاب «شعرية الحضنة وشعراؤها» لصالح غيلوس، ليسدَّ فراغا في المكتبة العربية عامة، ودائرة الإبداع في الشعرية الجزائرية خاصة، بالنظر إلى أهمية موضوعه، ألا وهو الشعرية العربية في منطقة الحضنة، تلك المنطقة القابعة في أقصى الشمال الشرقي في الوطن الجزائري، بكل ما تتميز به جغرافيتها، التي جمعت البحر والبر، والسهل والجبل، فلم يأتِ اسمُها « الحضنة» من فراغ، وإنما لكونها جاثمة في أحضان الطبيعة الساحرة، فتنوعت أنشطة سكانها الاقتصادية، وقويت لُحمتُهم الاجتماعية، وأقبلوا على العلم والإبداع والثقافة، فازدادت حركة الوعي والاستنارة، لتصبح الحضنة معينا لا ينضب في إمداد الوطن الجزائري بالعلماء والمبدعين، والشخصيات المناضلة المقاومة للاستعمار، إبان ثورة التحرير الكبرى.
وهو ما أصّله غيلوس في صدر كتابه، كي يتعرف القارئ العربي على الخصائص الطبيعية التي شكّلت بيئة الحضنة، التي ستكون عونا لنا في فهم حركة الإبداع الشعري وسماته في هذه البقعة الجغرافية، فلا يمكن فصل انعكاس المكان عن إبداع الإنسان، ولا يتسنى فهم السمات المشتركة بين المبدعين المنتمين إلى الحضنة، إلا بالنظر إلى البيئة التي عاشوا فيها، وصاغوا نصوصهم في رحابها. تبدو الإضافة العلمية التي اجتهد المؤلف في إنجازها في هذا الكتاب؛ في سعيه الحثيث إلى التعريف بالإبداع الشعري في الحضنة، من خلال استعراضه لأجيال متعددة من الشعراء الذين انتموا بالأصالة والثقافة والتكوين إلى هذا الإقليم. وهو ما نراه ضروريا للغاية في مجال الدراسات الشعرية العربية الحديثة؛ فقد انشغلت غالبية الدراسات الأكاديمية والبحثية بالشاعر الفرد، يدرسون إبداعه بمنهجيات عديدة، غير منشغلين كثيرا بالبيئة المكانية التي أنجبته، أو بالجيل الشعري الذي عاصره، ودون تفعيل لمنهجية المقارنة بين إبداعه وإبداع سابقيه أو مجايليه، أو حتى لاحقيه.
وهناك من الدراسات ما انشغل بالقضايا الإبداعية، مثل الاغتراب أو الهموم الوطنية والقومية، أو الظواهر الجمالية والتشكيلية في النصوص، ولكن نادرا منها ما تناول الإبداع الشعري في منطقة بعينها، من خلال التجميع والرصد لأجيال الشعراء المتتابعين فيها، وهو ما نراه من الأهمية بمكان، في ضوء الاهتمام الأكاديمي والإعلامي والثقافي بأدباء العواصم وشخصياتها الثقافية والفكرية، على حساب أدباء الأقاليم الذين واصلوا إبداعهم متمسكين بوجودهم في بلداتهم، عازفين عن الرحيل إلى العاصمة. وهي ظاهرة لا تقتصر على الوطن الجزائري حسب، وإنما تمتد لمختلف الأقطار العربية، حيث استأثر أدباء العواصم ومثقفوها بالأضواء والإعلام والدراسات الأدبية والنقدية، على حساب أدباء المحافظات والمدن والريف، وباتت المقولة الرائجة في الساحة الثقافية: «إن من أراد الشهرة فلا بد من العيش في العاصمة»؛ حيث يقترب من وسائل الإعلام، ويتواصل مع النقاد والصحافيين، وتراجعت في المقابل مفاهيم محورية، مثل أصالة الإبداع، وعمق الإضافة، وجودة النصوص، وروعة الأساليب.
وتبدو المفارقة أنه من الثابت أن الكثيرين لم يرحلوا، ومكثوا في قراهم ومدنهم، وواصلوا الكتابة الإبداعية، ما أوجد حراكا ثقافيا فريدا في مختلف الأقاليم العربية، وأضحت بعض المدن منافسا قويا للعاصمة، في ضوء استفادة الأدباء من الثورة التكنولوجية وشبكة الإنترنت بمواقعه ومنصاته ووسائل التواصل الاجتماعي، فحققوا وجودا فريدا، بل إنهم تجاوزا الطرائق التقليدية في تحقيق وجودهم الإبداعي، وأصبحوا وهم في أقاليمهم شخصيات لامعة تمثّل أوطانهم، وتفرض إبداعها ورؤاها. فكانت المحصلة النهائية وجود إبداع ومبدعين في مختلف المدن والولايات والمحافظات، ما ألقى عبئا كبيرا على الدراسات النقدية، للنظر في أعمال هؤلاء المبدعين، وتناولها بالبحث والدرس والتوثيق والجمع، أملا في وضع خريطة إبداعية للوطن، لا تقتصر على المشاهير من الأدباء، ولا القاطنين في العاصمة، وإنما ترنو إلى مختلف أنحاء الوطن: إحصاء ورصدا، تدوينا وفهرسةً، لتتاح الفرصة أمام الباحثين والنقاد لإنجاز دراسات أكاديمية شاملة، تنظر في المشترك، وتنتصر للمجيد المبدع، وتعيد تشكيل خارطة الإبداع الوطني على أسس جديدة، قوامها: الجدة في الرؤى والصياغة والقضايا المثارة، وأيضا طرائق المعالجة النصية.
وقد انتهج غيلوس نهج التعريف بمختلف التيارات والاتجاهات والأشكال الشعرية في منطقة الحضنة، متخذا من الشكل عنصرا مميِّزا له، بمعنى أنه لم يلجأ إلى الطريقة التقليدية المتمثلة في التدوين الزمني للأجيال الشعرية، من الأقدم إلى الأحدث، وإنما جعل شكل القصيدة معيارا له، فوضع نصوصا لشعراء معاصرين جنبا إلى جنب مع شعراء قدامى، ما دام التزم كلاهما بالشكل العمودي في نصه، وهذا ما نراه في ما قدمه من نصوص لشعراء القصيدة العمودية (الكلاسيكية) مثل عمر الشريف ميهوبي، وبلخير عقاب، ورشيد جدي، وعمار بن لقريشي، وأحمد بن روان.. إلخ، والأمر نفسه في شعر التفعيلة، ومن أبرز أسماء شعراء الحضنة في هذا الشكل: سليني غنية، وخير الدين هبال، وحسين مبرك، وصولا إلى قصيدة النثر، حيث أورد عددا من نصوص شعرائها ومنهم: عيسى ماروك، وإبراهيم صالحي، وعياش يحياوي، والأخضر فلوس، وخالد بن صالح.
والملاحظ أن المؤلف أورد أكثر من نص للشاعر الواحد، في أشكال عديدة: الكلاسيكية والتفعيلة وأيضا قصيدة النثر، ويأتي صالح غيلوس بوصفه شاعرا في مقدمتهم، ففي الشعر الكلاسيكي جاءت قصيدته «خلوة»، التي تفيض بالحب الإلهي، بتعبيرات إيمانية، وقافية شجية، وصور وأخيلة عليّة. ثم قصيدته الرائعة «ترانيم الوجد» والتي جمعت جماليات شعر التفعيلة موسيقى ورموزا، وحلقت بنا في أجواء جمعت الحب والنظرة السامية إلى الوجود والمرأة، مع توظيف بديع لجماليات التكرار والتخييل. وهو نفس ما نجده من مستوى فني في قصيدته النثرية «يداهمني الحنين»، والتي استخدم فيها ضمير المخاطب، في تعبيره عن ذاته الشعرية في رؤيتها التي نظرت إلى الكون الفسيح، كأنه قصيدة، رافعا شعار حريته في وجه كل طغيان.
لقد تنوعت النصوص الشعرية شكلا وطرحا ورؤىً، مثلما تنوّع شعراؤها في أجيالهم، وفي حضورهم، وهو ما ينبئنا أن الحضنة موطنا أصيلا للإبداع والمبدعين، ويجعل هذا الكتاب نبراسا لدراسات قادمة، تنظر في القواسم المشتركة، وتقدّم دراسات مفصلة لتجربة كل شاعر، وما يلتقي فيه مع غيره من شعراء إقليمه، آخذة في الحسبان أن هناك من الشعراء من عاشوا في العاصمة، أو اغتربوا في السفر، ومنهم الشاعر عياش يحياوي، والذي يحمل تجربة جمعت بين التفعيلة وقصيدة النثر، وكان من أبرز شعراء مرحلة الحداثة في الشعرية الجزائرية، وقد اغترب في الخليج لسنوات طويلة، وعاش ردها من الزمن في العاصمة الجزائر، ولكن ظل ينظر إلى الوجود والمدن نظرة اغترابية، شاعرا بأن انتماءه الحقيقي هو في مسقط رأسه المسيلة التي دفن فيها.
إن مثل هذا الكتاب، وغيره من الدراسات والبحوث، لا تكتفي بالنظر إلى الشاعر فقط، وإنما تسعى إلى نظرة أشمل، للشعراء في منطقة مكانية بعينها، خاصة أنه انفتح على أشكال الشعرية الحديثة: العمودي، والتفعيلة، وقصيدة النثر، متجاوزا الجدليات العتيقة حول شرعية كل شكل، وما أحدثه من إضافة جمالية، والتي نرى أن الحسم في جدال كهذاهو النظر إلى النصوص الشعرية ذاتها، من حيث الجودة والرداءة، والإيحاء والتوهج، فكل شكل له سماته المميزة، وتبقى الذات الشاعرة مثل النحلة، تمتاح من رحيق كل شكل، فتثري تجربتها، وتعمّق إبداعها. وهي الرؤية المتصالحة مع النص والشكل، والرؤية والطرح، تعترف بإبداع كل جيل، دون أن تغمط مبدعا أصيلا حقه.
كاتب مصري

















