
«رائحة التفاح» للسوري محمود حسن جاسم: الشخصية والمنظور… إعادة استجلاء التاريخ
2022-06-17
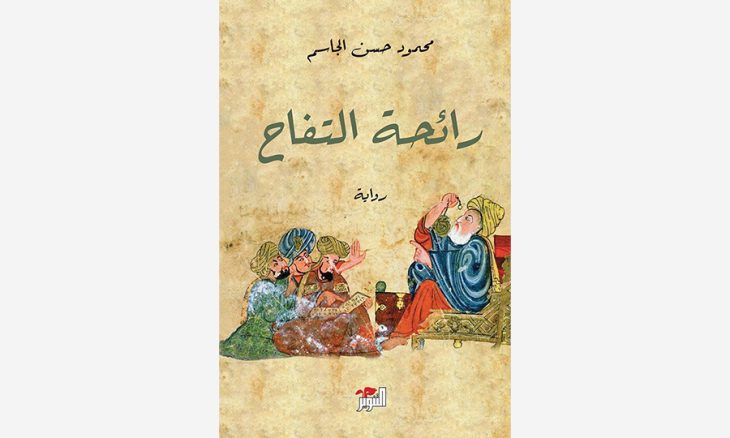
رامي أبو شهاب
قدم الروائي والأكاديمي السوري محمود حسن الجاسم عدداً من الروايات التي حظي معظمها باستقبال لافت، ولاسيما رواية «نزوح مريم» التي اختيرت ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2016. في روايته الجديدة بعنوان «رائحة التفاح» الصادرة عن دار التنوير 2022 نواجه تجربة سردية مغايرة عن سائر أعماله السابقة، من ناحية الفضاء الذي تنتمي إليه، إذ تعتمد التاريخ إطاراً ومرجعية لها، ومع ذلك فإنّ ما يوحد أعماله القدرة الواضحة على بناء متخيل سردي ناضج، كون رواياته مسكونة بمتوالية الحكاية، بالإضافة إلى بناء الشخصيات ضمن معالجة معمقة، ذلك أن الحرص على مكونات السرد يبدو جزءاً من عقيدة الكاتب الذي يخضع أعماله للمراجعة والبحث وصولاً إلى صيغ متكاملة؛ لا ضمن منهجية التكوين الدلالي حسب، وإنما مع الحرص على التسنين البنيوي للحكاية، ما يجعل من رواياته قائمة ضمن فاعلية السرد التي تستجيب لمعيارية فنية ناضجة.
التاريخ الآخر
في «رائحة التفاح» نواجه مغامرة سردية تحتفل بتضمين التاريخ ليكون عنصراً أساسياً في التكوين السردي الدلالي، لكنه ليس تاريخاً يختص بإماطة اللثام عن شخصيات – قد تبدو للوهلة الأولى لا تحتمل بعداً جدلياً، أو جملة من الدلالات كونها مسكونة بنمطية ثقافية – إلا أنه يستحضرها كي يعيد تموضعها في الوعي التاريخي عبر رؤية سردية مغايرة، ففي الرواية ثمة ما يمكن أن يُضاف عبر طرح هذه الشخصيات في سياقات تتقاطع في منطقة ترتهن للماضي والمستقبل في آن واحد، لقد استجلب إدراج هذه الشخصيات في السياق السردي المتخيل شيئاً من البحث بغية تعرية أو تعديل الكثير من المخبوء في تكوينها ورؤيتها.
ربما يعدّ النظر إلى الحقبة التاريخية التي يعنى بها العمل مرتهناً لسياقات تلك المرحلة؛ بما تحتمله من إسقاطات لا يمكن أن نعدها سوى نتاج تأويلي يحتكم لقراءات متعددة، إذ تنهض الرواية بشكل محوري على ثلاث شخصيات: اثنتين تخضعان لمرجعية واقعية تاريخية، ونعني شخصية الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعالم النحو الشهير سيبويه، في حين أن الشخصية الثالثة «رستم» شُيدت لتمارس وظيفة دفع المتخيل إلى حدوده القصوى، عبر خلق حبكة تستند إلى هيام هذه الشخصية بإحدى المغنيات التي جلبت إلى البصرة، مع تنافس عليها مع قبل شخص آخر، غير أن هذه الفتاة تفضل حريتها على أن تبقى أسيرة… في ظلال حكاية رستم يتولد شيء من الدفء والحميمية التي تسكن البنية الحكائية، بوصفها جزءاً من لعبة التحبيك السردي التي تتصل بالحكاية المحورية، ومركزها الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يطالع القارئ حكايته عبر المخطوط الذي يسنده لتلميذه سيبويه، الذي يطلب بدوره من صديقه رستم أن ينسخه ليمارس الأخير فعل السرد أو ليتمثل منظور الراوي.
يُشار إلى أن حدث وفاة الخليل في أحد المساجد في الرواية يعتمد مرجعية واقعية، غير أن المخطوط الذي يسرد قطاعات من حياة الخليل ضمن تقنية الاسترجاع قد يبدو جزءاً من المتخيل التاريخي، فحين يقوم رستم بنسخ هذا المخطوط يعلق القارئ بالحكاية التي تستأثر متناً كبيراً، غير أن هذا يأتي ضمن تقنية التناوب السردي بين زمنين: الأول زمن طفولة الخليل بن أحمد حتى وفاته، والزمن الثاني يتعلق بما بعد وفاة الخليل وزاده حكاية سيبويه بالدرجة الأولى، ومن ثم رستم بدرجة أقل.
هكذا نكون أمام زمنين لا يتقاطعان، إنما يصل أحدهما الآخر، لكنهما أيضا يندرجان ضمن فعل التناوب على مستوى الحكي ضمن ثلاثة منظورات، حيث الخليل بن أحمد الفراهيدي يكتب عن طفولته وتعليمه، والإضافات التي قدمها ضمن سياق عصره بما شهده من حروب وفتن ومكائد، علاوة على ذكر شخصيات تاريخية إشكالية، ومن جانب آخر نقرأ عن سيبويه وسعيه لتأليف كتاب يأمل من خلاله أن يفرض وجوده أو احترامه على الآخرين، ولاسيما أقرانه في علوم النحو واللغة، وبالتحديد الكسائي، على الرغم من أنه (أي سيبويه) كان يعاني من حبسة كان لها كبير الأثر في تراجع حضوره، بينما تتمثل الشخصية الأخيرة برستم الذي يجمع بين هذين المكونين فيأتي اختلاقه لغاية سردية أو بنيوية.
هكذا تبدو صيغ السرد جزءاً من فاعلية الحفر العميق في تكوينات هذه الشخصيات: هواجسها ومخاوفها وتمزقها بين البوح والاستتار، أو تمكين المضمر في نهجها وتطلعاتها، هي ثلاثة منظورات يتوسطها متلفظ الخليل الذي يلقي عينه على التاريخ كي يتأمله، وليحكي ما عاصره من أحداث تخضع من وجهة نظر القارئ ربما للكثير من الإسقاطات، كما تحتمل الكثير من الجمل الثقافية التي تضمر ضمن اللغة التي تمارس هلامية المعنى، وانزياح الدلالة تبعاً للتوليد الدلالي الآتي من لدن القارئ. قد تبدو الرواية في توجهها المبدئي مرتهنة لاستجلاء تموضع الخليل بن أحمد بوصفه الشخصية الأكثر حضوراً، فهي تتعقب نشأته، وجهوده، غير أن الدلالة ربما تستند إلى إعادة رسم حضور هذه الشخصية في الوعي الثقافي العربي، وذلك لا يرتكن فقط على هذه الخاصية، إنما يتعداه حين نقرأ السياق المكاني، فنرى مدينة البصرة تواجه مدينة الكوفة ضمن تنافس واضح لا يعدم دلالات مضمرة تتجلى ذروتها في المناظرة بين سيبويه والكسائي.
إن مركزية الحبكة السردية تستند إلى موضعة التاريخ اللغوي الذي صاغته هاتان الشخصيتان سيبويه والخليل، وهي مقولة عاينها القارئ عبر مواكبة ما كابده الخليل بن أحمد لتحقيق ما كان يرجوه من نتائج.
المقصد والمقصد الآخر
لعل تموضع سيبويه العالم النحوي الشهير بما يعنيه اسمه من إحالة، ونقصد رائحة التفاح بالفارسية، كما شغفه بالعطر أو الطيب المشتق من التفاح بيد أن تنافسه الشديد، ومناظرته مع الكسائي حول إحدى المسائل النحوية قد تبدو جزءاً من خطابية ما، وهنا ينبغي التساؤل عن معنى الثقل الدلالي في العمل عبر عملية التوجيه التي يمارسها المنظور السردي الذي يخضع لعدة موجهات كما يشير بوريس أوسبنسكي، حيث تكون وجهة النظر خاضعة لبعد أيديولوجي أو تعبيري أو أنها تتصل بموقف زمني أو مكاني، وهنا نرى أن الشخصيات تتغاير في هذا المستوى، فالخليل يعبر عن وجهة نظره، في حين أن ما دون ذلك يعتمد منظور رستم الذي يعكس موقفه، وموقف صديقه سيبويه في سياق محدد. منظور الخليل يبدو أقرب للتوصيف أو أنه مجرد من الأحكام، فهل يمكن أن يتعرض القارئ لنوع من التضليل، حيث تبدو مروية الخليل نسقا ظاهرا في حين يتوارى بين ظلالها مروية سيبويه الذي يستأثر بالعنوان، على الرغم من أنه يبقى أقل تأثيراً ضمن معيارية المتن السردي القائمة على البعد الكمي.
فشخصية الخليل لا تبدو جزءاً من حيوية دينامية تنهض على الصراع بمقدار ما تُظهر ذلك شخصية سيبويه ضمن مقولة السلطة التي انتصرت للكسائي في المناظرة الشهيرة – كما تذكر المصادر التاريخية – وهكذا فإن هذا التنافس بين هاتين المدينتين يحيل إلى نموذج صراع بين منظورين حيث كانت البصرة ذات ولاء يخالف ولاء الكوفة، وهنا يمكن أن نجترح قراءة منظور السلطة والمثقف، إذ كان الكسائي ينال حظوة لدى الوزير يحيى البرمكي، في حين كان سيبويه يعاني من التهميش والإقصاء، كما يمكن أن نلاحظ تلك الإحالات للتوتر القائم بين الأمويين والعباسيين، بين ثنايا الرواية؛ أي بوصفه سياقاً يحاذي التمركز الحكائي المرتهن للشخصيات، وبشكل عميق وواضح في مروية الخليل من جهة، ومن جهة أخرى موقف سيبويه المتوتر، في حين أن حضور رستم يبقى إضافة سردية تستهدف تمكين النسيج السردي لنخلص إلى أن محمود جاسم قد صان المتعة السردية من التآكل والصدأ.
فاعلية الانتقال
إن مركزية الحبكة السردية تستند إلى موضعة التاريخ اللغوي الذي صاغته هاتان الشخصيتان سيبويه والخليل، وهي مقولة عاينها القارئ عبر مواكبة ما كابده الخليل بن أحمد لتحقيق ما كان يرجوه من نتائج، ولا يمكن أن ننكر بأنها كانت شخصية سردية تتسم بالحيرة والتأمل، والإخلاص، وشيء من الانكفاء على الذات، وهنا نرى كيف أن خصوصية السرد وخطورته تتمثل عبر قدرته على إحالة تلك الجذوة من المتخيل الذي يتكئ على شخصيات قد تبدو نمطية، لكن محمود جاسم أضاف لها تلك الحرارة، ووضعها في مواقف وصراعات داخلية وخارجية، وفي كثير من الأحيان كانت تتكشف عن الكثير من الشغف والهشاشة، وربما السلبية. هكذا ننتقل بين وقائع سيبويه والخليل بن أحمد، وبينهما حكاية الوراق رستم وعشقه للمغنية، غير أن رستم يبدو لنا جزءاً من اللعبة السردية فهو صديق سيبويه، فتبدو وظيفة الرؤية أو وجهة النظر جزءاً من تكوينه الوظيفي، كما وضحنا سابقاً، علاوة على أن الرواية تعنى برصد تحولات الخلافة بين الأمويين والعباسيين، فتستحضر شخصيات ذات مرجعية تاريخية تندرج ضمن الإطار المتخيل، لكن مع شيء من المعالجة للوظيفة التاريخية والقيم الجدلية التي ترتبط بها، أو من حيث الحكم عليها، وهكذا يبدو التاريخي جزءاً من فاعلية تعميق المتخيل الذي يتسم بالكثير من التوجهات التي تقرأ هذا الحدث تبعاً لمنظور الشخصيات، التي تلقي ظلالاً من التفسير تجاه ما يحصل، في حين أن الموقف هنا لا يتبنى تصوراً معيناً، إنما هو يبقى في صيغة حياد واضحة لتبدو الحكاية جزءاً من عملية التفاعل بين المتلقي والنص، لكن الرواية لا تعدم شيئاً من إضاءات رصد البنى الحضارية والثقافية لذلك الزمن، علاوة على استجلاء ما يكمن فيه من اختلاف في تفسير الأحداث التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والسياسية ومركزها السلطة، فثمة إشارة إلى قضايا خلق القرآن، كما ثمة أيضا إشارة إلى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يجتمع مع الكثير من العلماء الذين ينتمون إلى مذاهب متعددة أو متباينة، دون إقصاء أو نبذ، وبهذا تمسي هذه الشخصية جزءاً من معالجة جانب من جوانب قبول الآخر، كما مناقشة قضية تحريم القتل أو التكفير، وهي جملة من التأملات والبحث الذي كان يغشى الفراهيدي، حيث يمتلك أسئلته الخاصة على الرغم من أن جهوده بدت ذات طابع تقني.
نخلص إلى أن محمود جاسم اجترح نصاً ممتعاً من ناحية قدرته على توليد حكائية سردية، بالتضافر مع استلهام موضوع جديد، كما تمكين التاريخ ضمن الإدراج السردي السلس، غير أن الأهم أنه قدم رواية تفيض بجمل ثقافية ضمن بعدين: التوجيه الدلالي غير المباشر، وقوام ذلك توظيف شخصيات تاريخية أعيد تموضع قيمتها، وبيان أثرها، والانتصار لها، في حين يمكن أن نعثر على جملة ثقافية غير مباشرة تتصل بتكوين المثقف والسلطة، مع بيان بعض التّشوهات التي سكنت التاريخ، إذ بدت هذه الجمل جزءاً غير معاين من المقولة النهائية التي تحتاج إلى الكثير من التأمل، وإعادة المساءلة.
كاتب أردني فلسطيني

















