
«على ضفة نهر الأشياء» لأسامة إسبر: تأملات الأنا وتجليات الطبيعة
2022-03-07
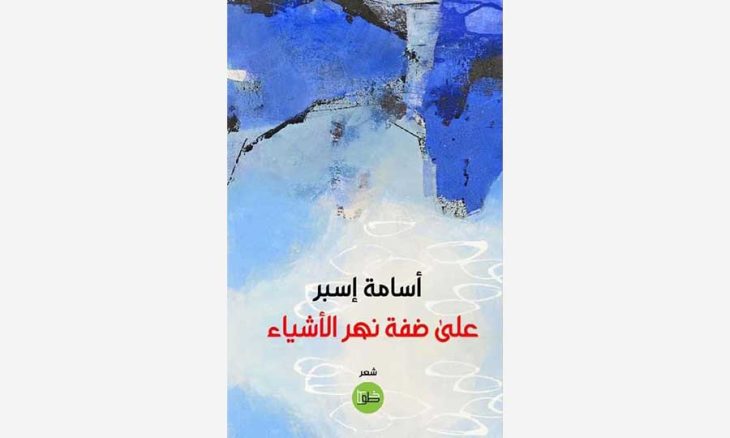
محمود أبوحامد
من عتبة العنوان إلى مدخل الديوان، مروراً بالفصول والسهوب والبحار، وصولاً إلى آخر سطر فيه، يبدو الشاعر أسامة إسبر وكأنه يمنح للتناص مع الطبيعة تعريفاً جديداً، ويتعداه من فهمه اللغوي المعجمي والاصطلاحي إلى وجوده التأملي والفلسفي والجمالي، في توالد يتدفق بين «أنا» الشاعر وتجليات الطبيعة بأشيائها ومكوناتها وكائناتها.. فعنوان الديوان «على ضفة نهر الأشياء» لم يكن: نهر الأشياء، أو ضفة النهر، بل ثمة حيز لتلك الأشياء وهي ضفة نهرها، وعلى هذه الضفة ثمة كائن ما.. (تنحني عيناي فوق ورقة عشب،/ ترتفعان إلى قّشة في الهواء/ تعومان في ماء النهر/ وتراقبان ظلالاً تجري على الضفاف/ هرباً من شمس ُمشرقة).
وتستمر هذه العلاقة بمكوناتها وخيوطها وأحداثها وتصوراتها ودلالاتها وأبعادها في جميع قصائد الديوان وعناوينه الداخلية وحكاياته وتداعياته، وآلية تدفق المعاني والرؤيا في قصائده وبين سطورها.. ويتم ذلك عبر تقص معرفي طازج ومباغت للذات وعلاقتها بكل ما هو خارجها.. علاقتها بالكائنات المهمشة وبالحياة بحركة الأشياء فيها وليس بروحها وحسب.. إنه نهر الأشياء الذي يعيش الشاعر معه وعلى ضفته، ليتعلم من انبثاق الضوء وصوت الريح وتفتح الزهر ونضوج الثمر.. أفكاراً ومعاني ومبادئ مغايرة، ويعلن الحرب على كل المبادئ والعقائد والمدارس، التي بنت بيوت عناكبها في دماغه.. يركض مع الظلال التي تجري وراء الأشكال الهاربة، يصغي لنبض الأرض وشرايين الينابيع تحت التراب.. يقرأ سطوراً من صفحات الماء والهواء والأضواء.. يكوّن أفكاراً تنحل خيوط كلماتها في ماء يتدفق أو زهرة تنمو أو عطر ينتشر..
في مدرسة الأشياء لا مرجعية للأشياء إلا ذراتها التي لا تتوقف عن الرحيل عبر الدروب، بينما في المدارس التي تعلم فيها الشاعر، كانت الأشياء نسخاً عن بعضها، وبدلة الفتوة تخنق عنفوان الشباب بأنشوطة التعاليم.. (ولعقود، كانت مقاعد الدراسة وجدرانها السرية/ أعشاشاً لطيور كلمات آتية من فردوس الشرود/ من أحلام يقظة تمحو ألوان الساعات البطيئة/ من أفكار متسربة من عوالم بعيدة في الباطن/ هدمت الجسور والطرق إليها).
كل قصائد الديوان تؤكد أن صاحبه لا يؤمن بالمسلمات، وهذا يعني أن ثمة مرجعية تؤمن بالبحث الدائم، وليس في علاقة الطبيعة بمكوناتها وكائناتها وحسب، بل في علاقة الأنا بالأنا وبالآخر، والأنا بالأشياء.
تقصّي الأشكال
أسامة إسبر الذي يؤكد في ديوانه أن الحياة في حركتها، ويمنح للأشياء روحها، يتقصى توالد تفاصيل التفاصيل، ولا يعيد تسميتها أو يكرر ظلال مرادفاتها، بل يمنحها أشكالاً متغيرة ومجازات متجددة، تعيدنا للدهشة منها وبها، وتدفعنا لتأملها من جديد، في تجليات الطبيعة الحاضنة لها.. بلغة جزلة وبليغة، واستعارات وكنايات وتشابيه جميلة ومذهلة، فنبات الفطر كأذن تصغي لضجيج المدينة، والضباب يسرّج المدينة كفرس، وأوراق تلجأ للرصيف هرباً من أعين الصقيع، الهواء حين يحرك ريش الطائر يفصّل له ثوباً جديداً، وفي أعين الأشجار الغيوم فساتين خضراء، وفي الشتاء الغيوم منازل للبرق والرعد.. ولا تتوقف البلاغة في وصف مكونات الطبيعة، بل في علاقة تلك المكونات ببعضها بعضا، وعلاقة الأشياء بالكائنات، كعناق قرني خرنوب، وتتعرى الأشجار في مخدع الخريف، والأصوات تنمو كالفطور على الألسن، والضوء يحط بجناحي فراشة على بتلة زهرة سوسن.. وأيضاً علاقة الطبيعة ككل بالذات الإلهية والبشرية.. (أيها الثلج/ يا حاكم المدينة/ أعشق منظرك حين تذوب/ كي يجلس غيرك على الكرسي/ لا سلالة لك/ ولا أجساد مدربة على الخضوع/ سلطة البياض التي تفرضها/ تعرف أن أوردة الينابيع/ ستغفر لها طغيانها/ أيها الثلج/ يا جنرالنا الشفاف/ أراك تمهد للربيع الزاحف بجيشه/ من الأعشاب والأزهار/ خارجاً من شقوقك الكريمة/ ومن سماواتك البيضاء/ الغافية على وجه الأرض).
وفي تناوله لأي طقس من طقوس هذه العلاقة يحيط الشاعر إسبر بتداعيات تشكلاتها إحاطة شاملة، تحرضنا على اكتشاف مكونات مغايرة لوجودها في مدارسنا ودفاترنا وذاكرتنا أيضاً.. ونرى ذلك في قصائده عن الطيور، وفي سبره لتشكلات الأمكنة وتتابعات الصوت والضوء والماء ورقص الفصول، وانزياحاتها الجميلة والغريبة، ورصده لما كانت ولما هي الآن ولما يمكن أن تكون، ونرى ذلك بوضوح في رصده للأضواء التي بدت كقطيع محنط والمدينة كمتحف لها، وبشدة الإضاءة وخفوتها ضوء شاحب، والشحوب لباس للمدينة، وثمة ضوء لعتمة أخرى.. لكن ماذا سيحدث لو اختفى هذا الضوء؟
(لو جفت أسلاكها/ كما تجفّ العروق المحرومة من الماء/ وفرغت كما تفرغ دماء الضحايا/ لا بد أن الأفق/ سيتحول إلى مقبرة أضواء مطفأة/ سرت قشعريرة في جسدي/ فحاولت التماس الدفء من تلك الأضواء/ التي تسري كإيقاعات غامضة/ في ظلمة الأشياء/ لكن البرد لم يغادرني).
من سمات هذا التقصي تسليط الضوء على الكائنات المهمشة، وإعادة تشكيل وجودها في أذهاننا بصور ووضعيات مغايرة، أكان ذلك بمشهدية ما، كتناول حمامة لدودة ميتة بين المارة، أو كالقفّاز الذي تجرجره أصابع الريح، أو كالشبح وعقب السيجارة.. أو في توصيفه لحالة ما، كالورقة الأخيرة على شجرة ظلت تتمسك بالغصن، كما لو أنه قشة في بحر السقوط، أو اللون الأخضر على ضفة النهر الذي يفيض عن الأعشاب باحثاً عن شيء يلونه، أو العناقيد المتدلية من الدالية، سماء سوداء حين يأتك جوهرها في كأس يوسع السماء الزرقاء.
البعد الفلسفي
كل قصائد الديوان تؤكد أن صاحبه لا يؤمن بالمسلمات، وهذا يعني أن ثمة مرجعية تؤمن بالبحث الدائم، وليس في علاقة الطبيعة بمكوناتها وكائناتها وحسب، بل في علاقة الأنا بالأنا وبالآخر، والأنا بالأشياء، ومفاهيم الشاعر، الذي ينتمي لمدرسة تفكير جديدة، حول الحياة والموت، والحنين والوطن، والغربة والاغتراب، وذاكرة الأمكنة وتبدلات الأزمنة، متكئاً على المفردات الجزلة بأبعادها الفلسفية الايحائية والجمالية، وعلى مجازات مفرداته التي يلامس بعضها الرموز الصوفية: (حين تدور في النقطة نفسها أو تدور بك النقطة/ حين يُحشر وجودك في نقرة زر/ حين تشتري سعادتك كم تُشترى وجبة جاهزة/ حين يكوُن الحُّب معلباً/ حين لا يتحدث إليك صوتك/ ولا تُصغي إليك أذنك/ حين لا تتعرف عليك عيناك في المرآة/ وتسير في الشوارع كرقم/ حينها سترى الشمس تغرب في القلوب/ والعتمة تعيش وحيدةً فيها).
قلما تخلو قصيدة للشاعر من «أناه» التي تتمظهر بوجودها بوضوح كضمير في جمله الشعرية وفي علاقة الذات مع الطبيعة ومكوناتها، وفي علاقته بالأمكنة والمدن التي عاش فيها والتي يتذكرها.. وقليلة جداً القصائد التي يستخدم فيها ضمير المخاطب أو ضمير الغائب.
والبعد الفلسفي التأملي يمنح للشاعر أيضاً آليات خاصة في تقصي وشائج المفردات بدلالاتها ومجازاتها، وإعادة النظر في كل شيء من جديد، أكان عبر المشاهدات اليومية، أو التداعيات الذهنية، ويتجلى كل هذا في طقوس تأملية صوفية تارة، وجمالية تارة أخرى: (كان صوتِك لغة أخرى تعرّفني/ تغسلني وتدفعني/ كي أولد داخل نفسي). وقد لا تكفي قصيدة واحدة لإشباع حالة من حالات تناول الشاعر لغرض ما، فيعود ليضيف عليها من جديد عبر قصيدة أخرى.. ومن الأمثلة عن ذلك تناوله للفردوس في قصيدة «خيمة العزاء» وقصيدة «الفردوس» وقصيدة «حيث يحيا الموت» وقصيدة «تراب أرضي» وقصيدة «على شاطئ بحيرة».. وقد تتكرر المفردة في عدة قصائد، لكنها تأتي مختلفة في سياقها ودلالاتها وجملها الشعرية، وهناك الكثير من المفردات كأمثلة على ذلك، مثل الريشة والضوء والثلج والريح والشجر..
وإن كانت سطوة الطبيعة تظهر في الديوان بوضوح، حتى في الحب والغزل، كما في قصيدة «وردة الحزن» لكن التأملات الفلسفية والوجودية التي تعبر بها، ومن خلالها تتجاوز تجلياتها في تناول الشاعر لقضاياه الفكرية والعاطفية والوطنية، وللكثير من «البديهيات» التي يصوغها للقارئ بطرق ومفاهيم جديدة، أو يلفت نظره إليها، أو يعيد لها اعتبارها كشيء كان مهملاً أو كنقطة للتداعي: (الجذع الخشبي المرمي على الشاطئ/ كان مرة يعيش مورقاً في شجرة/ لكنه يبدو بائساً الآن/ كأنه جثة مهاجر لفظها البحر/ أو نفي من غابة).
رسائلي وأمكنتي
قلما تخلو قصيدة للشاعر من «أناه» التي تتمظهر بوجودها بوضوح كضمير في جمله الشعرية وفي علاقة الذات مع الطبيعة ومكوناتها، وفي علاقته بالأمكنة والمدن التي عاش فيها والتي يتذكرها.. وقليلة جداً القصائد التي يستخدم فيها ضمير المخاطب أو ضمير الغائب.. وللشاعر رسائله الخاصة ورسائله المتنوعة، منها ما تحمل عناوين لقصائد مثل «رسالة إلى باب، ورسالة الربيع» ومنها ما هي ضد الحرب والخراب والدمار، ومنها رسائل موجهة للدفاع عن الحرية وعن الطبيعة، مثل قصيدة «ريش» أو لانتقاد ظاهرة اجتماعية ما، كما في قصيدة «اقتناء» ومنها ما هي موجهة للشاعر: (أتلّقى رسائل من المطر/ حين أكون ظامئاً/ ومن الحّب/ حين أكون عاشقاً/ ومن اللغة/ حين يُضنيني الشغف/ ومن الريشة/ حين تستدرُج/ الألواُن عينَّي/ إلى غواياتِك).
وللشاعر أمكنته التي عاش فيها وزارها، أكان في الوطن أو في المهجر بين مدريد وشيكاغو، وله رصده للمدنية ومتابعة تطوراتها العلمية والتقنية والبيئية، والصحية أيضاً: (يسير البشر واضعين كمامات على وجوههم/ نظراتهم قلقة/ ثمة شيء ما يتربص بهم في الخارج/ لكن في الأعين نفسها وهج/ لا يمكن أن يطفئه أي شيء). كما وللشاعر أمكنته الخاصة التي يحب، كالحدائق والمتاحف والشواطئ.. تقاسمه الذكريات صورها، والحنين حزنها وفرحها، والغربة والاغتراب تداعياتها وتأملاتها.. كما في حديثه مع الفضاء الذي رأى لأّول مرة دموعاً على خديه، مقطّرة من لوعة في القلب. وقال له دون أن يمسحها: (لم أفكر يوماً بعبور الحدود/ أو باقتلاع جذوري/ كانت بلا تربة ملائمة «هناك»/ وكنت «هناك» متكيفاً مع الوهم/ لم يقل: الوطن/ قال: «هناك»!/ كم لو أن الوطن سراب في صحراء/ أو ذكرى قديمة).
وتظهر «أنا» أسامة إسبر في مرجعياته الفنية والتقنية واللغوية، فهو المصور الفوتوغرافي الذي يلتقط جماليات الطبيعة وأسرارها، وهو المترجم الذي في مخزونه اللغوي ثقافات متعددة، وهو المهاجر الذي تعرف على حضارات عدة وشعوب متنوعة وأمكنة متباينة بجغرافية روحها وفنونها المعمارية وطقوسها المختلفة.. (في حديقة الريتيرو في مدريد/ عداؤون يملأون مسارات الدروب/ أعين تتأمل تيجان الأشجار/ عدسات تشمشم ككلاب مربوطة بالرسن/ كي تصطاد طيور صور عابرة/ رؤوس مطأطئة / تحدق بالدروب أو بخطواتها/ أو ربما غارقة في صورة ما من الماضي).
كاتب وصحافي فلسطيني/سوري

















