
للسياب : «أنشودة المطر» أم «أغنية المطر»
2025-06-06
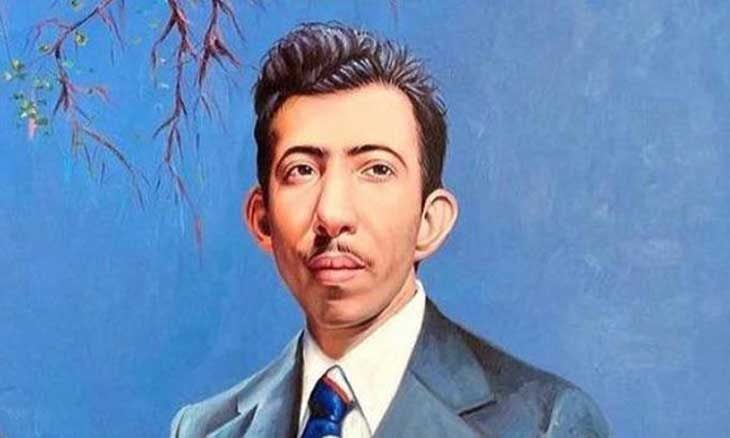 منصف الوهايبي*
منصف الوهايبي*
ليس من مقاصدي في هذا المقال، حضور الموسيقى موضوعا للقصيدة، أو توظيف إيقاعات اللغة، وهي ليست من الموسيقى في شيء؛ وإنما القصيدة مغناة وليس الأغنية المكتوبة خصيصا للغناء والترنم. ومثل هذه القصائد وهي التي تشرع الشعر على أفق غير الإنشاد، مراتب وأنواعا، ولها شأن في كل الثقافات، ومنها قصائد السياب وغيره من المعاصرين مثل محمود درويش أو نزار قباني خاصة. ولا نجادل في أن هؤلاء أو بعضهم، كان يحب لشعره أن يغنى، فيغادر «موسيقى الحجرة» وصمت اللغة، إلى الشارع وجلبة الناس؛ ويكون في الصميم من نسيج الحياة. غير أننا كلما أصغينا بقلوبنا وأسماعنا، إلى القصيدة مغناة، أدركنا أننا لا نسمع النص الذي شغفنا، وإنما ما لا يغنى فيه مكتوبا. ولا أخفي أن هذا هو شعوري وأنا أستمع هذه الأيام إلى قصيدة السياب الشهيرة «أنشودة المطر»، وغيرها من ديوانه هذا مثل «سفر أيوب» و»غريب على الخليج؛ في مقاطع منها بأصوات مطربين معروفين أمثال السعودي محمد عبده والعراقي سعدون جابر واللبنانية أميمة الخليل؛ ولعلها الأقرب إلى عالم السياب؛ إذ تجري القصيدة على لسانها بسلاسة مذهلة. ومن غير خوض في «قيمة» هذه الألحان، وأعرف أن البعض من أهل الموسيقى يستهجنها؛ ويراها أقرب إلى «الإنشاد» منها إلى الموسيقى:
عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السَحر
أو شُرفتانِ راح ينأى عنهما القمر
عيناكِ حين تبسِمان تورِقُ الكُروم
وترقصُ الأضواء كالأقمارِ في نهر
يرجُه المجداف وهناً ساعة السَحر
كأنما تنبضُ في غوريهما النجوم
أشير إلى أن من الشعر قديما وحديثا، ما يمكن أن يحمل على هذا النوع من الموسيقى التي هي أقرب إلى ما كان يسميه ميخائيل نعيمة «الشعر المهموس»، مثلما يمكن أن يحمل على نوع من الهذر والتخليط والوسواس، بمصطلحات العرب القدماء. وكانت حجتهم لذلك، وهم الذين لم يطالبوا الشاعر بأن يكون صادقا؛ أن الشعر عند أهل العلم به هو «حسن التأتي، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن يورَد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه؛ فإن الكلام لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف».
أشير إلى أن استخدام اصطلاح الموسيقى، في سياق الكلام على الشعر، لا ينهض له سند لا من هذا ولا من تلك. فالموسيقى فن قائم بذاته، وهي التي تنزع إلى وحدة الشكل والمحتوى. على أن ما يسوغ هذا التأتي هو اللغة نفسها فهي تحوي كلمات ذات طاقة استعارية؛ الأمر الذي يتيح لها أن تنتقل من مجال الى آخر، فيتعدد إجراؤها ويتنوع. ونقدر أن «سيولة» الكلمة، أو «ماء الشعر» أو «مائيته» بعبارة القدماء، ترجع إلى ذاتها، أي إلى وفرة معناها وغناه، مثلما ترجع إلى سياق استخدامها أو إجرائها. فهي تشهد لوحدة «جوهرية» ما، أو تجاوب بين مختلف الفنون التي كثيرا ما تصنف في سجلات حسية متمايزة، وهذا مما يسوغ احتكامنا إلى جهاز تحليل «موسيقى» بالأساس؛ يُضاف إلى ذلك أن في الإنشاد موسيقى وأن الإنشاد نوع من أنواع الغناء. غير أن الاصطلاحات الموسيقية التي يمكن أن تنضوي إلى سجل فن مثل الشعر، تحتاج إلى كثير من حسن التأتي، مرده إلى تكافؤها المتعدد. وقد يفيدنا هذا التكافؤ في إدراك الفروق بين مختلف استعمالاتها، أكثر مما يفيدنا في معرفة وجوه الشبه بينها. من ذلك كلمة «نغم» بسائر مشتقاتها مثل «تنغيم» و»تناغم»، وكلمة «لحن» فاستعمالها العروضي يختلف عن استعمالها الموسيقي. والتناغم صفة وقيمة ترجعان إلى القوانين اللغوية الصوتية في تجميع الكلمات وتسويتها، وفي ضبطها وتوازنها. ومصطلح «قصيد» أو نشيد»، يدل على نوع موسيقي؛ أو هو ينضوي إلى مدار الموسيقى، والقصد من إنشائه إنما هو إنشاده، فالقصيد يعد لينشد، أو كما يقول سيبويه: «الشعر وضع للغناء والترنم».
وقد يحتج البعض بـ»الموشح»، ففيه يتلاقى الشعر والموسيقى والغناء، لكن ما يغفل عنه بعضنا أن الموشح «أغنية» وليس قصيدة بالمعنى الذي استتب للقصيدة في نظرية الشعر عند العرب. وثمة اليوم علم مستحدث تختص به الأغنية «الكانتالوجيا»، كنت أشرت إليه في مقال سالف عن «أحن إلى خبز أمي»(محمود درويش ومارسيل خليفة)؛ وهو مصطلح لا أعرف له مقابلا في العربية؛ واقترحت له «علم الغناء»، أو «الإنشاديات» أي مباشرة الأغنية، من حيث هي جنس أدبي فني قائم بذاته. صحيح أننا يمكن أن نفيد من الموشح في إعادة ترتيب علاقتنا بـ»القصيدة/ الأغنية»، سواء من حيث معجم المصطلحات، أو من حيث الموسيقى والإيقاع؛ وكل ما يسوغ البحث في نشأة هذا الفن، والاستفاضة في المؤثرات التي اكتنفت وضعه؛ وفي معضلة أوزانه. وكان ابن سناء الملك (القرن 12 م) أول من طرحها. ثم تلقفها واستدرك عليه، المستشرق الألماني هارتمان (القرن 19 م)، فالإسباني كورينطي، فسيد غازي، فسليم ريدان الذي يقدم أطروحة «جديدة» أساسها رهان معرفي منه، على ضرورة الربط بين الشعر والموسيقى. ومسوغات طرحه، إن المصطلح النقدي المخصوص بالموشح، يحفه غموض غير يسير؛ بسبب انتمائه إلى نظرية عمود الشعر، وعروض الخليل؛ إي إلى مجال غير موسيقي. والموشح ـ باستثناء الموشح الشعري، الذي هو أقرب إلى القصيد منه إلى الأغنية ـ «كان ثورة صامتة على الشعر» بعبارة الباحث، ولا ينتظمه أي وزن من أوزان العرب المعروفة، وحتى المهملة. وعروضه ـ إذا جوزنا لأنفسنا هذا المصطلح ـ ألحان موسيقية مصطفاة صاغتها ثقافات البحر الأبيض المتوسط، وتحديدا ثقافة الأندلس التي كانت مثاقفة تشكلت في سياق تاريخي مخصوص؛ إذ لم يواجه الإسلام نظما فكرية راسخة كانت لها سطوتها، مثل فلسفة اليونان وعلومها، أو آداب فارس وحكمة الهند. وإنما وجد المسلمون، كما يقول موريس لمبار، رواسب من حضارات وثقافات كانت تشكل «نمط حياة»، أو «أسلوب عيش»، لها أنساقها المعرفية لا شك. بيْد أنها لم تشكل عائقا يذكر في مجال الإبداع الفني، لارتباطه باليومي والمعيش الحي.
ونحن نعرف أن من القدامى من ذهب إلى أن علم العروض وجد قبل الخليل، وأن الخليل تأثر فيه بآداب الأمم الأخرى (العروض الهندي السنسكريتي)؛ فما بالنا بالموشحات التي ظهرت في بيئة كانت تخالطها عناصر وأمشاج، من مكونات عربية وغير عربية. والخليل ـ على ما يبدو ـ وضع علم العروض ليقيم حدا فاصلا بين أوزان مأثورة وأخرى مهملة مستحدثة. وكان لهذا الحد أثره في وضع حد آخر بين شعر مأثور وشعر محدث. وشاع تعريف لعلم العروض مغلوط أو هو غير دقيق، فقد أقر بعضهم أن «العروض علم يعرف به صحيح الشعر من فاسده». وكان أصوب لو قيل يعرف به صحيح وزن الشعر من فاسده. ولا يخفى ما بين التعريفين من فرق بين، فربما صح الوزن وفسد الشعر؛ وربما فسد الوزن، وصح الشعر. ذلك أن الوزن قد لا يكون المدخل الأنسب إلى شعرية النص، أو بلاغته أو إيقاعه، وأمره من أمر «التدلال»، أو ما يصنع الدلالة والمعنى.
ولم يكن بالمستغرب أن أدار كبار شعراء العربية من القدامى والمعاصرين، قصائدهم على بحور مثل الطويل والبسيط والكامل والوافر والخفيف. لكن مزية السياب في «أنشودة المطر» أنه استطاع بشعرية لافتة أن ينقل الرجز إلى مثل هذه البحور، التي استغرقت أكثر الشعر العربي القديم. وما نظن ذلك إلا لعلة إيقاعية، فهذه البحور ذات الإيقاع الأصيل أو التفعيلات الرئيسية، كما يسميها المستشرق فايل، هي السبب في ثبات النغم الصاعد أو «جوهر الإيقاع»، أي الوتد المجموع الذي لا يصيبه زحاف، ولا تصيبه العلة إلا في عروضه، أو ضربه أي في موضع القافية. وهذا تقريبا ما أفلح فيه السياب وهو يحرر «الأرجوزة» من نمطيتها الإيقاعية، ونزوعها إلى النثر أو ما يشبه النثر. فـ»أنشودة المطر» ذات إيقاع خاص بها يختلف عن جوهر الإيقاع الصاعد في القصيدة. ومن الملاحظ أن أكثر البحور دورانا في الشعر القديم، هي تلك التي تتكون من تفعيلتين، وفيها يأتي جوهر الإيقاع بعد مقطع واحد كالطويل، ليعلو بالنغم في أول البيت ويستمر صاعدا حتى نهايته؛ أو كالبسيط بتفعيلاته القافزة خافتة الوقع. أما البحور قليلة الدوران فتتميز بإيقاعها الهابط أي الوتد المفروق المكون من مقطع طويل منبور يتلوه مقطع قصير. ولعل هذا مما زهدهم فيها. ومن المفارقات الشعرية عندنا أن شعراء «التفعيلة» منذ البدايات هم الذين أعادوا الاعتبار لهذه الأوزان مثل، الرجز والخبب، أو المتدارك أو المتقارب. وأمثلة أكثر من أن أسوقها في هذا الحيز.
*كاتب تونسي



















