
الشعرية بما هي إنتاج للنص وتأويله: تحولات التجربة الشعرية عند محمد بنطلحة
2024-02-16
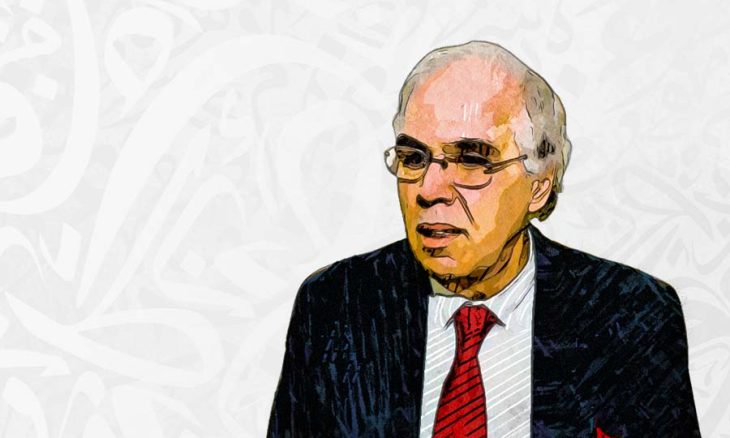
عبداللطيف الوراري
تجارب كثيرة ومتعدّدة خبرها المتن الشعري المغربي الحديث والمعاصر، ولكن ما أقلّ هذه التجارب التي أضافت إليه وأحدثت رعشة حقيقية في أضلاعه البلورية، وفي طليعتها تجربة الشاعر محمد بنطلحة.
فابتداءً من رؤى في «موسم العوسج» (1970) وليس انتهاءً بـ«سأنتظر أن يتنفس البرنز» (2022)، ظلّ الشاعر يُطوِّر مشروعه الشعري بـانتباه وأناة، خارج ادّعاءات النظرية وذائقة التلقي السائد، بقدر ما كان يراقب سياسات الفعل الكتابي داخل هذا المشروع، بموازاة مع اشتراطات الوعي الحديث الذي أدمجه – بقوّة- في قلب ممارسته الشعرية، التي نتعرّف من خلالها على أوضاع الدال النصّي بعناصره التبادليّة؛ الذات والمعنى والإيقاع، التي لها علاقة مباشرة بترتيب صيغ المتخيل واشتغالاتها في الخطاب الشعري وعبره، من النزوع الملحمي الرؤيوي إلى مساءلة الهوية الشعرية قياساً إلى رهان المغايرة والاختلاف بشكل دائم.
بنية تأسيسية
في كتابه «شعرية القصيدة المغربية: بحث في البنيات الشكلية والأكوان الدلالية»، يحاور الشاعر والباحث محمد عرش تجربة محمد بنطلحة الشعرية، ويرصد من خلالها التمفصلات الكبرى التي طبعتها منذ سبعينيات القرن العشرين، وبالقدر ذاته يريد أن يردّ الاعتبار لشاعر أساسي في خريطة الشعر المغربي الحديث، ليس بوصفه أحد أبرز مجايليه من شعراء السبعينيات وحسب، بل كذلك بوصف شعره ما زال ذا راهنية؛ بحكم الإضافات النوعية التي قدّمها، والتي ما تزال في الغالب مكبوتة تحتاج إلى من يبحثها ويلقي عليها ضوء المعرفة بالشعر وأسئلته الجديدة.
قبل أن يسائل شعرية محمد بنطلحة ويتتبعها عبر سيرورة تطورها، ومن أجل أن يستشكل دراسته الحالية، يعود الباحث محمد عرش إلى وضعية الشعر المغربي الحديث في سياقاته التاريخية والسياسية والسوسيوثقافية، ولاسيما وضعية الانتقال المرحلي من جيل الستينيات إلى جيل السبعينيات، متوقّفاً عند أبرز الدراسات النقدية التي ناقشت هذه الوضعية من منظور أو آخر (تاريخي، سوسيولوجي، بنيوي تكويني..)، وهي في غالبيتها لشعراء مجايلين تقدّموا بها في شكل أطاريح جامعية: محمد بنيس في «ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب» (1979)، وعبد الله راجع في «القصيدة المغربية المعاصرة: بنية الشهادة والاستشهاد» (1988)، ومحمد بنطلحة في «قراءات نقدية للشعر المغربي المعاصر: تحليل وتقويم» (2010). يُجمع هؤلاء الشعراء النقاد على أن الحداثة في الشعر المغربي بدأت مع جيل الستينيات، إلا أن هذه الحداثة، في نظرهم، وحسب المصطلح النقدي عند هذا أو ذاك، عرفت تعثُّرات في مراحلها الأولى، أو غلّبت ما هو وطني وأيديولوجي على ما هو جمالي فيها؛ فإلى جانب «الانبهار بالشرق» و»طبيعة الصراع الطبقي» وما واكبه من أحداث مفصلية على الصعيد الوطني أو القومي أو العالمي (المقاومة والنضال من أجل التغيير، نكسة 1967 وصعود المقاومة الفلسطينية، انتفاضة مايو/أيار 1968 في باريس..)، و»بنية السقوط والانتظار» التي تحكمت في الطابع العام للمتن الشعري الستيني، إلا أنّه لم تكن هناك رغبة صريحة في «قتل الأب» إبداعيّاً، أو إحداث قطيعة مع هذه المرحلة الشعرية، بقدر ما كان العمل يتجه إلى تثمين «النماذج الشعرية»، التي أخذت تظهر منذ أواخر هذا العقد، والإضافة إليه من لدن شعراء الجيل السبعيني عبر تدشين بنية شعرية جديدة لها «طابع التأسيس والمواجهة». ورغم أنّ معظم شعراء هذا الجيل أعادوا إنتاج ما سبقهم من شعر، وانخرطوا أول الأمر في موضوعات الالتزام الأيديولوجي والاجتماعي، إلا أن الرؤية الشعرية خضعت لصالح الاهتمام بـ»العلاقات الداخلية للقصيدة»، ابتداءً من أواسط السبعينيات. وفي المقابل، كان أحمد المجاطي؛ أحد مؤسسي القصيدة الستينية وعرّابها الأبرز، ينظر إلى ما يحدث باعتباره «مروقاً»؛ فالصراع كان محتدماً بين جيل الرواد والجيل الجديد، ويحاول كل فريق أن ينفي عن الآخر ما يريد أن ينسبه إلى نصّه في أمور الشعر وحداثته.
شعرية محمد بنطلحة
منذ أواخر الستينيات بدأ يبرز بعض الشعراء الذين سيأتلف معهم عقد الجيل السبعيني، وكانوا لا يزالون طلبةً في كلية الآداب في فاس، وكانت نصوصهم الشعرية ممهورة بـ»ظروف محلّية» تدور بين جدران الكلية والمطعم والحي الجامعيين، ثم انضمّ إليهم البعض الآخر من مدن وهوامش مختلفة، فتوسّعت الحركة الشعرية لجيلهم الذي أخذ يباعد – جماليّاً- بينه وبين الجيل السابق. وضمن هؤلاء الشعراء الجدد، لفت محمد بنطلحة نظر النقاد إلى شعره وتفرُّده فيه، ومن جملتهم عبد الله راجع، الذي وجد في نصوصه «تلك الصورة الجيدة القادرة على الإشعاع داخل النص»، وحسن الأمراني الذي اعتبره واحداً ممن ساهموا في «تأصيل أسس الشعر المغربي المعاصر». وفي المقابل، انتقده آخرون وآخذوا على شعره طابعه الاختلافي.
إنّ أي شعر جديد ومختلف، في تاريخ الثقافة قديمها وحديثها، كان في الغالب محطّ خلاف بين النقاد والدارسين، كما هو الحال بالنسبة إلى شعر محمد بنطلحة. ولهذا يعود الباحث إلى إعادة تقييم هذا الشعر واستكشافه من منهج ملائم ومتعدد المداخل، إذ وجد في الشعرية ما يسمح له بدراسة أبعادها النصية والجمالية المختلفة، لغويّاً وإيقاعيّاً وتخييليّاً، وما تشتمل عليه من مضمرات ثقافية وأسطورية وتاريخية تساهم في بناء العمل الشعري داخل بنياته الشكلية وأكوانه الدلالية والرمزية، من جانبين يجتمعان في جسد واحد: شعرية قصيدة التفعيلة، وشعرية قصيدة النثر، دون الوقوع في تغليب جانب على آخر؛ لأن ما يهمّ الباحث هو الكتابة الإبداعية وما طبعها من تحولات فنية، ميّزتْ هذا النمط من الشعر أو ذاك.
ينطلق الباحث محمد عرش في تحليلاته النصية من شعرية اللغة باعتبارها المنبع الرئيس لمكونات الشعرية، بسبب ما تفترضه من كثافة لغوية على الصعيد الصوتي أو التركيبي أو الدلالي، وما ينتج عنها من تحولاتٍ تمسُّ البناء المقطعي– الفيزيائي الخالق لـ»شعرية الإيقاع»، ثم السرد وما يحققه ضمن آليات اشتغاله من أبعاد تخييلية في علاقتها بالبلاغة وتشكل الصورة وتحويلها إلى رموز وتمثلات نفسية وفكرية وثقافية، على نحو ما يفتح التجربة برمّتها على أفق شعرية الكتابة كإبدال ومشروع فعل يتأسس باستمرار. فهو يتتبع آثار هذه الشعرية في مصادرها، وسيرورة تحوّلها، وما تضيفه أو تعيد دمجه في بنية الخطاب، لاسيما أنه يتجاوز حدود الجملة وحدود النص إلى المتن الشعري بكامله. يقول: «لأن أهمية المتن، والحرص على تنسيقه، تساهم في تقوية عملية التفكيك، بين الغياب والحضور، والأثر الذي تبقيه النصوص، وتقود إلى توضيح الاختلاف، وإعطاء الأهمية للهامشي، دون الاقتصار على الأصل». من هنا، يعود إلى دواوين الشاعر التي توالى صدورها منذ أواخر الثمانينيات، ويتوقف عند كل ديوان من خلال ثيمة مركزية، أو خاصية بارزة، أو قصية مهيمنة؛ مثل: الإحالة على ضمير المتكلم في «نشيد البجع» وتردادته المرجعية والرمزية، وتوظيف الخطاب الميتاشعري الذي يسعى إلى إدخال بعض البيانات والمصطلحات الإبداعية لكشف سيرة الذات وسيرة القصيدة، كما في «غيمة أو حجر»، وفي «سدوم» بحث ما يسميه «دراما التطهير» (السياسي، الأيديولوجي والثقافي) وما يترتب عنها من صور ومفارقات صادمة تتخفف من الزوائد، في ما هي تخلخل أفق الانتظار، وفي «بعكس الماء» اكتشف فنوناً أخرى (لوحات، سينما، مسرح..) لمؤازرة شعرية السرد، وفي «قليلا أكثر» وجد أن الشاعر يعيد تسمية عناصر الطبيعة ويطلقها في فضاء فلسفي ووجودي وسريالي يستدعي المهمش والمنسي، وبالتالي يدخل اللغة وتشكلها المعماري في امتحان جديد على صعيد التكثيف، والتفضية، واللامعقول، والسخرية اللاذعة، بلاغة الفراغ، قلب ثنائية الدال والمدلول، إلخ.
انفتاح وتأويل
بناءً على فرضيات محددة يمثل مفهوم الشعرية أساسها النظري المتين، يعتمد الباحث منهج الشعرية ضمن شبكة مفاهيمه وتصوراته المعرفية التي مثلت تحوّلاً في تاريخ نظرية الأدب، سواء في قديم الثقافة (أرسطو، قدامة بن جعفر، عبد القاهر الجرجاني، حازم القرطاجني..)، أو في حديثها (الشكلانيون الروس، رومان ياكبسون، تزفيتان تودوروف، جان كوهن، كمال أبو ديب، محمد مفتاح..)، كما يفيد من قضايا الشعرية التي غدت حقلا منفتحا على مناهج ومعارف مجاورة (التداوليات، نظرية التلقي، شعرية الإيقاع..)، فلم تعد تحصر نفسها فقط في البحث عن القوانين الداخلية لتحديد أدبية النص، بل فضاء لتقاطع محافل أخرى (القارئ، النص الموازي، التفاعل النصي، شعرنة السرد، التخييل) تساهم بطريقة أو بأخرى في إنتاج المعنى والتدليل. من هنا، يتوقف الباحث على دراسة التجربة الشعرية في عبورها من قصيدة التفعيلة إلى قصيدة النثر، مع ما يفترضه ذلك من تمايز نوعي بين نصوص المرحلتين؛ حيث أنّ لكل ديوان خصائصه الشكلية والثيماتية ضمن سيرورة تطور التجربة برمّتها على محوري الاتصال والانفصال، وما لهذا أو ذلك من أصالة أو قيمة في استكشاف نوازع الذات، وتوليد معنى جديد، أو تشييد هوية جديدة، أو بناء شكل جديد لكتابة مفتوحة. ويمكن أن نستخلص من هذه الدراسة، ما يلي:
ـ ضبط مفهوم الشعرية ضمن أبنيته المتنوعة (البناء التركيبي، الإيقاعي، الدلالي..) لإبراز مدى مساهمتها في شعرية النص وتفرده؛
ـ التركيز على شعرية الإيقاع التي تجاوز العروض إلى نظرية النظم وتعالق الكلم، على نحو يكشف اشتغالات النص الشعري ووظيفته الإيقاعية التي تعكس «موسيقى الذات الشاعرة»، سواء عروضيّاً (الانتقال بين البحور، تنويع القافية، التدوير تبعاً لحركة المعنى..)، أو تركيبيّاً (التوزيع، الالتفات، هندسة البناء..)، أو دلاليّاً (التسريد، التضاد، الانزياح..)؛
ـ تثمين شعرية السرد عبر التذكر والاستعارة التي تعيد بناء عناصر الذاكرة وتخلق «تنويعات تخييلية مطبقة على الواقع»، مثلما تعمل على شحن الجمل التعبيرية وربطها ببعض عناصر السرد من قطع وتدوير ودمج، للحفاظ على انسيابية الجملة أو المقطع، واندماج ذات الشاعر بذات السارد مع ما يفرضه السياق من تعدد في الضمائر وأزمنة الفعل، أو من اختلاف في تكثيف الزمن النصي- النفسي وتسارعه؛
ـ ربط الشعريّات (شعرية اللغة، الإيقاع، السرد، المتخيل) بعضها ببعض على نحو يكشف الفروقات ما بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، ومن ثمّ يبرز جدلية الكتابة ورهاناتها القائمة على التأسيس، وتوسيع الفعل الشعري، وتخطّي ما هو مألوف واعتيادي من أجل بناء عالم جديد.
وإذن، فإن القراءة التي يقترحها الباحث هي، بهذا المعنى، تحاول أن تؤسس، وسط ركام القراءات، لأصالتها الخاصة، بما هي قراءة نصية وعبر لسانية في آن، تقوم على إثراء النص وتشرعه على مآلات التأويل.
كاتب مغربي



















