
بعد انقضاء أربعين سنة على عملٍ أوّل: بحثا عن خاتمة أضعف من تلك الجريمة المروّعة
2024-01-02
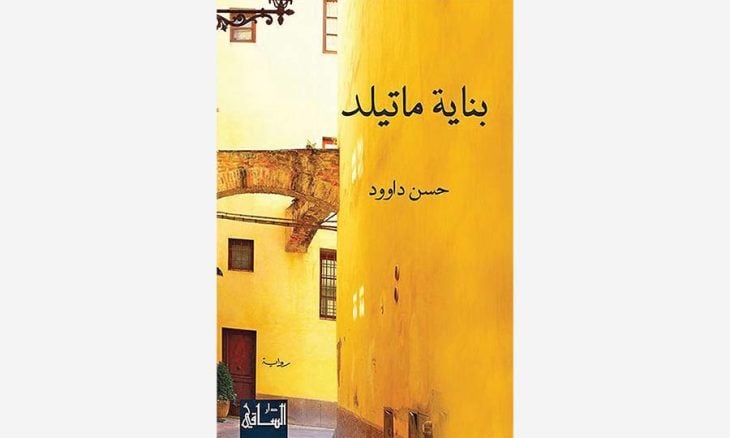
حسن داوود
لم يأخذني إلى كتابة روايتي الأولى مقتلُ بطلتها ماتيلد، وإن كانت تلك الجريمة قد روّعت بيروت آنذاك. صحيح أن الرواية انتهت بمصرع تلك المرأة، الساكنة في الطابق الثالث من البناية، إلى أن ما دفعني إلى الكتابة هو حنيني لزمن البناية العادي الذي كانت قد مرّ، آنذاك، عشرون عاما على انقضائه. امرأتان غير ماتيلد هما من كانتا تثيران ذلك الحنين: نبيهة الشيباني ومدام لور. منهما كنت أبدأ إنهاض الذكريات وإعادة إشعال تذكّري لهما في البناية، غاديتين رائحتين في التنقّل بين طوابقها.
حتى إن مصرع ماتيلد، وهو الذي ينبغي أن يكون أهمّ ما حصل للبناية في تاريخها، لم يكن كافيا لتنتهي الرواية عنده، أي ليكون خاتمتَها. بعض من قرأوها آنذاك كتبوا، أو قالوا، إنني قلّلت من أهمية هذا الحدث، وهذا صحيح، لأنني ربما لم أكن أريد، وأنا أصف تلك العلاقات التفصيلية بين الجيران، أن يطغى حدث بقوّة تلك الجريمة. وأذكر أنني حين كنت أُسأل آنذاك، أي من أربعين سنة، لماذا اخترت «بناية ماتيلد» عنوانا للرواية، كنت أعزو السبب إلى أن ماتيلد هي الساكنة الوحيدة التي ظلّت رافضة لوجودنا، وأحيانا كنت أقول بأنها كانت تتصرّف كما لو أنها مالكة للعقار وليست مجرّد مستأجرة لإحدى شققه.
رغبتي في الابتعاد عن الحدث الكبير، أو ما يمكن اعتباره الحدث الأول في العمل الروائي، يعود إلى أننا كنا نعيش في خضم أحداث تفوقه جسامةً. انفجارات ومواجهات ومتفجّرات وتهديد بمتفجرات أقسى وأعنف، ثم تصريحات وخطب وعقائد لا تقل قساوة وعنفا، كل ذلك كان خبزَ عيشنا اليومي، ما كنت أحلم به هو ذلك الزمن الأسبق، زمن الهدوء والطمأنينة، زمن مدام لور ونبيهة الشيباني وشجرات الكينا التي ترتفع رؤوسها وصولا إلى الطابق الخامس، حيث بيتنا.
لكن في زمن الحرب ذاك كان يرى المحاربون أن الانكفاء إلى الماضي، ودعوة الناس إليه ليس إلى ردّا عدوانيّا عليهم. أحسب الآن أن الاستقبال الذي حظيت به تلك الرواية يعود بعضه إلى التذكير بأن هناك حياة أخرى يعمل المتقاتلون على طمسها. كل تلك التفاصيل الواردة في الرواية بدت لهؤلاء خارجة عما ينبغي أن يكون مجال الكتابة، أي مقاربة الواقع الحقيقي. ذاك الذي، في رأيهم، تقتصر مراوحته على التنقّل بين الهزيمة والانتصار.
كنت أتساءل، فيما أنا أخطّ سطور «بناية ماتيلد» إن كان هذا الذي أكتبه روايةً. أعني إن كنت أقترب من إجادة هذا الفن، أما بناء الرواية الذي كنت أسعى إلى بلوغه فهو البناء العادي التقليدي. ولطالما شعرت، في أثناء ما كنت أكتب، بأني لا أنجح ولا أوفّق، حيث دائما كانت تلوح أمامي مسافة باقية بيني وبين إتقان أصول هذه الحرفة. حالي في ذلك كانت حالَ من يسعى للانتساب إلى ناد يضم محترفين وعليّ، لأكون مثلهم، أن أكتسب خبرتهم، أو أن أتّبعها، فقط حين صدرت الرواية جعلني قرّاؤها أدرك أن جودتها تكمن في تلك المسافة ذاتها، أي في اختلافها عن المعيار النمطي لفن الرواية، بل رحت أفكّر، بعد الاستقبال الذي حظيتْ به، أن هؤلاء القرّاء يرون فيها ما لا أراه. وأنني كتبت ما كنت غافلا عن إدراكه.
من ذلك مثلا تلك المقالات التي وصفتني، بعيد صدورها، بأني كاتب المكان، أو كاتبٌ عن المكان. لم أكن أعرف ذلك، ولا قاصدا له او منتبها إليه. كان على أولئك القائلين أن يرشدوني إلى ما كتبت، أي أن يوضحوا لي أنني كاتبُ ماذا. تلك النظرة الفريدة التي تأتينا كأنها من خارج وعينا بها، مدهشة ومربكة معا. ذاك أنها، بين ما تشير إليه هو، أنك لست كاتبَ نصّك، وأنك لا تعيه كلَّه. أما لماذا نرى أن هذا مربك فلأن هذه العناصر المتدخّلة في كتابتنا، أو التي تصنع كتابتنا، غير متحكَّم بها، وأنها يمكن أن تأتي ساعة تشاء وقد تذهب ساعة تشاء.
انقضى أربعون عاما على صدور «بناية ماتيلد» إذن، وما زلت إلى الآن، كلما سمعت مديحا لها من قارئ، أرجع إليها من أجل أن أعرف أين مكمن ذاك المديح. تلك القراءة، قراءتي لما كنت كتبت، لم توصلني إلى ما أريد معرفته. سأقرأها مرّة أخرى، أقول، لكن ينبغي عدم الإمعان في ذلك، خوفا من أن أفكّك ذلك الشيء الذي تصعب إعادة تركيبه.
«بناية ماتيلد» هي روايتي الأولى وقد صدرت في مثل هذه الأيام من سنة 1983، أي من أربعين سنة على التمام. الكلمات أعلاه ولدّها تذكر المناسبة.
كاتب لبناني



















