
فلسطين في «لون الروح» لصلاح الدين بوجاه: الهوية/ العنف
2023-12-16
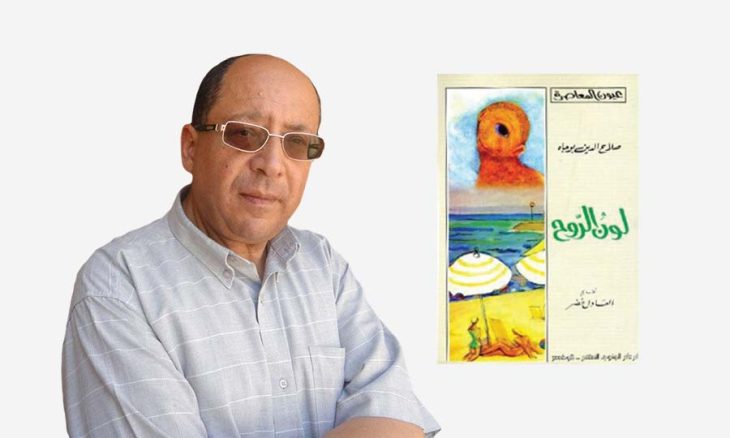
منصف الوهايبي
تتوزع «لون الروح» على ثلاثة فصول: «المنتجع قرب البحيرة» و«الشارع الفضفاض» و«غابة الأوكاليبتوس». وأولها وصف للفندق الذي «حدثت فيه مساخر كثيرة» تنقيبا عن لون الروح. هذا وغيره، إنما يرد بلسان السارد المتكلم الذي التحق بالعمل، وكلف بمراقبة النزلاء؛ من أجل حفظ الأمن، فقد تفجر في المدة الأخيرة، فندق كبير قريب؛ ووصل تيليكس يفيد بتسلل بعض الإرهابيين إلى المنتجع أو «فندق إبليس» كما يسميه أحد الأعوان. وبسبب ذلك، يشرع الأمن في تقليب الرمل، بحثا عن أي شكل من أشكال الحياة، قرب السجن الذي يقع في القلعة الكبيرة، أكبر سجون المنطقة، كما جاء في النص؛ ولعلها قلعة عكا الأثرية. وثم أكثر من سجين فكر في حفر نفق، تحت السجن رغم طول المسافة؛ إذ كان يعول على سهولة الحفر في الرمال. على أن الحراس انتبهوا، لكنهم تغاضوا؛ لإدراكهم أنه نفق لا يمكن أن يفضي إلى هروب المساجين. فكانوا يمسكون بهم، وينصبون لهم مشنقة في ساحة السجن، على بعد كيلومترات قليلة من الفندق.
ثم ينقلنا السارد في الفصل الثاني إلى لب الرواية، فـ»هذا بلد الطوائف.. البعض لا أجداد لهم فوق هذا التراب…» بل إن «أغلبهم أخذ يستنبط له أجدادا، وتاريخا وآثارا» وهي إشارة لا تخفى إلى اغتصاب فلسطين، ومحاولة تزييف تاريخها. وتتعزز هذه الإشارة، بانتقالنا من السارد الأول إلى سارد ثان هو كاتب «سائح» يقص علينا رحلاته إلى تل أبيب، ومستوطنات غزة حيث كان المستوطنون على وشك الرحيل: «جئت من لندن إلى تل أبيب، لكتابة رواية؛ ولم أكتبها حتى الآن».
يصف شوارع المدينة المتصالبة التي يؤدي بعضها إلى بعض، وفيها ألوان من الناس، ومشاهد القتل، حيث لا تقدم نشرات الأخبار سوى صور الضحايا من الفلسطينيين، والدم الذي بات عاديا مألوفا على الشاشات، والجسد المقطع المبتور، في دماره وتقطع أوصاله. ويخلص إلى أن «هذا البلد ليس إسرائيل.. لقد أحرجني عدم تصديقهم لي، وإصرارهم على أنها إسرائيل وتل أبيب». وندرك من حديثه وهو «مونولوج» أنه يهودي بريطاني، إذ يقول: «كنت أحاول كتابة شيء عن اليهود، لأنني إذا استطعت التعبير عن هذا الموضوع، ربما تمكنت من فهم شيء عن نفسي» والمسوغ لحيرته أن اليهود في فلسطين المحتلة أخلاط وأجناس، فمن هم إذن؟ وهناك يهودي إثيوبي أسود، ويهودي من رومانيا أشقر، ويهودي كان مسيحيا.. وما إلى ذلك من أجناس شتى. والاستنتاج الذي يخلص إليه أن جذور «العداء للسامية» وأسبابه، مردها إلى أن اليهود «يقودون الآخرين إلى الجنون، لعجزهم عن حل معضلة من نحن وما نحن؟» بل هو لا يتردد في نعت اغتصاب فلسطين فـ»هذه مجرد حركة طائشة من حركات التاريخ» إذ جاء المحتلون من كل أصقاع الأرض.. من أوروبا وافريقيا وأمريكا.. و»كل الشوارع مكتظة باليهود الدياسبورا».. جمعوا شملهم بعد ألفي عام «قائلين لبعضهم بعضا: هاي.. أتذكروننا؟ هنا ملتقى كل الجنسيات.. مسألة محيرة.. تدل على اللقيا بين البشر؛ لكنها في بعض وجوهها تعني التشتت والكثرة..» إنها شبكة معقدة من الحضارة واللغة والدين في تل أبيب ورام الله.. كما يقول هذا الكاتب القادم من لندن..»تخيل أن المستعمر الصهيوني والإرهابي العربي يعيشان ويتنفسان كآدميين». بيْد أننا لا نكاد نعرف «لون الروح» في الفصل الثالث «غابة الأوكاليبتوس» حتى ندرك أنها مسألة معقدة جدا تعقد هذا الصراع الدامي في فلسطين بين أصحاب الأرض، وهؤلاء المحتلين الوافدين من الشتات، وأن الحل لا يزال بعيدا، أو في دولتين، أو «دولة واحدة».. أو هو في طي المستقبل.
ومع ذلك فإن الحلم الصهيوني حلم مبتور؛ ماهيته جغرافيا لاهوتية تجعل من إسرائيل في المنظور الصهيوني دولة الصعود والعودة والتجمع وإعادة التكوين.
وهذا طرح زائف، لا سند له من تاريخ فلسطين؛ حتى إن قدمه الإسرائيليون، في سياق من أسطورتين متلازمتين نافقتين هما: أسطورتا التفوق والمؤامرة اللتان تقدمان لنا باعتبارهما قدرا لا يمكن رده، وكأنه ذلك القدر الإغريقي الغاشم الذي يترصد فريسته حتى قبل أن تولد؛ فهو ينسج خيوط مصيرها في زمن سديم، ويظل يتتبعها حتى يجهز عليها في اللحظة المناسبة. فلا جبل صهيون حتى بالنسبة إلى المسيحي، مملكة من هذا العالم. وهو تأكيدا لا يعني فلسطين. والجغرافيا اللاهوتية على ما يقرره بول ريكور في نص قديم له، مرحلة ألغاها تاريخ الأنبياء اليهود الروحي. وعليه فإن الماهية المؤسسة للوجود الإسرائيلي، ليست الماهية المؤسسة لوجود المسلم أو المسيحي، واعتبار إسرائيل نفسَها امتدادا لإسرائيل الذاكرة إنما سنده المخيال الديني، وليس التاريخ في كل الأحوال. أما الحلم الفلسطيني فهو على العكس من ذلك، إنما يعضد ماهيتَه التاريخُ والجغرافيا، ومنهما تستمد المقاومة الفلسطينية شرعيتها و«لون روحها». فلعل هذا ما يضيء العنوان «لون الروح» على ما فيه من الغرابة، أو حتى اللعب اللغوي؛ ذلك أن ما دأبنا عليه في تلقي الفنون عامة، أنها تقاس بمقياس الجمال، وبما توفره من لذة أو متعة، أو حتى من نفع وإفادة، أو ما يصطلح عليه عامة بـ«الجميل النافع». ومن حق المتلقي، مهما يكن نصيبه من الفن؛ أن ينشد من الأعمال الفنية الجمال القائم على امتزاج الفكرة بالصورة، أو ما يتراءى له أنه الحقيقة الحية الملموسة، أو أن يبحث عن الفنان في الفنان نفسه؛ وقد تملكته الأخيلة، واستأثرت به الاستيهامات، فلا يرى فيه سوى نوازعه الخاصة، أو ما يتوهم أنها بواعثه الدخيلة. فقلما خلا عصر من فنان يواجه العنف بفنه؛ وإن كان يخلع عليه أسماء تنتسب إلى العائلة المفهومية نفسها، ومن فروع شجرة أنسابها، نظير الطغيان والجور والظلم والجريمة، أو الإرهاب، أو كل فعل عنيف ماديا كان أو رمزيا. فالعنف مرتبط بالشدة والقوة والقسوة والغلظة واللوم والتحقير والشتم.
والعنف ليس ظاهرة جديدة، فإنه يسيطر على كل تاريخ البشرية، ومعها بدأ. أما هذا العنف الإسرائيلي المسلط على غزة، بكل وحشية وهمجية، فهو الصورة الأجلى لمظاهر البدائية والمتوحش في الإنسان، بل صورة من غرائبية البشر، أو هو تعبير عن السلطة الغاشمة عامة، وغضب إله العهد القديم، والآلهة عامة؛ على نحو ما نجد في صور الجحيم والقيامة في الكتب الدينية، أو تمثيل المسيح على الصليب، وما إليها. وفي «لون الروح» يحضر العنف بدلالات وهيئات شتى، وما يعتبره أحرار العالم عنفا وإبادة وانتهاكا صارخا لحقوق الآخر، تعده دولة الاحتلال من المآثر والمفاخر، في هذه الحرب على غزة، حيث نقف على الجسد الفلسطيني المقطع المفكك، الذي ليس بميسور العين أن تقيسه أو تستوعبه بيسر؛ وكأننا في فيلم «فرانكشتين» أو ما يشبه «مطبخا مأتميا» للأجساد المقطعة، أو الإنسان وهو يُمسخ حجرا، في زمن مجرم مخزٍ كهذا الزمن، حيث تتحول الهمجية إلى فرجة. لكن يظل بالإمكان التمييز بين الخوف من عنف حاضر يبلغ حد الرعب والفزع من نُذر المستقبل. وفي أي حال، نحن خائفون مما هو محتمل أو وارد أو متوقع أو مجهول، مثل محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة؛ في عالم يكاد يكون فيه المستقبل جزءا من حاضرنا القلق، بل إن الخوف والأمل أو الرجاء، بعيدا عن كونهما مشاعر متناقضة، كما يقع في الظن، يتعالقان في الشعور نفسه؛ فليس ثمة خوف دون رجاء، ولا رجاء دون خوف، لذلك لا غرابة أن يحضر الدين بقوة في هذه الحرب، وفي كل الحروب، فهناك ما يسمى بـ»جين الروحانيات» وهو الذي يهيئ الناس للدين، ويجعل كثيرا من البشر يولدون «مكبلين سلفا» بقوة هذه الشبكة التي تقود إلى الأديان. فثمة متلازمات من الخوف والصراع والهروب وما بعد الصدمة ؛ وهي تتضافر كلها في ضمان بقاء النوع والحيطة من كل خطر يتهدد الحياة، بل العدوانية عند البعض. والمشكل أن أسطورة الأصل والبدايات، وهي لب معضلة الهوية، تؤخذ عند المحتل الإسرائيلي الذي يتمثل بـ»العهد القديم» على أنها مسلمة أو حقيقة من حقائق التاريخ.
أضع الرواية جانبا، وأتساءل: ما لون الروح في فلسطين اليوم؟ ولا أظفر بجواب إلا في «أزهار فلسطين» الكتاب الذي حملته معي، من رام الله عام 2000، وأعيد قراءة المقدمة التي كتبها محمود درويش، وكأنها قصيدة نثر استثنائية، لأكتشف ثانية، أن كل زهرة في هذا الكتاب حديقة تحتفظ بسريرتها الحميمية، بل هي جزيرة خضراء في زحمة هذا الصراع الدامي، لكأني أراها الآن من مشبك، وأقول لعل الفردوس صُنع ليظل مسيجا؛ لا يسكنه أحد. غير أن فلسطين ليست الفردوس المفقود؛ ولن تكون صورة من الأندلس.
كاتب وشاعر تونسي



















