
الالتقاء بالذات في زمن الجائحةِ في قصص «كوفيد الصغير»
2023-12-08
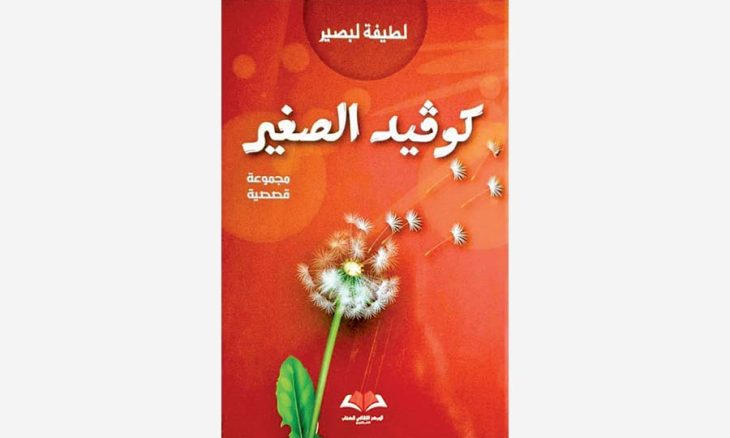
سعاد العنزي
علينا أن ننظر إلى كورونا، التي تهدد بالفتك الإنسان، بأنها نسخة معكوسة من رواية ويلز (الغزاة من المريخ)، الذين يدمرون الحياة على كوكب الأرض؛ إنهم نحن البشر! إذ نحن مهددون الآن بـ«أوضع ما خلق الرب على هذا الكوكب!»، فيروسات غبية تتكاثر تكاثراً أعمى، وتتحور.
لَما حدث زلزال لشبونة، عام 1755، وقُتل ما بين 60000 إلى 100000مواطن بريء، هز ذلك العالم الغربي بأكمله، فكرياً وإنسانياً وأخلاقياً، ودفع البشرية نحو أسئلة جوهرية مهمة، نقلت الفكر الإنساني إلى منحىً آخر، فبدأ الناس يطرحون أسئلة روحية مهمة ومصيرية: لِمَ يمت هنا آلاف البشر، في حين تشهد كل من باريس ولندن حياة الترف واللهو، فهل الله غاضب على لشبونة وحدها؟ ما يعني أن الفجيعة أصابت جماعة إنسانية دون غيرها. إنما، ما فعله السيد كوفيد 19 (كورونا) هو اجتياح جماعي كوني لكل البشرية، لا يميز بين عِرق ولون أو بلد، فهزم كل أسلحة الحرب التقليدية والحديثة، ليُظهر مهاراته الخاصة، وليسخر من كل تجار الحروب والأسلحة، ويشل الحياة الإنسانية كاملةً، ما أدى، وسيؤدي لاحقاً، إلى هزة فكرية أعمق وأشد نحو التفكير في طبيعة الحياة عينها، وخدعة صراع القوى العظمى، والصراع على الثروات، إذ بإمكان فيروس طارئ أن يجعل من الإنسان المقتنع جداً بسببية الحياة والمنطقية والعقلانية، غيرَ قادرٍ على ممارسة الحياة، ولا يمتلك شروطها الآنية.
لا ننكر حقيقة أن الفيروس ولّد أزمة ثقة بين المواطن الأوروبي وحكوماته التي تعد من القوى العظمى، إذْ في الوقت عينه ظهر أنها غير قادرة على التصدي لفيروس أو حماية مواطنيها منه، أو حتى إظهار القدرة العلاجية الاستيعابية لضحايا المرض، ما حسّن قليلاً من موقف الحكومات العربية في قضية اهتمامها بمواطنيها ورعاياها والحرص عليهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما يعطي المواطن العربي الثقة بحرص المؤسسات السياسية عليه، ما دامت قادرة على حمايته. هذه الأزمة من شأنها أن تدفع بالأمة العربية إلى التفكير في نهضة عربية تقوم على المعرفة والعلم والتطور، وتجعل من العلماء والمثقفين قادةً للمجتمع، ما يدفع إلى إعادة التفكير في مفاهيم وأسس التعليم التقليدي، واستبدالها بمفاهيمَ جديدةٍ، ومن ثم ضرورة تفعيل التعليم الإلكتروني في ضوء العالم الرقمي الذي نعيش فيه، والمستجدات البيئية غير المتوقعة. ومن جانب آخر فكري، لا بد من الالتفات إلى اهتزاز القيم الثقافية الصلبة والجامدة والمسيطرة على طرائق التفكير منذ آلاف السنين، فقد كان الإنسان يحارب في سبيل معتقدات وعادات وتقاليد بالية، ويدافع عن امتيازات عنصرية بغيضة لم تحمِهِ قط من الفيروس.
حقيقةً، أرى أن الأثر الأكبر سيكون في مجالات السياسة والاقتصاد والطب والعلم، وهو ما سيحرك على نحو من الأنحاء المجتمعات الإنسانية. إذْ، بعد هذه الأزمة، يتوجب على المجتمعات الإنسانية أن تقفَ وقفة واحدة، كمجتمع إنساني كوني واحد يواجه أخطاراً متعددة، دون اصطفاء إثنية واحدة أو جغرافية محددة. يعد الأدب، والسرد تحديداً، واحداً من المجالات الخصبة القادرة على مناقشة أي موضوع من موضوعات الحياة الإنسانية، وطرح الصور والرؤى الحادة التي تحلل وتشرح الظواهرَ الطارئة على المجتمع باقتدار شديد، مثل الأوبئة، بدءاً بالكوليرا ثم الطاعون… وصولاً إلى جائحة كوفيد 19، وهنا تبرز لدينا مجموعة «كوفيد الصغير» للكاتبة المغربية لطيفة البصير.
تتساءل إحدى المقالات عن وجود أدب كورونا، وهي للكاتبGabino Iglesias بعنوان: “Are we ready for COVID-19 as a central theme in literature?”: هل نحن حقاً مستعدون لإنتاج أدب كورونا الذي لم ندركه ونتعرفه بعدُ؟ حقيقةً، يُعد هذا السؤال سؤالاً مشروعاً، على وجه الخصوص، إذْ إن ثمة نصوصاً كثيرةً بالفعل قدمت للجائحة بطريقة تسجيلية مباشرة فجة، لكن مجموعة «كوفيد الصغير» تماست مع الجائحة بعين أدبية متمكنة وناقدة متبصرة، فاستطاعت أن تنجوَ بنصوصها من هنات الكتابة الاستعجالية. تحاول البصير أن تشرح هذا المرض بعين نقدية أدبية ثاقبة، وبروح الباحثة المطلعة الممتلئة بالشغف، فتتابع بيقظة كل ما يحدث من مستجدات، مثل الكاميرا، فترصد هذه اليوميات بفنية وكثافة عالية. ربما هذا ما جعل الكاتبة تسمي المجموعة القصصية بـ«كوفيد الصغير»، الذي تجعله بطلاً للقصة عينها، التي تحمل عنوان المجموعة نفسها، لأن تاريخ الوباء غير واضح المعالم بعد، ولم تفهم طبيعة هذا الضيف غير المرئي، وغير واضح المعالم.
تنهض مجموعة الكاتبة المغربية الأكاديمية والأديبة لطيفة البصير، على خمسةَ عشرَ نصاً، جميعها تشتغل على موضوع كورونا، أو كوفيد الصغير. كل قصة من القصص تبين تأثير الفيروس في أفراد المجتمع، في يومياتهم العادية، إذْ يلعب الفيروس دوراً مهماً في تشكيلها وإعادة بنائها، ويجد بعضهم في عزلة كورونا فرصة للالتقاء بالذات والانبعاث من جديد نحو حياة فُضلى، وهذه واحدة من وظائف الأدب في فتح نافذة للاستبصار والأمل. في فضاء نصي ممتلئ بالدلالات والإشارات والومضات الغنية، تصبح الأماكن المغلقة هي الأساس، وبمسار سردي يخالف فيه أبطال القصص مسارهم المعتاد، وهو الخروج والحركة والسعي نحو العالم واتجاهات الحياة المختلفة، فنجدهم يتجهون إلى العزلة، وللمرة الأولى يصبح المكوث في المنزل عملاً حكيماً من قِبل البشرية.
إن عزلة كورونا تحمل في أحد مضامينها المباشرة أنها عزلة مرضية ناتجة عن مرض قد يفتك بالبشرية ويعطل الحياة العامة، حتى إنْ لم يحدث هذا الخطر، فالإنسان اليوم مهدد بخطر التلاعب به بطريقة أكثر فتكاً من الأسلحة التقليدية والكونية، إذْ لم تعد مجرد كلمة تدغدغ مشاعر المنخرطين في شعارات القرية الكونية، بل غدت آلية لتصدير الأمراض والإرهاب والفيروسات الأكثر تحييراً للبشرية. وتبرز أزمة البشرية اليوم في أن الإنسان لم يعد يقبض على شيء. يقول سلافوي جيجيك في كتابه «الجائحة: كوفيد 19»: «إنني أخشى العيشَ في بربرية مقنعة بالإنسانية – عندما يجري فرض إجراءات قاسية ووحشية بنبرة الندم والتعاطف، وزفها مصحوبةً بآراء الخبراء والمحللين». لقد أوقف الفيروس حركة العالم، وتوقف معه كثير من الأشكال والممارسات التي اعتادها الإنسان، الذي افتقد اليوم روتينه اليومي، فانفتح أمامه مجال لممارسات جديدة، وتالياً عليه أن يعتادها ويتقبلها، فهي تأخذ حيزاً من وقته وممارساته. يبين سلافوي جيجيك في كتابه سابق الذكر، أنه ما قبل كورونا كان ينتظر وقت نومه بعد يوم حافل بالقراءة والكتابة، لكن بعد حدوث كورونا كان يخاف النوم والقلق الناتج عن كورونا. كما أشار إلى قضية أخرى تتمثل في أن هناك أشياء تشتغل على لا وعي المجتمع، والممنوع والمحظور، ويشير إلى أنه في الماضي كان ثمة كثيرٌ من الأشخاص، والمثقفين تحديداً، لا يخرجون من المنزل أو المكتب بحثاً عن وقت فراغ للقراءة والكتابة، لكن ما إن يضع المرء في ذهنه أن هذا الشيء ممنوع فإنه يتوق إلى تحرير ذاته، ويشعر بفقدان الحرية، وبرغبة ملحة في كسر الحظر. بقدر ما تحمل العزلة من مضامين خاصة بالأمن والسلامة، وأنها مكان عزلة مع كامل وسائل الرفاهية والترفيه، إلا أنها تحمل بين معانيها تقييداً في الحركة والتجوال خارج المنزل، ورؤية بعض مشاهد الحياة في الطرق والأماكن العامة التي هي جزء من حيواتنا. باختصار، مهما تعالى الإنسان على رغباته، تبقى الروح الإنسانية تحتاج إلى أن تمتلئ بكل ظواهر الحضور الإنساني، وهذا أبسط ما افتقدناه في زمن كورونا. هذا ما تحاول البصير قوله في نصوص مجموعتها؛ التماس مع قلق البشرية الوجودي، والبحث عن أمل يضيء هذه العتمة.
في حضرة (الإمتاع والمؤانسة)
تستدعي الكاتبة البصير في مجموعتها مجموعةً من الصور والرموز الثقافية، مثل استدعائها لشخصية أبي حيان التوحيدي، ومَي زيادة، والرسام لودفيغ دويتش، بطريقة تبين أن انشغالاتنا الجمالية والمعرفية لا تزال قائمة بهذه الرموز والشخصيات. كما تقول بطريقة مباشرة إن الالتقاء بشخصيات ورموز الماضي الثقافية قد يضيء عتمة الحاضر. ففي أول قصة بعنوان (إيماءة)، تربط بين شخصية البطلة مَي، ومَي زيادة، وتقارن بين حالتَي مَي البطلة ومَي زيادة، موضحة فكرة مهمة، وهي نقل النقاش حول الأعمال الأدبية والرموز الثقافية من حلقات الدرس الأدبي والأكاديمي إلى دائرة الحياة العامة ليصبح موضوعاً من موضوعات النقاش في الحياة العامة، ومن ثم تحليلها في ضوء تجربة مَي القاسية، فهل ستقاسي مَي الصغيرة مصيراً مشابهاً لمصير مَي زيادة، ولاسيما أن الأولى كانت تعاني مرضاً نادراً ومجهولاً؟
أما الصورة الثانية، فهي تبرز في قصة (عزلة لودفيغ دويتش)، إذْ تظهر صورة الرسام المستشرق النمساوي لودفيغ دويتش، الذي أفردت له الكاتبة كتاباً خاصاً، عنوانه (لودفيغ دويتش) يتحدث فيه عن تجربته ومعيشته في مصرَ، مستثمرةً هذه التفاصيل التي تشغل حياة البطلة بوصفها موضوعاً لاهتماماتها البحثية. تزور البطلة القاهرة باحثةً عن كل الأماكن التي تجول فيها لودفيغ، وكانت ملهمة له في رسم لوحاته، وهي لا تقترب من لوحاته بل تقترب منه ومن روحه التي تملأ المكان: «أشحت بوجهي عن الصور، وكأن يداً قوية أدارت وجهي جانباً، فلمحت من خلف الدموع لودفيغ دويتش في صورة مضببة، وتراءى لي وهو ينظر إليّ بابتسامته الخجلى التي تشبهني، وقد أمسك بكثير من ريشاته وأوراقه». فتقرر بعد ذلك عدم الرحيل عن القاهرة، المدينة التي تجمعهما معاً. وهنا تتضح صورة الفن الملهم في إيجاد الحلول، والوصول إلى مرافئ الذات.
في قصة (ثم زارني أبو حيان التوحيدي)، تستدعي الكاتبة عزلة شخصية أبي حيان التوحيدي، رابطة بين عزلته وعزلة بطل قصتها الكاتب، بحيث يخرج في نهاية القصة قوياً وقادراً على تجاوز العزلة. يتعجب البطل/ السارد منه، لأن أبا حيان التوحيدي كان سيد الشكائين في زمنه. أحرق الكاتب كتبه، كما فعل أبو حيان التوحيدي، متسائلاً عن جدوى الكتب والعلم والمعرفة والفلسفة، قائلاً: «هل كانت النفس هي باعثة هذا الألم؟ هل كانت سمية؟ هل كانت الكتب التي لا تضيف شيئاً؟ هل كان الآخرون الذين لم يعودوا يفتحون كتاباً؟ هل كانت الفلسفة قد صارت جلداً كئيباً في زمن آخر؟ هل كان الوباء قد نفذ إلى المسام وأنبأنا بأن كل الأهواء إلى زوال؟ هل كنت أنا الذي أضرم النار في هذا الضجيج؟». يأتي الحدث الصادم والكاشف في القصة؛ يكتشف البطل أن هناك سيدة قرأت أعماله وكتبه، وكتاب أبي حيان التوحيدي «الإمتاع والمؤانسة»، وأنه كان أول ما أنقذت من النار، موضحةً أنها شفيت من الاكتئاب بقراءة أعماله. ليس غريباً أن يكون العنوان (الإمتاع والمؤانسة) هو العنوان المنتقى، لحاجة الناس في وحشة العزلة إلى إمتاع ومؤانسة. يدهش الساردَ هذا الحدثُ، فيقول: «يبدو أن الكتب موعودة بمَن ينقذها، فكأنها تبعث برسائلها قبل أن تلتهمها النيران.. هذا غريب». وينبغي هنا الحديث عن حدث مهم في حياة التوحيدي، وهو إحراقه لما كان بين يديه من مؤلفاته، رغبةً منه في الانتقام من جميع الذين تجاهلوه، وتجاهلوا علمه وأدبه. يبدو أنْه ليست الكتب وحدها منذورة لمن ينقذها، بل حتى الكتّاب الذين هضمت الحياة حقهم في الشهرة واعتراف الناس بمواهبهم، مثل أبي حيان التوحيدي، يعودون مجدداً إلى عالم الضوء.
تلتقط رواية الناقد المغربي عبد الفتاح كليطو «والله إن هذه الحكاية حكايتي» هذه الحالة من التجاهل والإنكار لتفتح السؤال على أكثر من جانب: هل حقاً أحرق أبو حيان أعماله أو أنه لم يحرقها؟ وإذا كان حقاً قد أحرقها، فكيف وصلت إلينا؟ إلا إذا كان أبو حيان قد أحرق كتباً له أخرى لم تصل إلينا. هنا، يذكرنا بكافكا الذي أراد إحراق أعماله، لكن صديقه ماكس برود سارع إلى حفظ تلك الأعمال. وحال أبي حيان التوحيدي يشبه حال كافكا في عدم الانتشار كل في زمنه، إنما تم إنصافهما في أزمنة لاحقة لهما. بهذا نجد أن الكتاب، كما يبين مصطفى بوكرن، يعد بطلاً من أبطال الرواية، يحرك الأحداث وقرارات الشخصيات، مثل شخصية حسن ميرو، التي تؤجل قراءة كتاب «مثالب الوزيرين» خوفَ الشؤمِ الذي سيلاحقه من جراء هذا الكتاب. لقد مات أبو حيان التوحيدي غبناً وقهراً بسبب عدم الذيوع والاشتهار، في حين نجد الجاحظ يموت بسبب سقوط المكتبة عليه. إنما، في قصة (ثم) نجد أن الكاتب البطل، بطل قصة البصير، والمرأة القارئة بسبب قراءة أبي حيان التوحيدي، التقى كل طرف بالنص الآخر الذي يفهمه ويقرأ له، ويعيد الشغف إليه مجدداً.
كوفيد الصغير
في قصص عدة، تحفر الكاتبة معالم الحياة الاجتماعية متأثرة بكورونا وما أنتجته من رعب وذعر اجتماعي، مثل قصة (كوفيد الصغير). تبدأ القصة بحدث غريب، وهو إحضار الأب طفلاً صغيراً غريباً عنهم، مجهول الأبوين، يرتدي ملابس رثة. قد يبدو هذا الحدث عادياً في زمن آخر، لكن في زمن الجائحة سيكون هذا الحدث مضاعفاً في غرائبيته. بدأ التساؤل يدور حول هذا الطفل: مَن يكون هذا الطفل؟ ثم بدأ الحوار مع الأم، وهي أكثر الشخصيات رفضاً لوجوده بينهم. هنا، يبدأ الصراع يتطور في القصة متضحاً من خلال الحوار الدائر بين الأم والأب، ويزداد النقاش حدةً لأنه، كما تقول الأم وتؤكد أكثر من مرة: «أحضر كورونا تمشي على قدميها في المنزل». توضح المفارقة أن العالم يضج قلقاً بسبب أحداث كورونا، في حين نجد أن دخول الطفل الغريب المنزلَ يُحدث حالة من البهجة والسرور والطمأنينة لدى الأسرة، وهي ما نسجته الكاتبة في أغلب القصص، خلق حالة من الاستئناس في قلب أزمة كورونا والحظر الكلي.
الشخصيات
من خلال شخصية الطفل كوفيد الصغير، تجسد هيئة كورونا الغريبة المجتمع؛ طفولة الطفل تشبه تاريخ حضورها الفجائي العجيب، حالة لقيطة في العلم، مثل حالة الطفل اللقيط الذي لا يعلمون له أصلاً، فيبدو مخيفاً وغريباً، لكنه مضحك ومؤنس في الوقت نفسه، إذْ يجعل أهل البيت يتعايشون معه، ويعتادونه. هنا، تتضح دلالة عنوان القصة (كوفيد الصغير).
يبدو الأب كريماً، معطاءً، محباً للخير، مؤمناً بقضاء الله وقدره، ويحب مساعدة الآخرين. على قدر انبساطية الأب، تظهر شخصية الأم منقبضة، غاضبة، وقلقة بسبب خوفها من تبعات كورونا، أي الطفل الغريب. أما الراوي (الطفل) فيبدو كمتلق للأحداث، يشعر بمشاعر مضطربة، فيتأرجح بين أن يكون سعيداً بهذا الحديث الصغير، وأن يشعر بالتردد بسبب والدته. أما الطفل الضيف الغريب نفسه، فلم تصدر عنه أي حركة، وكل هذه الحركات والأفكار تأتي من قِبل الأسرة، وهي إشارة إلى كوفيد الذي ليست له ملامح ولا صوت، باستثناء أثره المخيف في الناس. تتضح صورة الأم، وهي صانعة صور وأساطير، بعين الابن، فنرى الأم سابقاً وقد كانت تختلق القصص لترعب ابنها؛ فهناك وحش سوف يبتلعه، مثلها مثل الشخصية المتخيلة عند الشعب الكويتي (حمارة القايلة). وحينما تأتي كورونا، ويضطر الجميع إلى العزلة في البيوت، تخيف الأم الطفل بهذا المخلوق الغريب. تبدأ الأسرة تعيش مع كوفيد بالألفة، وتطمئن إلى وجوده معها، فبات كأنه فرد من أفراد الأسرة، ونرى صورة المنزل في أمن وطمأنينة، أما الحي فيتحول إلى مثل صورة الوحش، التي رسمتها الأم بسبب جائحة كورونا. يبدو سبب تسميته بكوفيد الصغير أنه مرض جديد وغير مرئي، وغير معروف الهوية، مثل الطفل الصغير مجهول النسب.
ختاماً، استطاعت لطيفة البصير في هذه المجموعة القصصية أن ترصد تفاصيل عزلة كوفيد الصغير، مبحرةً في أعماق النفس الإنسانية، وتنسج مخيلات خصبة تحلم وتتأمل، فتصل في نهاية المطاف إلى حالة الإمتاع والمؤانسة التي ترومها شخصيات المجموعة.
كاتبة كويتية



















