
استعدْنا الأمل.. فقدناه.. لا. استعدناه مرة أخرى!
2023-08-31
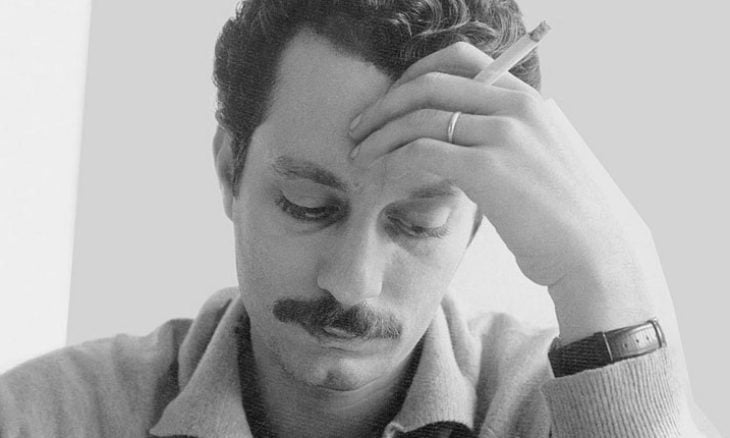
إبراهيم نصر الله
في ذلك اليوم التموزيّ من هذا العام، خرج معظم المشاركين في مؤتمر غسان كنفاني للرواية العربية مطمئنين أو شبه مطمئنين، بعد مناقشة مستقبل الرواية في ضوء التحولات التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، أمّا جمهور الحضور فلا يستطيع أحد أن يتنبأ بما دار في رؤوسهم، وقد بدأنا نقرأ عن صدور روايات وأعمال شعرية وفيديوهات وأغنيات تتم صناعتها في مختبره.
يمكننا القول إذًا إن هناك «صناعة روائية وشعرية» يمكن أن يُنجزها هذا الذكاء، حيث لا نستطيع أن نقول «كتابة روائية وشعرية»، تماماً كالمسافة بين لوحة من لوحات بيكاسو ولوحة من لوحات الذكاء الصنعي؛ اللوحة مثال دالّ هنا ربما أكثر من أي شيء آخر.
ذلك أمرٌ يمنحنا الأمل.
أتخيل كاتبًا عربيًا بارزًا يرسل إلى ناشره رواية جديدة عمِل عليها طويلًا، تحضيرًا وكتابة، والأهم حياةً، ويأتيه الجواب بعد دقائق من إرساله لها: «للأسف، عليك الانتظار ثلاث سنوات، فبرنامجنا حافل بعدد من الروايات الجديدة التي أنتجها معْملُنا الإلكتروني، وهي تلبي شغف الناس في هذه المرحلة، الشغف الذي درسه معْملنا أيضًا. وبالمناسبة، هل ما زلت مصرًّا على أن يكون لك حقوق تأليف، كما فعلت دائمًا في الماضي؟».
أو يتلقى شاعر، ممن تبقّى من شعراء على قيد الشِّعر (الحقيقية، حقّق الشعر العربي قفزات رهيبة وسبّاقة -في السنوات الثلاثين الماضية- في مجال الشِّعر الصنعي مع أن الذين كتبوه من لحم ودم، إلا أن قصائدهم لم تكن لا من لحم ولا من دم). حيث يتلقى هذا الشاعر رسالة تقول له: للحقيقة، نحن سننشر هذا العام عشر مجموعات شعرية أنتجت في معْملنا. وللأسف، تبدو حرارتها وجِدتها، وتنوّع قاموسها اللغوي، ودقة الوصف للطبيعة غير مسبوقة، كما أن الحبيبات في قصائد معْملنا تبدو الواحدة منهن أكثر فتنة وجرأة وهذا ينطبق أيضًا على قائل الشِّعر نفسه».
ضمن منطق السوق، هذا وارد تمامًا، بل وَرَدَ، فكثير من دور النشر تتسابق لأن تكون الأولى بتوظيفها لبشر، أو محققين، قادرين على اعتصار تجارب الذكاء الصنعي العاطفية! لإنتاج نصوص كهذه.
عمومًا، في عالمنا العربي ستظل رواتب موظف موهوب من هذا النوع أكثر من أيّ حقوق تُدفع للأصليين، ما دامت حقوق أي عاملة منزل تفوق حقوق كثير من الكتاب لدينا أيضًا، مع الاحترام الشديد لكل المهن على هذه المعمورة.
ذلك أمر يفقدنا الأمل.
الصديق الدكتور وسيم دهمش، الأستاذ في عدد من جامعات إيطاليا، ومترجم عدد كبير من الأعمال الفلسطينية والعربية إلى الإيطالية منذ نهايات الستينيات، حاولت إقناعه بترجمة كتاب لتاجر ودبلوماسي إيطالي يتحدث فيه عن فلسطين 18، ولأن ترجمة كتاب ليست مسألة سهلة، وتحتاج إلى وقت، ولا يعرف أين سينشر في عالمنا العربي، طلبت منه أن يرسل إليّ نسخة إلكترونية، فأرسلها، وخلال سبع دقائق أو أقل، أرسلتها له مترجمة إلى العربية!
صديقنا أرسل إليّ ضاحكًا: أنت أسرع مترجم في العالم.
كل ما حدث أنني أدخلت النسخة إلى برنامج ترجمة، وتمّ الأمر! صحيح أن النص غير دقيق، بل وكارثي في معظم أجزائه، لكنه يعطي فكرة لا بأس بها، وإن لم تكن موثوقة. هذا شجعني لإعادة ترجمة كتبي المترجمة إلى لغات أخرى إلى العربية، وكانت النتائج مذهلة، فـ «زمن الخيول البيضاء» التي يبلغ عدد كلماتها بلغة أجنبية 180 ألفًا، تُرجِمتْ خلال دقائق، ولكنها في الحقيقة لم تعد روايتي.
بالطبع، اليوم يتم العمل على ظهور روايات في عدد من اللغات متزامنة ترجماتها مع نسختها الأصلية (النسخة الأصلية للمفارقة المضحكة، هي نسخة الذكاء الصنعي).
ذلك أمرٌ يفقدنا الأمل.
كل ما سيحدث أن دور النشر ستكون بحاجة إلى محررين، لا إلى مترجمين، وبالمناسبة، نستطيع أن نعترف: بعيدًا عن الأدب، تحقق الترجمة الإلكترونية في كثير من الأحيان نتائج مبهرة.
يعيدنا هذا إلى الرواية، وكيف خرجنا مطمئنين من مؤتمر غسان كنفاني واثقين بأن العالم غير قادر على الاستغناء عنا.
ذلك أمر منحنا الأمل.
في ذلك اليوم دُعيت إلي بيت صديق عزيز، وهناك وجدت طفليه وابنته يتبادلون اللعب أمام شاشة كبيرة، وكل واحد منهم له لعبة داخل اللعبة الأمّ، حيث يختار الشخصيات التي يريدها أن تكون بطلات لعبته، الأماكن التي ستدور فيها الأحداث، الألبسة التي تلبسها، رفاق الدرب، المناخ، الحضارة التي ستحتضن الأحداث، الموسيقى التصويرية، والأهمّ، وجود أكثر من مائة شخصية، إن لم يكن أكثر، يختار منها ما يريد، ولا أقول مَن يريد، لبناء رواية تلفزيونية تفاعلية، يرافق فيها الواحد منهم أبطاله، وحين يتعب، كما يحدث معنا حين ننتهي من كتابة فصل، يعود في اليوم التالي ويكمِل، وقد تستغرق كتابة الطفل لروايته المرئية التفاعلية هذه أسابيع، وهو حقًا يعيش أحداثها، وإن على الشاشة، رغم أن (الحياة هي في مكان آخر) حسب كونديرا.
لكن المهم في الأمر أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: أي رواية أو قصة نكتبها للأطفال ستقنعه وستذيبه في أجوائها كما يحدث في لعبته؛ دون أن ننسى أن كل شيء في هذا المجال في بداياته.
ذلك أمر يفقدنا الأمل.
في محاضرة قدّمتها في مخيم «مار إلياس» ضمن احتفالية مرور خمسين عامًا على استشهاد غسان كنفاني، في العام الماضي، وقف فتى يتحدّث عن تجربته مع غسان، فقال: طلبت من أخي هاتفًا نقالًا، فقال لي: اقرأ «رجال في الشمس»، وسأوجه إليك أسئلة حولها. وحين قرأتها وسألني، أجبت، فقال لي: أنت تستحق الهاتف الآن، فقلت له: «ولكن هل يمكن أن تُحضر لي رواية أخرى لغسان». لقد تورط الفتى بغسان.
ذلك أمر يمنحنا الأمل.
في المحاضرة نفسها، وقف فتى آخر وقال: أنا تعرّفت إلى غسان كنفاني حين أحضرت لي جدتي روايته «أم سعد» وأحببتها جدًا.
ما لفت انتباهي أن جدته أحضرت له الرواية، ولم تفعل ما كانت جداتنا وأمهاتنا يفعلن (قديمًا!)، لقد أصبح غسان هو الجدّة الحقيقية لهذا الفتى.
وبعـــد:
قبل عشرين عامًا كتبتُ «الروائيون آخر جدّات العالم»، وفي حكاية هذا الفتى ورفيقه في مخيم «مار إلياس» ما يؤكد ذلك لحسن الحظ، وهذا يمنحنا الأمل، ولكن هل سيكون ما سيُنتج للأطفال والفتيان عبر الذكاء الصنعي من قصص وروايات، هو ما سيُقرأ لهم قبل أن يغفوا؟ أم أنهم أنفسهم سينتجون ما يريدون قبل أن يضعوا رؤوسهم على مخداتهم، وحين يحلمون سيُكملون اللعبة في أحلامهم؟ وهذا أمر يفقدنا الأمل. أم أن علينا أن نعترف أن لكل زمن قوانينه، ونعترف هنا بلا جدوانا حين يتعلق الأمر بالمستقبل؟! أم نصرُّ على هذه الجدوى، وقد أنتجت البشرية ملايين القصص والروايات والحكايات الحيّة، التي لا يكفي إطلاق النار عليها، حتى تموت؟

















