
الحروب الباردة: حركات الاحتجاج ضد تغير المناخ
2023-08-28
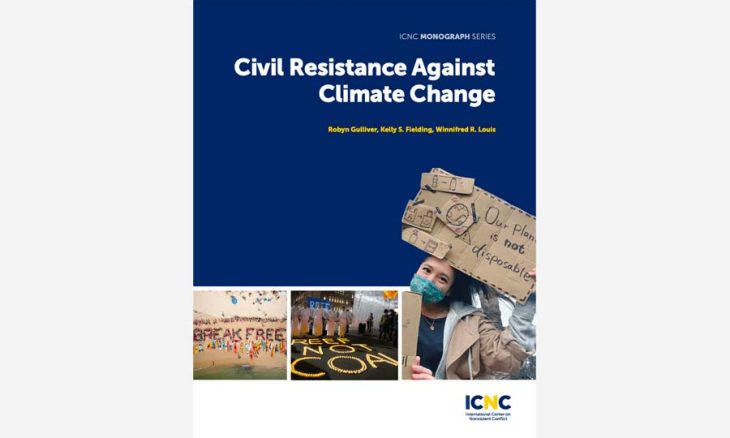
صالح الرزوق
عن المركز الدولي لدراسة النزاعات غير العنيفة صدر كتاب «حركات المقاومة المدنية ضد تغير المناخ» من تأليف روبين غوليفر وكيلي فيلدنغ ووينيفريد لويس. يبدأ الكتاب بمتابعة الإجراءات التي ظهرت منذ عام 2015 للتحذير من تغير المناخ. ثم يذكرنا بحركات سابقة نشطت بين 1990-1999 نوهت بتراجع منسوب المياه والغطاء الأخضر، وخسارة التنوع البيولوجي، وانقراض بعض الأنواع. وقد واكبت هذا الحراك أعمال فنية وأدبية تدخل إما في سياق الخيال العلمي أو الديستوبيا (المدينة الفاسدة) ومنها رواية «الطريق» لكورماك مكارثي و»أنا روبوت» لإسحاق عظيموف وغيرها. لكن بدأت الرؤية في الأدب من النتائج، في حين بدأت حركات الاحتجاج من الأسباب والحد منها. ففي أستراليا ونيوزيلندا تناولت هذه الجماعات تأثير مشروعات الإنتاج العملاقة، وفي إنكلترا وألمانيا أدانت أثر الحروب وما لها من نتائج على التوازن البيئي. في حين أنها في أمريكا حذرت من مشكلة التمييز العرقي وتفاوت الحقوق المدنية. وترى غوليفر وباقي فريق الدراسة، إننا جميعا نشترك في مواجهة الخطر نفسه، وهو ما يدعونا لتأسيس ودعم «حركة المناخ». ويشترط على هذه الحركة ما يلي:
1- توفير هوية واحدة لجميع الأعضاء.
2- الانتماء لشبكة عريضة من المنظمات والهيئات الرسمية.
3- العمل الطوعي من أجل موضوع مشترك.
وتفهم غوليفر وفريقها أن خدمة المناخ هو بشكل أساسي حركة مقاومة مدنية تهدف لتعبئة المجتمع ومنظماته وتعديل أو حماية القوانين الخاصة، والتأثير في السياسات وأصحاب النفوذ والدولة. ومن الواضح أن النشاط المدني غير الأساليب الفنية. فالأدب يزيد إحساسنا بما ينتظر كوكبنا من كوارث. في حين أن جماعات المناخ تجزئ الظواهر والأسباب لتوفير الحل المناسب.
وتقسم غوليفر وفريقها الحلول إلى أساليب تقليدية وراديكالية. الأول يشمل نشاط المؤسسات لفرض تبدل اجتماعي وسياسي. والثاني يعتمد على المقاومة المدنية كالمظاهرات والإضراب والمقاطعة، وتتفرع الأساليب الراديكالية إلى ثلاثة محاور هي:
-عقد الاجتماعات وإلقاء الخطابات.
– الإضراب.
– وأخيرا الاحتجاج بالامتناع عن الحركة في أماكن العمل.
لكن مع التقدم غير المسبوق للتكنولوجيا، كان لا بد من توسيع قاعدة نشاطات المعارضة لتشمل أساليب الأسلوب النفسي وكسر سرية نشاط المؤسسات (تحت مسمى الشفافية) يضاف لذلك الامتناع بالتشجيع، والمقصود به تقديم الجوائز والمكافآت وليس العقاب والردع. لكن منذ البداية يجب التمييز بين النشاط الهادف لإصلاح البيئة، والنشاط المعارض لتبدل المناخ. وإذا غلبت على الأول هموم سياسية وإدارية للثاني طابع اجتماعي. ولا يوجد شيء يرعب غوليفر وفريقها أكثر من تدهور المناخ في أستراليا، وتضرب عدة أمثلة على ذلك منها جفاف الألفية الثالثة وانخفاض منسوب الأنهار وتراجع الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى كارثة حرائق الغابات. وقاد ذلك لاندلاع حروب المناخ بين الأحزاب المتنافسة على الحكم. وهو ما ضاعف من الوعي البيئي والقيام بإجراءات عملية مثل بناء المدن الصغيرة الانتقالية (التي تستغني عن مصادر التلوث) والاهتمام بما يسمى «العدالة المناخية» ويعني توفير الحماية وحق التصحيح لمن هم عرضة لأكبر قدر من الضرر.
وتنبه غوليفر بعدة فصول متتالية، في آخر الكتاب، إلى سياسة الأذن الصماء التي تتبعها الحكومات في أستراليا، وتذكر أن الشرطة اعتقلت 536 ناشطا خلال 3 سنوات، وتراوحت التهم بين انتهاك حرمة الأملاك الخاصة والاعتداء على الشرطة. ومع ذلك لم ينخفض النشاط، وربما زادت حدته لسببين أساسيين: الأول زيادة عدد الجماعات الصغيرة المنادية بحماية المناخ، والثاني انتماء غالبية الناشطين لشريحة البسطاء والمحرومين، لكن للأسف تبدو هذه القراءة بعيدة عن الواقع الدولي، فهي لا تقدم أي معلومات عن النفايات النووية، ولا تزيد من معلوماتنا عن المسؤولية الأخلاقية المترتبة عليها، مع أن باسكوت تونكاك خبير السموم في الأمم المتحدة نبه لمخاطرها على البيئة، في كلمة ألقاها عام 2020. كما أن غوليفر وفريقها لم يعنيا بسياسة التمييز النووي التي تتبعها الدول القوية، وإذا انضمت للنادي النووي مؤخرا بعض الدول النامية، فهذا لا يعني أنها تعمل دون وصاية أو معونة من قوة أكبر مثل أمريكا والصين، ولا ضرورة للتذكير أن من فتح طريق هذا السباق هو الترسانة النووية في إسرائيل، فحسب إحصائيات «معهد استوكهولم لأبحاث السلام» لدى إسرائيل 80 سلاحا نوويا بينها 50 رأسا حربيا جاهزا للتحميل على صواريخ أريحا 2 متوسطة المدى. ولا أعتقد أن البيانات التي تقدمها الأمم المتحدة صحيحة. وبالنظر لجدول الانبعاثات لا تستطيع أن تجد أي منطق في الأرقام المدونة. فالولايات المتحدة تتصدره بـ 22%، بينما لا تزيد روسيا على نسبة 5.6%. وكلاهما دولة منتجة ومخزنة للنفط. بينما تتساوى بهذا الخصوص كل من سوريا وإسرائيل بنسبة تبلغ 0.3%، في حين أن إندونيسيا تتساوى مع فرنسا برقم تلوث يبلغ 1.4%. وإذا اتفقنا على أن هذا الرقم يراهن على استخدام النفط ومشتقاته فقط، لا أفهم كيف تتساوى دورة الإنتاج والاستهلاك بين الطرفين، ولاسيما أن فرنسا أكبر منتج للطاقة النووية، وأقل الدول إنتاجا للكربون، ولا أرى لماذا اعتمد فريق الكتاب على معيار واحد وهو الاحتباس الحراري وتناسى أسبابه، ومنها ظاهرة التشرد في المدن الكبيرة مثل واشنطن، فقد بلغ عدد المحرومين من المأوى في وسط العاصمة فقط حوالي 8944 متشردا. أما موسكو فقد بلغ عدد المتشردين فيها 75 ألفا. ولا شك في أن أساليب التدفئة البدائية وحرق المواد الجافة سيضيف المزيد من الألم والأوجاع للمناخ. وأغفل فريق الكتاب أيضا كل ما يتعلق بالأمطار الحامضية المسؤولة عن التعرية وتسمم المياه الجوفية، وتراجع الغطاء الأخضر، ولذلك لن يكون لأرقام الانبعاثات أي معنى إن تقترن بمعايير مكملة كالرطوبة ومعدل الأمطار ومواعيدها.
كما أشارت غوليفر وفريقها إلى نجاح أصدقاء المناخ في القطاع التجاري والسوق، وفشل في القطاع السياسي، لكن هذا لا يوضح نوع المهن المستهدفة، وهل شملت تجارة الأسلحة، أم المواد الكربونية التي تستعصي على إعادة التدوير؟ ويمكن أن نوجه السؤال نفسه للقطاع السياسي، هل شمل البرامج العسكرية النووية، أم فقط التشريعات العامة التي تسنها الحكومة. وكانت سفيتلانا أليكسييفتش قد تكلمت عن مثل هذه الموضوعات في روايتها «صلاة شيرنوبل». وفيها تناولت بطريقة المونولوج وتيار الوعي وتكنيك الأصوات ما لحق بالغطاء النباتي والحياة الحيوانية من كوارث وذلك في غضون 14 يوما بعد تسرب الإشعاع. ومثلها فعلت أرونداتي روي مؤلفة «الدليل العادي إلى الإمبراطورية» وفضحت إفراغ الخزان الاجتماعي والعاطفي للهند التاريخية. وننتظر من غوليفر وفريقها أن يتحلوا بالجرأة والصراحة نفسها، ويقدموا لنا تقريرا مكملا يكشف أخطاء الغرب في سياسة التوسع وحل المشاكل الدولية بالإكراه، وما يتسبب به ذلك من تضحية بالبيئة وتدمير للهويات الوطنية الناشئة.
* شارك في إعداد المونوغراف روبين غوليفر، كيلي س. فيلدنغ، ووينيفريد ر. لويس. وصدر ضمن منشورات المركز الدولي لدراسات النزاعات غير العنيفة في واشنطن 2021 ـ 109 صفحات؟
كاتب سوري



















