
كتاب «جغرافية الفكر»: هل تفكر الشعوب على نحو مختلف؟
2023-05-29
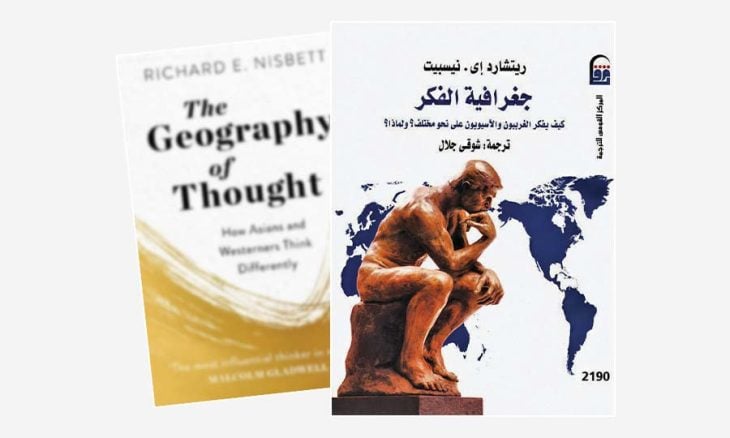
رامي أبو شهاب
على الرغم من أنّ كتاب «جغرافية الفكر- كيف يفكر الغربيون والآسيويون على نحو مختلف… ولماذا؟» للمؤلف ريتشارد نيسبت – ترجمة شوقي جلال ضمن منشورات كتب عالم المعرفة في الكويت – صدرت نسخته الإنكليزية منذ زمن وتحديداً عام 2003 ، إلا أن أطروحته ما زالت مثيرة أو طريفة تحتمل الكثير من الجدل والبحث، فهي تنطلق من رؤية تعتمد مقاربة معرفية إدراكية، لكنها في الوقت عينه تحتمل نوعاً من المفارقة، كونها تقرأ الفكر من منظور عرقي جغرافي، ضمن جملة من الأدوات قريبة الصلة بمنهجية علمية تخضع لأسس واضحة، غير أن نتائجه تبقى جزءاً من مقولات ربما لا تصمد مع الزمن، أو تحتاج إلى المزيد من الإخضاع البحثي.
يقدم الكتاب منظوراً معرفياً في قراءة الفكر حسب الجغرافية التي لا تعدّ عنصراً ثابتاً في تشكيل الذات، غير أنها قد تتقاطع بوضوح مع مقولة العرق كما المرجعيات الثقافية الحضارية والاجتماعية التي يمكن أن تؤسس نمطاً للتفكير، وتسهم في تشكل المعرفة والسلوك، وهذا ربما يكاد يقترب إلى حد ما من المقولات، التي تتأسس على أن بعض الأعراق لها توجه فكري، أو مسالك معرفية تتحدد بالذات الجمعية، التي تتمايز عن الآخر، لكن يبقى السؤال المحوري الذي يتصل بإنتاج المعرفة والسلوك، كما التعامل اليومي مع تطبيقات الحياة اليومية؟ وكيف يمكن أن يتصل هذا بالقدرة على تمكين التقارب والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب.
الفرضية والفكرة
ينطلق الكتاب من طرفي الفرضية، اللذين يتحددان بوجود علاقة بين عرق معين، ونشأته وتاريخه في جغرافية ما، وكيف يمكن أن يصوغ هذا طريقة تفكيره ورؤيته للعالم، والكاتب هنا لا ينطلق من الجغرافية المكانية وأثرها على التفكير فحسب، وإنما يُعنى أيضاً بالخصائص التاريخية والأفكار التي عبرت منطقة محددة، وشكلت المنظور الخاص بهذه الفئة من المجتمعات.
يمكن أن نميل إلى القول إن هذه الرؤية أصبحت مستهلكة، غير أن الأسلوب والأفكار اللذين ينطوي عليهما الكتاب ينبعثان من مساءلة تحتمل الكثير من التأمل والبحث، من حيث القدرة على قراءة نماذج وتجارب أخرى، كما عقد مقارنات بين الأفكار والشعوب والحضارات، حيث يقوم الكاتب بمقارنة العقل الغربي المتصل بمنطقتين جغرافيتين هما: أوروبا أو الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بدول شرق آسيا، وتحديداً اليابان والصين وكوريا.
ينهض الكتاب على عملية بحث معرفي واختبارات بغية قراءة أسس عمليات التفكير في تلك المناطق، فيبدأ من فعل تشكل الفكر الغربي بدءاً من اليونان القديمة، ومن ثم يبدأ بقراءة التطورات التي شهدها العقل الغربي في تلك المنطقة مقارنة بدول شرق آسيا، ويخلص إلى عدد من النتائج المثيرة واللافتة، وتتعلق بالتمايزات والاختلافات التي ينطوي عليها الفكر بين تلك المنطقتين، غير أنه لا ينطلق من أسس معيارية من أجل إصدار أحكام بالأفضلية أو التفوق أو مدى الفعالية، أو مقولة الأكثر تطوراً، وإنما سعى إلى فهم الاختلاف، ودوافعه، وأسبابه، من مبدأ أن هذا قد يؤدي إلى فهم أعمق للشعوب والحضارات والأمم، وآليات التفكير لديها.
يتكون الكتاب من عدة فصول تنطلق من فعل منهجي يؤسس مقولة الرسالة، حسب المنطلقات الإجرائية، حيث نقرأ في المقدمة الأساس المنطقي لفكرة الكتاب، كما الدوافع والمسوّغات التي تتصل بحادثة شخصية، وتتعلق بطالب آسيوي عبّر لأستاذه (المؤلف) عن أنهما مختلفان في رؤية الأشياء، من مبدأ أن الفكر الغربي مبني على افتراض أن السلوك كما الأشياء والطبيعة الحيوانية والبشرية يمكن فهمها في ضوء قواعد صريحة ومباشرة، فالغربيون يهتمون كثيراً بالتصنيف الفئوي كما يُعرف، وهذا ساعدهم على تحديد القواعد التي يتعين تطبيقها على الموضوعات التي تقع محل البحث والسؤال، وهم يعولون كثيراً على المنطق الصوري لحل المشكلات، بينما الشعوب في شرق آسيا ينظرون إلى الموضوعات، لكن في سياقها العام، فالعالم من وجهة نظر الآسيويين قد يبدو أكثر تعقيداً مما هو عليه في نظر الغربيين، في حين أن فهمهم للأحداث يحتاج منهم الاستغراق في التفكير، وبوجه خاص العوامل التي يؤثر بعضها في بعض، لكن بطريقة غير بسيطة، ولا حتمية، وهم دائماً ما يتجاهلون المنطق الصوري في حل المشكلات، ومن هنا، فإن هذه التمايزات والاختلافات دعت إلى البحث في طريقة عمل الدماغ، أو العمليات الذهنية الإدراكية، لكن هذا لا يكون بمعزل عن الإقرار بوجود النظرية المعرفية، كما أثر العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكيفية تفسير هذا التمايز.
يتأسس الكتاب على منهج المقارنة بغية البحث عن الفوارق الكبيرة بين طبيعة عمل الفكر في كلا الجغرافيتين، وقد اعتمد الكتاب على الدراسات المسحية والاستقصائية مع المشاهدة والملاحظة.. من أجل تبرير تلك الفروق بين هذين النهجين في التفكير أو الأسلوب، ولعل الكتاب يهدف أيضاً للإجابة عن فرضية أثر العلاقات الاجتماعية والسياقات على تشكيل الفكر، ومن ذلك مثلا طرح سؤال لماذا تميز الصينيون بالعلم والرياضيات، خاصة في الجبر والحساب على عكس الهندسة التي كانت مميزة لدى الإغريق، بل كانت تعدّ قلعتهم، ولماذا كانت حصيلة الآسيويين في العلم الثوري أقل من نظيرها لدى الغربيين، ويعلل الكتاب ذلك تبعاً للعلاقة بين الأحداث والوقائع، فالآسيويون يميلون إلى عزل الموضوع عن محيطه، أو سياقه في حين أن الغربيين يعتمدون بشكل واضح على الاستدلال السببي، وهذا يدعونا إلى النظر مرة أخرى في فكرة تنظيم المعرفة، ومن ذلك أن الغرب يتعلمون الأسماء بشكل أسرع من الأفعال، في حين أن الآسيويين على العكس من ذلك. يذكر الكتاب على سبيل المثال لا الحصر أن أبناء آسيا ينزعون إلى تجميع الأشياء والأحداث تأسيساً على كيفية ترابطها، أو انطلاقاً من علاقاتها، بينما الغربيون فهم يميلون إلى اعتماد المقولات والفئات والتصنيف، ومن الملامح التي يمكن أن نقرأها تركيز الغربيين في التفكير العقلي على المنطق الشكلي أو الصوري، والقيمة المباشرة، مع عزلها عن السياق، مع التأكيد على الاستقلالية والإنجاز الفردي، بينما الشرقيون ينظرون إلى الأمور من ناحية التناقض والتركيز على العلاقات من أجل فهم الحقيقة بشكل أوضح متأثرين بالفلسفات، ولاسيما الكونفوشية، وغيرها.
في فصل جاء بعنوان «القياس والطعون» يقرأ الكاتب التمايز بين الآسيويين والغربيين انطلاقاً من المرجعيات الحضارية القديمة، أو الأسس التي أسهمت في نشأة تلك الثقافات، ولاسيما لدى الإغريق بالنسبة إلى الغربيين، وفلسفة الطاو أو الطاوية الصينية بالنسبة للآسيويين، وهي فلسفة دينية تنهض على تعميق التناغم، إذ يرى المؤلف أن الغربيين كانوا أكثر قرباً من موضوع الفردية والحرية، في حين أن الآسيويين كانوا يميلون إلى التناغم الجمعي، ولا ينظرون إلى السياق الفردي بالصورة المبالغ فيها لدى الغربيين، ولاسيما لدى اليونانيين الذين كانوا يعشقون الجدل والمحاججة، كما ممارسة المنطق، بينما الآسيويون فإنهم يرون أنفسهم في سياق أقرب إلى التناغم مع القبيلة والعائلة والحاكم، ويرون أن الفرد تكمن قيمته في قدرته على أن يكون مفيداً لمجتمعه، ولعائلته، ولأسرته، فلا يوجد شيء اسمه الفردية، فالأنا تذوب في الكل الجمعي.
تساؤلات
ينظر الكتاب في الأسباب أو الدوافع التي ربما تعود إلى أسباب بيولوجية، وهذا يدعونا إلى أن نتحدث، أو أن نستذكر تلك الدراسات التي انتشرت في القرن التاسع عشر حول الاختلاف بين الشعوب تبعاً للتمايزات العرقية، أو البيولوجية بما تحمله من شبهات استعمارية، ومقولات تتصل بالعبودية، وقد أُثبت أن جزءاً كبيراً منها غير صحيح، لكن هل يمكن أن يكون الاختلاف تبعاً للغة، أم إلى العوامل الاقتصادية، كما يذكر الكتاب؟ وهل يمكن أن يكون هذا جزءاً من المنظومات الاجتماعية، والقيم الفلسفية؟ لكن ماذا عن استمرار هذا التمايز على الرغم من التغيرات في تلك العوامل، أو منطق التطور الحتمي ألا يوجد أثر لذلك؟ وهل سوف تبقى هذه التمايزات أم ستختفي؟ هل يمكن أن يقترب العقل البشري من طريقة تفكير موحدة؟
من الفصل الرابع إلى السابع، يذهب الكتاب إلى كثير من المعتقدات الأساسية محللاً دورها في بناء هذا التفكير العقلي، ومن هنا فإن فاعلية الاختبارات تبدو منطقية، أو مسوغة لاكتساب النتائج، ففي أحد الفصول يربط هذه النتائج بعلم النفس والفلسفة والمجتمع، مع التأكيد على أثر الممارسات الاجتماعية، بين تلك الشعوب، في حين أن الفصل الثامن يخلص إلى أن هذا التمايز قد ينتهي يوماً ما، وهو التصور الذي يبدو جزءاً من وعي الكتاب، بالإضافة إلى طرح سؤال محوري وجوهري، ويتمثل بمقولة: هل يمكن أن يؤدي هذا التمايز إلى التلاقي والاستمرار؟ أم سيبقى ضمن اضطراب التمايز والفرقة والاختلاف؟
يمكن ملاحظة وعي الكاتب بمنهجيته، ومنطلقاته، حيث يوضح العينة البحثية، فعندما يقصد شرق آسيا فإنه يقصد الصين والبلدان التي تأثرت بثقافة الصين، خاصة اليابان وكوريا، لكن عندما يتحدث عن الغربي فإنه يعني الأمريكيين والأوروبيين، كما أنه يضع السود والخلاسيين والإسبانيين باستثناء أي شخص من سلالة آسيوية، وهنا نلاحظ التمركز على البعد العرقي المتصل بجغرافية النشأة، والثقافة، وبالتالي هو ينظر إلى أن الأمريكي أو الأوروبي، هو الذي ولد ونشأ أو تعرض للعوامل الثقافية عينها، وبالتالي يمكن أن نقول إن الكتاب يؤطر الشخصية ضمن جغرافية العرق والمرجعية الحضارية، وقدرة ما سبق على تشكيل حالة الإنسان والفكر، ولعل الكتاب يدعو إلى تأمل مماثل لتحليل طريقة التفكير لدى الإنسان العربي، مع التركيز على رؤيته للأشياء، ولاسيما في ظل وجود معوقات بنيوية تحول دون تحقيق تقدم على مستوى الفكر، وتقديم إضافات معرفية نوعية للعالم في ظل سياقات راهنة.
ومن بين الملحوظات التي يمكن أن تتصل بأطروحة الكتاب، ما نشهده في هذا الزمن من تماثل لدى الإنسان في رؤيته للأشياء، وتعامله، مع العالم، والواقع، ولا سيما مع حضور التكنولوجيا التي غيرت الكثير من البنى الإدراكية والمعرفية للإنسان، فالتكنولوجيا في طريقها لخلق إنسان جديد، أو أن تقوم بإعادة إنتاج لمعنى الوعي الذي يمكن أن يمسي جزءاً متصلاً بالتكنولوجيا، ضمن مقولة السايبورغ نزولاً عند تنظير «دانا هاراوي» كما جاء في «مانفيستو السايبورغ» أو ربما يقترب الإنسان من إذابة الفوارق والتمايزات، ونعني على مستوى الشعوب في رؤيتها للعالم، والواقع دائم التحول.
كاتب أردني فلسطيني

















